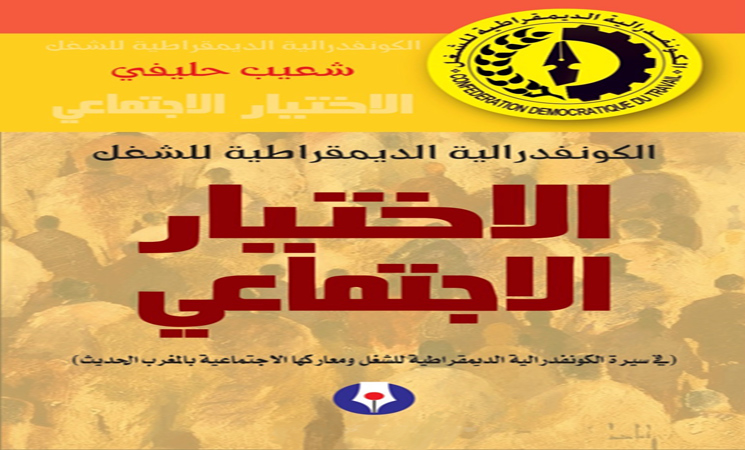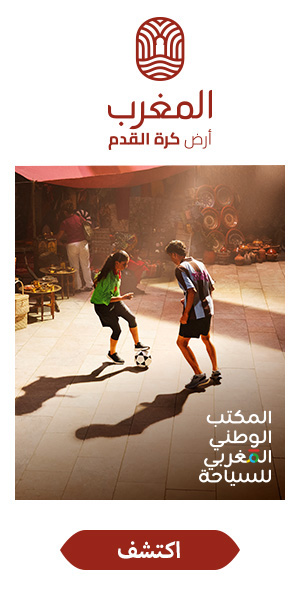كم من صورةٍ تلزمُنا لتلخيص حياة الكاتبة والسياسية والمناضلة والبرلمانية والأكاديمية والمثقفة والحقوقية،والباحثة والناقدة والمرأة المغربية رشيدة بنمسعود؟
كم من صورةٍ تلزمُنا لتلخيص حياة الكاتبة والسياسية والمناضلة والبرلمانية والأكاديمية والمثقفة والحقوقية،والباحثة والناقدة والمرأة المغربية رشيدة بنمسعود؟
ليس للحيرة في السؤال من جواب سوى الاستحالة، طالما هي حياة مترامية المعنى والشساعة، يصبح من المستحيل تلخيصها وهي استحالة قد تعفي الكاتب عنها، بما أنها تلتمس له عُذرا لتقصيره أو عجزه .. كما أفعل الآن منذ البداية، ولكنه جواب يضمر فيه السؤالَ الآخر: كيف استطاعت هي الواحدة أن تعيش تعددها، فتعيش الممكنات الكثيرة في تعدديتها، وتُربِّت عليها لكي تتعايش جنبا إلى جنب، في شخصيتها الواحدة والوحيدة والفردية؟
في تقدير الجواب عند هذا الواقف أمامك، يكمن الجواب في أنها قد استطاعت ما يستحيل عند الكثيرين منا لأنها: لم تكن لتعترف به أنه مستحيل، أو ببساطة لم تكن تعرف أنه كذلك!
1 – أجيال من النساء
في أنثوية واحدة:
فليس هناك موطن للعمل لم تطأه تجربتها الفريدة: العمل الحقوقي المنظم، العمل الثقافي اتحاد كتاب وجمعيات الأدب، العمل الديمقراطي في معبده السياسي الحزبي والنقابي والمؤسساتي في البرلمان، والجماعي للقضايا النسائية، وما أتعمد نسيانه لكي لا أطيل عليكم.
ومن المفارقة من رآها عدَّد مستحيلات غيرها: ما بين المنابر الجامعية والمجلات، بين الكتابة عن التفرد المغربي في ترويض المستقبل والتعدد الديموقراطي، في مسارات الـحياة الوطنية لها اسمها وطريقها الذي عمَّدت سبيله بالجدية، وتتقدم فيه مخفورة بالوعود دوما!..
لي أن أجزم أنه لا حاجة للمترادفات من القاموس المعتاد في كل تكريم، لأني أعتقد بدون أي رغبة مني في أن أرميها بورود تستحقها، بأنه لا حاجة للبلاغة لقول عمر متكامل في شَدوه وشذاه. ويكفي لذلك تسمية الأشياء بمسمياتها ليستقيم الاندهاش والإعجاب بسيرة مناضلة وأخت وقيادية وشقيقة في ترويض المستحيل المغربي..
ولقد تحققت لها هويتها الفردية المنسجمة والمتماسكة في الكيان وفي الوجود، لكنها في الآن ذاته لا تقيم في «أَيْنية» ( من أين ) محدَّدة محدودة مرسومة قبلا أو بعدا! فتوزعت ذاتها بين هويات متعددة في الفعل كما في التفكير: في وقت كانت رفيقاتها، أجيالا وأفرادا، يمكثن في مربعات متعارف عليها: منهن من تستنفد العمر كله في المتاريس السياسية لوحده، ومنهن من استغرقتها دروب وتدريبات الجبهات التنظيمية، ومنهن من لم تغادر معسكرات المعارك الثقافية..رشيدة كانت كل هذه الأعمار، وهاته الأجيال دفعة واحدة: الطالبة المناضلة، الأستاذة النقابية والسياسية والبرلمانية ..
فما العمل في تقديم ما يفيض عن اللغة…. باللغة القاصرة نفسها؟
الإعلان عن العجز لا يكفي، ولابد من الانتقاء. ولي في ذلك بعض الحق، بما أنني قد حُبِّب إليَّ من شؤون سيرتها: الشعر، وفلسطين والانتقال الديموقراطي .. وروعة الوجود الأنثوي في الأدب الخالد.
لي معها قواسم درويشيات المياه الباطنية التي تنادي قارئها من خلال ما وجدته في جمالية المكان في «مديح الظل العالي» لمحمود درويش.. مثلا، ولي معها صور فلسطين وهي تحضر باسمة مع ياسر عرفات ومحمود درويش ومارسيل خليفة.. وفي الأدب كل ما يضم هويتنا الفلسطينية سحر خليفة مثلا.
وقد أسعفتنا بدوْرها عندما تكثفت في سيرتها روافد الأكاديمي والأدبي، وتكثفت الأمكنة التي تجمع السحر من أطرافه:ولي في ذلك زواج السحر الثوري والسحر البرجوازي الأنيق: ما بين ظهر المهراز وباريز.
2 – في المكانين معا:باريز وظهر المهراز..
لها تفردها هي، وهي في ظهر المهراز ، أعلى تلة في الإطلالة على المغرب المشتهى وقد حملته إلى صدر أمه «الكومونة» في. بَرِيَّة باريز، وتطعم بذلك نفسها المحلي بالهواء الكوني، وتُعَدِّد ينابيعها، بعد أن علم كل أناس مشربهم !
فصارت لباريس في قلبها كمون وكمونة:لقد ذهبت إليها بمناخات الحرم الجامعي المغربي في نهاية سبعينات القرن الماضي (1976)،كما لو كانت تبحث لجمهورية ظهر المهراز عن بدايتها في الكومونة الباريزية.. كما لو كان طريقها الجسر العلمي إجباريا للربط بين الوطني والكوني في رمزيات الفضاء الثوري، وما زالت تحتفظ لباريس بمواعيدها كما يحتفظ الحنين بفصوله كاملة كل ربيع أو كل خريف كما تشتهي..
باريز لتكوين الحرية والذوق الرفيع ونفهم مما تبوح به عن عاصمة الأنوار أن باريز التي في مخيالها صنيعة قدميها وإيقاع كعبها على أسفلت الثوار والمتمردين والعالمين. هكذا تقول عنها»نسجتها خطاي ذهابا وإيابا ما بين كوليج دي فرانس، السوربون، سانيسي (باريس 3)، معهد اللغات الشرقية ( Langues o) – فانسان ..الحي اللاتيني، لا كونكورد، لا مدلين…الخ، فيقودني التذكر إلى أجواء درس الحضارة العبرية بمعهد اللغات الشرقية أواخر السبعين.» عندما وصلت رشيدة بنمسعود إلى باريز كانت العاصمة ترقص وتغلي وتنام وتحلم على إيقاع :« يا نساء العالم انهضن»، ما زالت الأغنية تسيل بذهبها في حارات باريس: انهضن يا نساء العالم؛
تدعوهن لاختطاف عربة التاريخ أو سفينته، لا فرق، لترسو فوق تربة مغربية مازالت غير خصبة للأغنية.
كانت الحرية مفعمة بشحنات التراجيديات وقتها..
وأعود إلى ظهر المهراز الآن وأتساءل بغير قليل من التردد الوجِل:
هل رحلت منه إلى باريس بفعل القرابة بين الجغرافيات الدلالية في وعي مثيلاتها وأمثالها من الثوار والثائرات؟ :لعلي أجازف بالقول إنها لم تكن تطرح السؤال، بل كانت تقتحم القلاع، مثل امرأة حرة مثل ماريان.. مثل العالمات..بالوعد الكامن، مما تعتق في وعيها من صراع طلابي وصراع المرجعيات ..
من الزمن الطلابي كما عاشته، وقتَ كانت الجثثُ أفضلَ سمادٍ لتخصيب الحقل السياسي، قد تعبر سحنتها سحابة أو شرود رمادي، أو تعبرها مسحة حزن وهي ترتب مزهرية، فلها في الورود أمامها صورة مقتبسة من مزاج الشهداء والراحلين، ولها ربما أسماؤهم،في لائحة الزهور!
لكن رشيدة الباهرة بتفاءلها لا تتنازل للحزن طويلا، فتعطي الحياة كل صباح بسمته،كما عرفتها في كل بلاء لا لكي تركن الحياة إلى سعادة ساذجة ورتيبة، بل لكي تكون أكثر ذكاء وأكثر جدارة بموهبتها..
3 – هي تفجر اللغة
وأنا أدبرها..
لعل المألوف الأكاديمي والنافع من التقديم يقتضي أن نركن إلى تسلسل الحياة ذاتها، في ترتيب لحظاتها العالية..نرتب مكانا للمسار العلمي وآخر للسيرة السياسية وثالثا للمسارات الأكاديمية والنضالية .. هكذا، لكن رشيدة بمسعود تنفلت من هذه الرتابة البيوغرافية لتلقي تحديا في وجه من يراود الكتابة على ضفاف نهرها الهادئ والعميق والذاهب بعيدا في التفرد، وسط مغرب ما بعد الاستقلال..
منذ أن وضعت والدتها «لالة أمينة الفاسي» بين يديها العالم، علمتها أن طرز الأفق الحالم أفضل بكثير من حرير الأميرات. بالرغم من حفاظهما عليهما معا: حلم الأميرات وحرير المستقبل ..فهي لم تحتفظ من الإبرة سوى بِحدة الوخز، في المكر اللغوي، الذي يسوغ الدونية الإرادية التي قبلت بها كثيرات ورفضتها رشيدة. وهو مدخل إجباري للاقتراب من ثراها:
وأطرح السؤال: كيف استطاعت تجسير الفجوة بين حقيقة الحياة الثرية، .. وبين اللغة بعد أن كانت قد فجرتها؟
وأتوسم الجواب بحيطة، لأقول :لابد للغة أن تكون هادئة لكي تستطيع بناء صداقة معها، ولكي تستطيع أن تطمئن إليها، وتكشف لها بعضا من هذا الثراء. لغة بلا محسنات بلاغية ولا إفراط دلالي، لهذا أتقدم حذرا في الحديث عن رشيدة بنمسعود، التي تتزنّر بالجملة لتفجر المعنى، ولكي لا يجفل حمام اللغة ويتركني وحيدا في تكرار ما وجده المنصفون البارعون في التقاط إنسانيتها قبلي.. وهم كثر، في الحياة وفي الأدب والسياسة والنضال الجمعي والديمقراطية والبحث الأكاديمي وفي .. الرفقة الوطنية الواسعة.. فانتبهت مبكرا للغاية إلى ضرورة، بل إلى شرطية، تكسير البعد الإيديولوجي للغة، وكان انتباهها العملي والفكري، هو محصلة تربية نضالية في ظهر المهراز وباريس، ومحصلة التفاعل الذكي مع الدرس اللساني، لهابرماس وكبار فرنسا ..
وانتبهت إلى «النحو الإيديولوجي» الذي يشكل الخلية النائمة للذكورة النكوصية، والى الإيديولوجيا بما هي صناعة ثقافية لغوية بالتحديد ..تقترح نقدا عقلانيا، كلما تقدم تراجع العقل الإيديولوجي وغادر مكامنه المتسترة حتى تحرقه شمس الحقيقة الجديدة..
انتبهت إلى أن اللغة سلاح الذكورة المختلة، وترسبات لامرئية قائمة على صناعة العدمية والدونية، وأحيانا بمساعدة من الحداثة، عند المناضلات اللائي لم يدركن خطورة هذا الرهان!
ولعلي لن أجانب الصواب بالقول:إن الهويات الوجودية، بل السياسية بالتحديد، عندما تتحدد على أساس الهويات اللغوية واللسانية، تكون ناقصة وضد التاريخ .أكاد أقول بأن رشيدة بمسعود شرعت الباب أمام «الوطنية اللسانية».. التي تُشرك الجميع في معركة الحرية واستقلال التراب اللغوي التداولي.( هذه كلمة ستعجب أنور المرتجي)!
4 – عندما أنصفها الدستور وثورته!
لم تصب بدوخة الأعالي.. وظلت ملتصقة بالمآل الجوهري للحرية من خلال الأدب والترافع والبحث العلمي، والتنقيب عن كل أغلالنا المرئية وغير المرئية التي نحبها أحيانا حتى ..!
ورفضت الغيتو النسائي..لغة كان أو سياسة أو تنظيما..
كما انتصرت للأدب النسائي لكنها فعلت وتفعله بموضوعية: بدون قبَلِية جنسية تحصر فكرها وذكاءها، من باب «المضارعة» التي تروم نُدِّية بدون تفرد..
انتبهت قبل الكثيرين والكثيرات إلى أن الإيديولوجيا لها مواطن كثيرة أشهرها: الجسد واللغة والدين ،فعمدت إلى مناصرة تأويل نصوص القرآن والسنة من منظور غير ذكوري مُعادٍ للنساء، ونقد التراث ..
أعادت ترشيد التأويل: ليس الطريق الأفضل إلى حرية المرأة هو الحرب مع الذكورة ولا تأويلها!.. فلا ليبرالية تجعل التاريخ سيارة أجرة مخصوصة تليق بها؛
ولا محافظة تجعله بين يدي حفاري القبور يوزعون صكوك الغفران..
وانتبهت إلى ضرورة ألا تكون الحداثة عنفا لامرئيا، ولا مبررا جماعيا لانتصار التقليد على تواصل وثيق ومكثف بالغيب، في زمن كانت فيه الفصائل المناهضة تشحذ رجعيتها من أجل حريم متجدد،
وأمعنت هي وأخواتها في صداقة النار: وقلن لا ثم لا!
والبلاد في منتهى الجدلية موزعة بين التوثب والحيرة، آمنت رشيدة بنمسعود بسخاء الخيال على توضيب القدر النسائي، وتعالقه مع الديمقراطية. فكانت الطفلة التي تجمع التعويذات من شواطئ اللغة لتعيد قراءة كف الحضارة العربية الإسلامية: لتتبين بيقظة ما هو الممكن المترتب عن نظرها إلى المستحيل.
في النضال السياسي الذي جمعني بها، أصرت دوما على تخصيب السياسة بسلاسة الأدب ..لهذا ظلت عصية على التنميط باسم السياسة، وأدركت أن الخُلُق في السياسة لا يخْلُص لصاحبه إلا عند الحيرة والسؤال والنقد!
ومثلما يكون اللاهوت أحيانا اختناقا للإلهي، وعت بأنه من الممكن أن تكون السياسة في المغرب اختناقا للسياسي!؛
والديمقراطية فخا للديمقراطي..
وكانت وبلباقتها الأميرية، الممتدة ينابيعها إلى الأندلس والحمراء، ترفض كل أبيسية تنظيمية ربما يقبل بها المزاج العام، لكنها تنتبه إلى مخاطرها لأن السياسة كما فهمتها نضاليا، واجبٌ مطلقٌ تجاه الحرية لا تجاه البراغماتية غير النظيفة!
تحكي رشيدة عن الدرس العبري في مسارها اللغوي بقصة لها معنى كبير: وتقول: في معهد اللغات والحضارات الشرقية INALCO، يحاصرني السؤال، تقول طالبة يهودية والأحرى ربما صهيونية rachida ton cas
Me parait bizarre, une arabe musulmane vient étudier l’hébreu
يحرجني ويرهبني السؤال.. اتفاقية كامب ديفيد وزيارة السادات للقدس رفعت من وتيرة السخط العربي وتصاعد العدوان الصهيوني ضد العرب بصفة عامة والفلسطينيين بصفة خاصة، تتسارع الأحداث ويزداد العنف الأسود… اغتيال شخصية فلسطينية داخل إحدى مكتبات الحي اللاتيني، محاولة إحراق مطعم إسرائيلي بنفس الحي…التوتر والقلق سيدا المقام، حاولت أن أتجاوز خلفية السؤال وأبعاده، وأختار من الكلمات أبلغها وألطفها.. فأجيب: الثقافة مسألة إنسانية كونية،وتعلم اللغات ضرورة للحوار الحضاري والثقافي، مهما اجتهدت في الجواب يتضاعف الإلحاح والإصرار.. ويظل السؤال يطرح ..و يطرح..
في جوابها رد استباقي عن فهم العبرية كرافد حضاري مغربي، لا يحتاج فيه المغربي وقتها ولا بعدها ولا في المستقبل، إلى تطبيع ثقافي لأنها رافد ثقافي قبل أي كيان سياسي: إنها اللغة العبرية المشتركة التي تممت دسترتها، عن حق لا بوصفها «عقارا لغويا» لكيان سياسي محتل!
لم يكن هذا هو الانتصار الدستوري الوحيد لرشيدة بنمسعود، بل كان لها انتصار ثان مع..»الدستور المغربي أنثويا»: كما كتب الفقيه الدستور المغربي اللبيب ، السي محمد الشركي في هذا التحول البليغ الذي لم يكن حاضرا في الدساتير السابقة، وحضر عند أختنا رشيدة منذ عقود !
تحرير اللغة في الطريق إلى تحرير المغربية.. والمغربي أيضا!
ختاما:
أتدري يا أنور، لماذا لم تسرق المرأة النار، كما فعل بروميثيوس promethée؟
ذلك لأن النساء،مثيلات رشيدة، هنَّ من أشعلنها لتتحلَّق حولها الآلهة!
وكما سألونا ذات ربيع: إلى أين ذهبتم بعيدا في الأندلس لتأتونا بسيدة مجللة بلباقة الأميرات للحديث عن مغرب عصي وآخر يولد من أفق رحب؟،
أقول بأن الدرس الكبير من حياة رشيدة بنمسعود، والمغربيات على طرازها، هو أن المستقبل يظل ناقصا.. حتى تعثر عليه المرأة فيكْتملُ!
طوبى لنا!
*(ألقيت هذه الشهادة في الحفل التكرمي لمسار د. رشيدة بنمسعود بالمعرض الدولي للكتاب بالرباط في دورته الثلاثين)