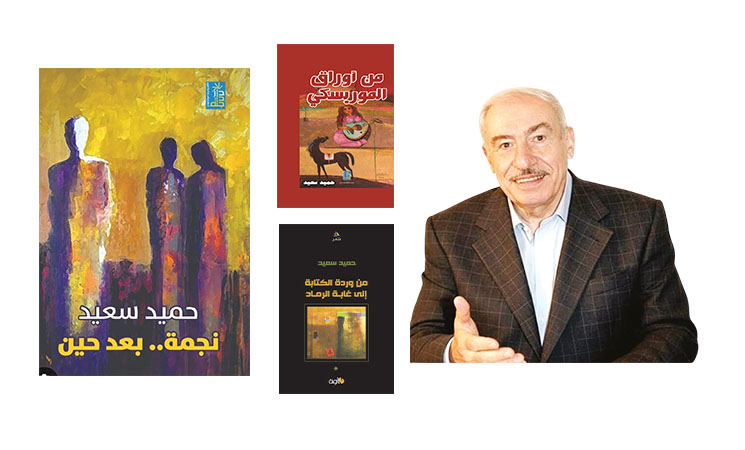رن هاتفي ذلك الصباح، كان الرقم يشير إلى مفتاح اتصال تونس الشقيقة،وبمجرد الرد طلع صوت صديقتي التونسية مبحوحا، وهي تحاول مقاومة الاختناق، الذي عرفت بعد ذلك أنه كان نتيجة تغيير في المناخ بتونس، إبان أمطار طوفانية حلت بالمنطقة، وهو المناخ الذي انعكس سلبا على مخارج صوت صديقتي، التي تحب أن تترك أزرار قميصها مفتوحة، لتعبر عن موقف واضح من الذين جعلوا من المرأة جسدا ينبغي أن يغلف بقماش شبيه بالكفن، إلا أنهم اختاروا له اللون الأسود بدل الأبيض الذي يلف الجسد استعدادا للرمي في القبر وعذاباته.
سألتني وهي تسرع من المكالمة حفاظا على رصيد هاتفها القليل جدا، هل ستأتين إلى تونس، أرجو أن تخبريني، فأصدقاؤك في بلدي ينتظرونك، ولو أن تونس التي انتظرتك مرارا بشوارعها البهيجة ليست هي تونس اليوم.
أجبتها أني لم آخذ قراري بعد، وأن مسرحية» الحكرة»، ستكون في الموعد.ردت صديقتي، وهي تحاول أن تضغط علي من أجل الحضورإلى تونس، بقولها :»لقد اشتقنا إليك صديقتي المبدعة».
في ذلك المساء، وبعد تردد ناتج عن تراكم الأشغال التي التزمت بإنجازها،قررت الذهاب إلى تونس.
لم أكن مستعدة بالفعل، وحقيبة سفري شاهدة على ذلك، حيث رميت فيها الثوب الذي سيغطي ربما البعض من جسدي، قلت مع نفسي «يا الله أيها الزمن الرديء الذي أصبح فرسانه الممتطون لخيول من خشب، يتفننون في الإفتاء في كل ما تعلق بأجسدنا المنهوكة. لقد أوهموننا أن التعامل مع أجسادنا هو الأصل، وأن الدماغ الذي قنع بالفعل والقوة، هو دماغ رهين بما يسكنه، وليس بالضرورة أن نكشفه باللسان أو بالإشارة.
حرصت بالفعل أن أحمل معي جهاز الحاسوب، الذي لا تفارق حقيبته كتفي، كما حرصت أن أضع معطفي الأحمر الذي يلف جسدي إلى ركبتي، في حقيبتي الصغيرة، وأنا أفتش في ذاكرتي عن مختلف المحطات التي كنتها في تونس البهية، كما فتشت في ما أعرفه فيما مضى والذي لم أكنه في زمن بورقيبة، وما تابعته في زمن بنعلي، وبعده ثورة الياسمين، وما تلا هذه الثورة من مشاهد الدم تلو الدم، والظلام المترصد بنا، والحلم تلو الحلم، والإحباط تلو الإحباط، والأمل الذي وجد نفسه غريبا، ثم الغموض الذي أدخل الكل في أنفاق ضيقة أدى بعضها إلى الجوار المشتت، وتلك هي القضية.
وكعادتي في تأسيس مشروع للسؤال، بدأت أستحضر كافة هذه المحطات، عاملة على إبعاد الذات في إيجاد أجوبة جاهزة، وهي الأجوبة، التي لا أخفيكم قرائي أنها تحمل حقائق لا يقبلها البعض من التونسيين والتونسيات الذين صدقوا «الحكاية»، أن ورود الياسمين ستلقي بظلالها على جوانب شوارع تونس، وفي مقدمتها شارع بورقيبة، إلا أن الورود اختفت، وحلت محلها أوراق الربيع اليابسة، التي فتتها الجفاف، حتى صارت غبارا، أزكم الأنوف، وحبس الأنفاس، وأثقل المشي عندما تراكم ، حتى استعصى إخراجه من أحذية شدت الأرجل إلى الوحل، ولم يعد حتى البطء يسعفها، لتستل من الحذاء، ذاهبة في كافة الاتجاهات، وعوض أن تقول «بنعلي هرب» استبدلت الجملة ب «بنعلي رجع»، بالجنون الذي أذهب العقول عندما حل الخراب، واختفى السياح، وأقفلت الفضاءات الجميلة، لأن صدى أصوات عشاق الطرب بكافة ألوانه، أحدث رنينا مزعجا في الآذن، ليتأبط هؤلاء العشاق، قنينات تحت معاطفهم سرا، عائدين إلى جحورهم، صائحين في دواخلهم «اللعنة، على من أنزل المشهد في قنوات الخريف العربي، بحقيقة مزيفة، حتى اعتقدنا أننا سنوزع ورود الياسمين على الجنوب والشمال، وبكل تأكيد على شمال إفريقيتنا، طاردين كل الأنظمة، وكل الطغاة، ومستبدلين دولا بدول أخرى، إلى غاية الانتشاء، بطرد الجمهوريات والجماهريات والمملكات، ضد الرؤساء والملوك والعسكر…لا مكان إلا لصوت الجزيزة ومعها العربية، وما أدراك ما الجزيرة والعربية، وهلم جرا من قنوات التغيير التي حملت جهابذة التحليل في المشهد التلفزي، ذلك الذي أسكر شعبا حتى الثمالة، بتقريب الحلم الذي امتزج فيه الخيال بشيء من الواقع المهدم لمفهوم الدولة والوطن والاستقرار، وكأن البداية هي إيمان بأن الصفر، هو حقيقة لانطلاق نحو أفق منشود، بمفاهيم غير محددة، عنوانها الكرامة والحرية والعدل، والحال أن الصفر كان بداية للانطلاق نحو المجهول.
كان السؤال، مشروعا، منطلقا من ذاكرة وشمت في محطات مختلفة، أن تونس تعثرت بالفعل في قضايا حقوق الإنسان، عندما اعتلت أصوات رفاقنا هناك، ضد كل مناحي القمع والتسلط، والجبروت الذي جعل بعض المتسلطين على الرقاب يتلذذون في ممارسة القهر على شباب وشابات تواقين إلى متنفس في حرية التعبير. وهو السؤال المشروع الذي شدني من قفايا وأنا أجهر بحقيقة، أن تونس الجبروت، كانت رائدة في الاقتصاد ومدبرة جيدة لملفات اجتماعية، وهي تونس التي وضعت برامج هامة واستراتيجية في قطاعات مختلفة ، قلنا في حينها إنه ينبغي الاحتذاء بها.
ولم أنس، أنا العارفة بخط العواصم المغاربية، عن قرب، وبكثير من الحس السياسي والمعرفي، أن قول الحقيقة جلب لي الكثير من المتاعب، عندما صرحت من إحدى الشاشات البديلة للجزيرة والعربية وما جاورهما، أن قطع الرؤوس إرهاب، وأن هدم الدول من بوابة استغلال فساد الأنظمة وجبروت حكامها هو بوابة للفوضى، ومجال لانتعاش تجار الدين وتجارالمخدرات والأسلحة والبشر. ساعتها سجلت اختفاء الكثير من مثقفي المنطقة، وانخراط آخرين في اللعبة باسم مفاهيم سامية في الديمقراطية وحقوق الإنسان. كان المشهد جد أليما، عندما رأيت مفكرين في حجم الحلم بالنسبة لي، يوظفون بل ويستعملون، بطرق مكشوفة، تنم عن رداءة الزمن ومشاهده،كانوا يرددون كالببغاء ما يقرره معدو القنوات المعلومة، أن قطيعة حصلت بين الذي كان، وأن الذي سيكون هو الجنة فوق أرض خلاء، والحال أن الخراب فوق ظهر دبابة مجسمة في هودج.