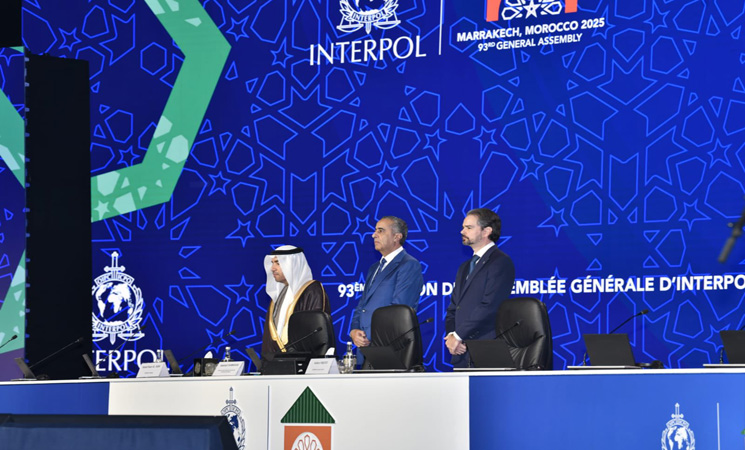مرة أخرى،تم بمدينة تطوان الجميلة شمال المملكة المغربية، قص شريط دورة سينمائية أخرى، وهي الدورة العاشرة لمهرجان تطوان الدولي لسينما المدارس (من 23 إلى 28 نونبر الجاري) والذي تنظمه جمعية (فداك/FIDEC) . في هذا المقال، سأحاول «الغطس» في ملصقه، بحثا عما يمكن أن يرويني. الملصق السينمائي، هو في العمق خطاب بصري، له قيمته الفنية والجمالية والثقافية والإنسانية ككل. عادة ما يمنحنا من يبدع عملا فنيا، فرصة «الاحتكاك» به بل فرصة «التشابك» معه/له، بحثا عن «تشكيل» أو كتابة عمل ثان على هامش العمل الأول.
عادة ما المكونات البصرية التي تخص السينما، تبدع من لدن من يمتلك حسا فنيا وجماليا، أي من لدن «مهووس» بالفن والجمال. الملصق الذي بين أيدينا، هنا، تمكن فعلا من ممارسة «سلطة» فنية علينا باعتبارنا متلقين له. مكونات عديدة تكون منها هذا الملصق «الدعائي» لهذه الدورة العاشرة، ذات البعد السينمائي المدارسي والتكويني، والمساهم في التربية على الصورة وبالصورة، ومن هنا تأتي قيمة وشرعية كل مهرجان أو ملتقى أو أي عمل يمنح للطلبة المغاربة فرصة لتقاسم تجاربهم مع الغير، وتمكين الغير(الآخر) الآتي من خلف البحرين المغربيين، من عرض أفكاره الفنية والثقافية، ليضعها بين يدي من له ثقافة تختلف عنه. كل ذلك يتحقق بواسطة الصورة، كأداة من أدوات التعبير الفنية التي بها نتقاسم فهمنا لذواتنا وللآخر وللعالم، وهو ما يساهم فعلا في خلخلة العديد من التمثلات السلبية، وتعويضها بأخرى ذات بعد إنساني (العالم يسع للجميع).
منذ البداية نجد أنفسنا ضمن مكونين أساسيين، وهما السماء والأرض. لندقق النظر في الملصق الحمال للعديد من الأبعاد والدلالات. سماء زرقاء تحتضن مكوناتها الطبيعية، نجوم وقمر. وأرض فيها وبها أنجز العمل، والمتضمن للعديد من الأيقونات الفنية والروحية والثقافية.
إننا هنا أمام مكونين أساسيين، وهما «الفوق» و»التحت». فهل من الممكن أن نقرأ «الفوق» ب»التحت»، والعكس صحيح وذلك ضمن رؤية تفاعلية بينهما، أي بين الأرض والسماء؟. بكل تأكيد، فحضور السماء بنجوميتها وقمرها، حضور له بعده الشاعري والجمالي. بعد، اخترق العديد من المكونات الشعرية والروائية والتشكيلية والسينمائية، الخ. كلما حضرت السماء في عمل فني ما، أتيحت لنا فرصة التأويل والبحث عن القبض عن لحظة سمو..لحظة من الصعب القبض عليها في الأرض، دون استحضار لمكون من مكونات الفنون (الفن كحاجة).
بكل تأكيد، ونحن أمام هذا العمل الفني، تتبادر إلى ذهن المتفرج/المتأمل، العديد من الأسئلة، لاسيما والملصق/اللوحة، تتفاعل داخلها مجموعة من المكونات المادية واللامادية، بل تتفاعل فيها العديد من المكونات ذات البعد المحيل على ما هو سينمائي ومسرحي واجتماعي/شعبي، الخ، مكونات من داخل السينما والمسرح، بعضها مستمد من بعض الأفلام (ذاكرة السينما) وبعضها مستمد من خارج السينما، وبعضها الآخر، يحيل على رموز تاريخية وروحية وعمرانية، مما يجعلنا نتشبع بالبعد الثقافي البصري لهذا الملصق/اللوحة، بل يجعلنا وكأننا أمام مرجعيات فنية ثقافية متعددة وخصبة آتية من مرجعيات، بعضها مرتبط بالذات المغربية، وبعضها الآخر أتي من الغير/الآخر، مما يوحي بتفاعل الذات مع الآخر، وهو من أهم ما تسعى إليه هذه المحطة السينمائية المدرسية الخصبة.
نوافذ وأبواب وفضاءات عديدة ( بعضها له بعد تربوي) وألوان (تزويق دال)، تحضر في هذا الخطاب البصري..عناصر تتميز بكونها مفتوحة (منفتحة) أمام الجميع. أمكنة منها يخرج الضوء/النور الهادف إلى قتل الظلام (الجهل). وأي نور من الممكن الاستمتاع به غير نور السينما؟. فماذا لو لم تفتح هذه النوافذ من لدن الفاتحين أمام من يوجد خلفها وأمامها؟.
حضور النافذة، هو حضور للرؤية الحالمة برؤيا عميقة ودالة. حضور من الممكن أن يفضي إلى خصوبة الذاكرة بل وجعلها مؤمنة بفعل السينما/الجمال. فتح النوافذ فعل من الممكن فهم قيمته من خلال عكسه أي إغلاقها. النافذة حينما تفتح، تغرينا، بالعديد من المقاربات ذات البعد النفسي والاجتماعي، الخ. كل فيلم أو عمل فني كيفما كان نوعه، هو نافذة تفتح على العالم الخارجي، لجعل الذات المبدعة (الفاتحة لها) تقدم فهمها للحياة أمام المتفرج. حضور النافذة، بهذا الكم الدال، والمهيمن على الملصق/اللوحة، يولد لدينا الانطباع، بقيمة هذه النافذة السينماتوغرافية، باعتبارها تشكل عينا بصيغ مختلفة، تعبر في حقيقة الأمر على الرغبة في تعدد الرؤى (وجهات النظر).
من جملة المكونات الحاضرة في هذا الملصق/اللوحة ، ملصقات سينمائية أخرى. ملصق داخل ملصق، وسينما داخل سينما، الخ، يجعلنا فعلا نقبض على لحظة سينماتوغرافية جميلة ولذيذة داخل هذا الملصق (الحديث عن السينما بالسينما). بل من الممكن اعتباره مشبعا بروح السينما، في سياقها الثقافي الشعبي أيضا، وهو ما تعبر عنه أيضا العديد من المرجعيات الفيلمية الحاضرة في الملصق، بل نتأكد من هذا من خلال المكونات الإنسانية الحياتية الموجودة أمام قاعة السينما (الدراجة النارية/ لحظة غرامية/…).
طبعا ما كان لكل هذه المكونات المحيلة على عوالم السينما، دون من يؤمن بالسينما كحلم.. الأمر يتعلق بجمعية فداك/FIDEC الصانعة لهذا الحلم. حلم تم رسمه على معلمة تطوان العمرانية المسرحية الإسبانية. خطاب مضمر من الممكن فهمه على أساس أن التعايش والتساكن بين الذات والآخر، حتما من الممكن تحقيقه بالفن.. بالسينما.. لاسيما تلك «الهاربة» من ضفاف نوافذ وأبواب المدارس السينمائية المكونة لرؤية/رؤيا سينمائية حالمة بغد أجمل خارج الحروب والدمار والخراب.. بل رؤية/رؤيا حالمة بالحق في الجمال.. الحق في الحلم.. الحق في السينما.. باعتبارها منقذة للذات وللأخر.
بكل تأكيد، تمكن من أبدع هذا العمل الفني، من حكيه لحدوثة سينمائية فنية بلغة سينمائية استلهمت من الذاكرة السينمائية والمسرحية، الخ، العديد من المكونات الخصبة والدالة. حدوثة بصرية منفتحة على العديد من الفنون/الألوان.. وهو ما جعلنا فعلا نفكر بالعين فيها.. وحينما تحضر العين، طبعا، تحضر ثقافة الفن والجمال.. والرغبة في تفكيك ما تشاهده العين، وفق ما يحلو لها، متمردة بدورها، ولو للحظات، عن العديد من أشكال «العنف» الذي يغزو عالمنا.. بحثا عن السفر في ذاكرة البوح.. والذي لولاه لكانت الحياة آفة كبيرة.