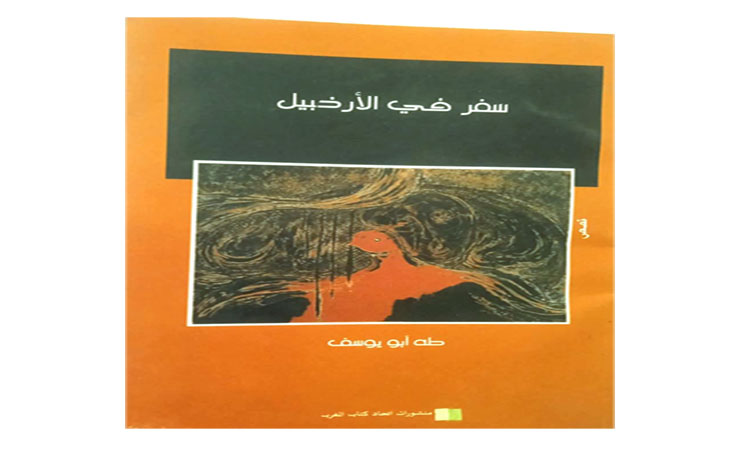يستدرجنا الأستاذ أبو يوسف طه، ونحن نقتفي أثر ترحاله الفنّي في مجموعة «سَفَر في الأرخبيل»(1)، الى خوض أطوار رحلة أخرى ممتعة ضمن جغرافيا نوعيّة، يتحكّم هو وحده في تعيين ملامحها، فيحدّد طبيعةَ تضاريسها ومناخها المستقرّ أو العارض، بأسلوب واقعيّ حينا وفنطازيّ حينا آخر، إلى جانب كونه هو من يرسم أيضا ملامح كائناتها النّشِطة منها والمتنشّطة(2)، والحالمة الآملة منها أو القانطة الخاملة. وإذا كان السّفر في اللغة العربيّة هو كلّ رحلةٍ، تؤطّرُها حركة الذّهاب أو الإيّاب النّواسة، التي تشبه حركة الرّيح وهي تذهبُ بالسّفير من الورق وتجيء به، كما يقول ابن منظور في لسان العرب (مادة «سفر»)(3)؛ فإنّ هذه الحركة الدّائبة، وهي تكنس الأرض كنسا، وتكشط قشرتها كشطا، ما تلبث أن تكشف عن المستتر والمتخفّي تحت أديمها، لتفضح بذلك ما كمن تحت السّطح. ذلك أنّ السّفر لم يُسمّ سفرا، كما يضيف ابن منظور دائما، إلا لأنّه يُسفر عن وجوه المسافرين وأخلاقهم، فيُظهِر ما كان خافيا منها(4). ومن ثمّ، تجرّنا هذه المعاني الأوليّة، الى أن نفترض من غير جزم، بأنّ السّفر الذي يدعونا إليه الأستاذ أبو يوسف طه، قد يكون حركةَ جيئةٍ وذهاب نوّاسةً بين أرض جَزور، بعضها متقارَبٌ ببعضها الآخر ومتعارض معه، تدفع بنا ريحُ تخييلها لكي نوغل السّير بين جغرافيتها الأدبية، للتّعرف إلى هذا الأرخبيل المؤطّر بمقصدية السّفور ربّما، وما تفترضه نوايا الفتْق والكشف. فما هي خصوصية أرخبيل هذه القصص، يا تُرى؟ وما الذي يُكوّن طبيعة فضاءاته التّخييلية؟ ثمّ ما ملامح ساكنته، المقيمة منها إقامة دائمة، أو النّازحة بدافع السّأم وضجّة الوجود؟
تتكوّن مجموعة سَفَر في الأرخبيل من مائة واثنتيْ عشرَة صفحة، وتضمّ بين دفّتيها إحدى وعشرين قصّة قصيرة، تغلب على عناوينها الإشارة التي تُعيـّن مدلولاتٍ متّصلةً رأسا، ببؤرة مركزيّة يمكن الاصطلاح عليها بعلامة: الذات/الإنسان، وهي علامة تتّخذ في بروزها ثلّةً من النّعوت والسّمات ضمن عناوين القصص، نذكر منها الصّفات التّالية: موظف بسيط، حارس، الرّجل، السّيد القرطبي، الفتاة، طامو، السّيد ماضينوف الرّجل، احْديدّان،،، الخ. كما يكنّى أيضا على تلك العلامة في عناوين القصص، بكُنى تشير الى إحدى لوازم الذّات الإنسانيّة أو أكثر، من قبيل: شفة، رأس، أصابع، عقل،،، الخ. في حين تحيل الموضوعات التي تتكوكب حول البؤرة المركزيّة السّالفة، على ثلّة من الأفعال والأحوال والصّفات، التي تكون لصيقة دوما بدائرة الذّات/الإنسان، لكونها إمّا صفاتٍ ملازمةً لهذه الذات، أو إكسسواراتِ وجودٍ إضافيّةً تنحصر مهمتها في تسليط الضّوء على ما يتّصل بدائرة الكائن، من أوضاع وشروط أنطولوجيّة متنوّعة تحياها الذات وتحيا بها، من قبيل: متاعب، أوهام، مبارزة، رغيف، سقوط، اغتيال، نهايات، متاهة… الخ.
ومن ثمّ، يجدر بالقارئ حتى ولو اكتفى بالتّصفح الأوليّ، فقط، للعناوين التي اختارها الكاتب لقصصه، سواء منها العناوين المركزيّة أو رديفتها الفرعية، أن يتساءل عن طبيعة العلاقة التي تتوخى تأسيسها جميع تلك العلامات الدّالة، في متخيل القراءة وسياقات التّلقي. وهل ثمّة من صلة يمكنها أن تربط بين بؤرة الذات/الإنسان، بمختلف أحوالها وإبدالاتها، وبين ما يمتّ بعلاقة للسّفر والأرخبيل، باعتبارهما دالّين بارزين في المجموعة؟ ثمّ هل تريد هذه الأضمومة أن تغرينا، من خلال غمزها الفنيّ الأوليّ، بالتسليم بأنّ الإنسان أرخبيل كامل التّكوين، وبأنّا كلّما اقتربنا من بعض جزره، أو انخرطنا في سبر جزء من أعماقه المسكونة بالأحلام أو الأوهام، كلما تحقّق لنا سفر في متاهة نوعيّة، لا تني تسفر عن وجه من وجوه الكينونة الممكنة لهذه لذات/الإنسان المشمولة بالّلغز الحرون؟
لنترك هذه الأسئلة الفكريّة والأدبيّة جانبا الى حين، ولنقترب الآن قليلا من عوالم المجموعة، من خلال الخوض مباشر في قراءة نصوصها، أو لنقل بالأحرى من خلال الخوض في استقراء وجوه كائناتها السّافرة/المسافرة.
تعمد نصوص المجموعة الى التّنويع ـ نسبيّا ـ في التّشكيل القصصي، فتستعمل تقنية الكتابة التّراسلية حينا، وتقنية كتابة التّقرير والبيان والبلاغ الصّحفي حينا آخر، أو ربّما هي توهم بإنجاز بعض ذلك وحسب، لأنّ مجمل نصوصها يراهن في الأساس على شكل الكتابة التّقليدية للقصّة، وأقصد البناء الدراميّ الذي يخضع لحبكةٍ تكون في العادة كلاسيكيّة، حتى ولوْ حاولت بعض القصص أن تخدعنا بانتمائها الى دائرة التّجريب الحداثي، بتشكيل يقوم إما على التّقطيع أو التّدوير الّلولبي لخاصية الزّمن، علاوة على نفحات مقصودة في بعدها الجامح فانطستيكيّا. ويتمّ جميع هذا في هذه القصص، من خلال تقديم محتوى حكائيّ يكاد يتماثل في كلّ النّصوص، لأنّ منطلقه ومنتهاه هي الذات/الإنسان، وبالتحديد معضلة تورّطها عامّة في المدينة(5)، سواء أكانت هذه الذات موظفا في إدارة، أم مجرد نزيل في زنزانة، أم طالبا، أم عاملا مياوما، أم خادمة، أم عميدَ شرطة، أم أرملة متروكة لوضع الضّائع، أم متشردا يحمل عاهة في جسده، أم كان غير هذا وذاك من مجموع هذه الكائنات الضّالعة في أزمة ضياعها الأنطولوجي.
لكنّ الملاحظ أنّ أغلب قصص المجموعة تحكي عن «أزمة المثقف»، أو بالأحرى تقدّم جزءا من معضلة ذات متعلّمة، تعيش وسط مدينة لا ترحم؛ مدينة «تمشي مقلوبة» على رأسها بفعل «سقوط العقل»(6)، سواء حين يتحرك المرء بين جادّاتها وأزقّتها المتاهيّة، أو حين ينقطع عن الآخرين، ويقبع وحيدا في شقته أو زنزانة عزلته، فينخرط في رحلة ذهنيّة مسجورة بالاستغوار، تنقله من حاضره البائس السّاقط، لتحطّ به بين دوائر ماض تليد، مضى عهده وانقضى مجده. ومن ثمّة، فإنّ سفر القراءة في سَفَر في الأرخبيل غالبا ما يجعلنا نلتقي بشخصيات كسيحة في وضعها الأنطولوجيّ والاجتماعيّ. فنلتقي بها هنا وهناك، تتحرّك داخل مدارات مدينتها المأفونة، بحثا عن منقذ، أو ربّما تكتفي بمجرد إحكام الغلق على الذّات، بين جدران محارِيّة كاتمة للصّوت والصّورة، قد تكون شقّة بإحدى العمارات الكئيبة، أو قد تكون مجرد حجرة غير متعيّنة، أو غير ذلك. وبإحكام الغلق عليها، تخوض الذات رحلتها الاسترجاعيّة، التي لا تخلو من سمات هذيانيّة، بمفردها أو بالاستعانة بمضاعف un double يتلبّس كينونتها، من قبيل ما يتمّ صوغه من طين الأحلام والأوهام.
وبهذا، غالبا ما تنتهي هذه الكائنات القصصيّة الى التبدّد في متاهة دائرتها، التي تشبه دائرة الحلزون المغتلم، وذلك من خلال مشاهد مشحونة بأجواء «كافكاوية»، نكاية في كافة الخلق، وزراية برتابة المعيش المقيت في مدينة تقتل الرّغبة في العمل والآمل، كما تحبط الذات النّشيطة العاملة وحتى المنكفئة على نفسها والخاملة. ففي متاعب موظف بسيط، يكتب السّارد رسالةً جوابيّة، يردّ فيها على رسالة سابقة، بعثت بها إليه صديقة قديمة، كاشفا لها عن أناه «المقنّعة المختبئة في الظلّ»، بلغة لا تروم التّستر على «الجُرم بدانتيل البلاغة»، فيندفع يحكي عن وضعه الهشّ، وكيف صار شخصية مرهَقة، أفلست ماديا ومعنويا في نهاية حياتها، ما فرض عليه اعتزال الناس أجمعين، بمن فيهم حتى زوجته التي لا تعرف عنه سوى شخصيته المُقنّعة(7). وبهذا، يقرّ المرسِل السّارد بواقع سقوطه الشّبيه بما جرى لأبيه، وكأنّ الزمن لم يراوح دورة السّقوط القديمة(8)، لينتهي صاحبنا بالتأكيد على انتظاره «للقفزة الهائلة، مثلما انتظرها والدي المسكين». وفي قصة حارس القيم، يكتشف البطل/الأب بالصّدفة، وجود كتاب قصصيّ كان مخبأ تحت وسادة ابنته المراهقة، فيشعر بوقع «وقوع الكارثة» على الأسرة كلّها، لأنه يعتبر بأنّ قراءة فتاة تعدّ «لؤلؤة العائلة النّادرة»، لأحد الكتب التالية: «الفتاة الحشاشة»، أو «الخبز الحافي»، أو «الضوء الهارب»، يعدّ إنذارا منذرا بوشك «الانهيار الفادح»؛ وبهذا يدخل هذا الأب ليلَ هذياناته المكفهرة، التي تعلن عن السّقوط والضّياع العامّين. وفي قصّة الرجل والرّصد والسّقوط يكتشف السّارد بأنه يعاني من آثار السّقوط من حوله، وأنه انتهى، فيقرّ صراحة «أنّي متّ»، ليبقى بعد ذلك منبطحا «ينقّ كضفدعة»، وقد غرق تماما في لجّة هذيانه. أمّا في قصّة أوهام السّيد القرطبي، فيلتقي السّارد – وهو في نشوة ربيعيّة من أمره – بصديق قديم، تظهر عليه ملامح «عياء مفرط»، ويعاني من لوثة في عقله بفعل ماضي الانتهاكات الجسيمة. وقبل أن ينسحب، يسلمه هذا الأخير ورقة، تتضمّن بلاغا صيغ ببلاغة مهلوسِة، يكشف فيها عن اختبال عقله، بفعل آثار ما عانى منه خلال سنوات الجمر والرّصاص. وفي قصة المبارزة، يرفع البطل عقيرته في التذاذ، وهو يصيح: «الوحدة! ما ألذّ أن يكون الإنسان وحيدا!»، ثم سرعان ما ينبثق مضاعفه فجأة من فراغ الشقة، ليمارس عليه نقدا لّاذعا، يضاعف من محنة هذا المتعلّم الذي يعيش وحدته، في أجواء يلازمها رهاب لازب، علاوة على الشّك والتّردد والخوف. وحين يبارز مضاعفه في غابة مجاورة للمدينة، يكتشف في لحظة إدراك مشحونة بوعي كافكاوي، بأنه لم يبارز غير نفسه، وأنّ أصابعه تنزف بدم غزير.
إنّ ما يمكن استنتاجه الى حدّ الآن، من مجمل هذه النّماذج التّمثيلية، كون أغلبها يؤكّد على هيمنة ثيمة أساسيّة لازبة على قصص المجموعة، وهي أزمة عيش الذات في فضاء مدينة، يحكمها الاستبداد والظلم والفضول الكابس على النّفس؛ مدينة كلّ من دخلها موؤود، وكل من خرج منها لا يشبه المولود. إنّها مدينة «تمشي مقلوبة» على رأسها، فتعاكس بهذا رغبة ساكنتها من المتعلمين والمثقفين الحالمين بأفضل البدائل، لأنها غول مفترس لا عقل له، بل إنّها غول محارب للعقل، مجاف ونافٍ له. ومن ثم، لا يُستغرَب أبدا أن يسكن أركان هذه المدينة، الى جانب جحافل الموظفين البسطاء وفيالق الفقراء الجوعى الى كلّ شيء، مجموعة أخرى من الأثرياء محدثي النعمة الذين كانوا بالأمس القريب مجرد أميّين معدَمين، فإذا بهم يصيرون بقدرة قدر قاهر من مترفي القوم، الذين يعلنونها حربا شعواء على الكل، بما في ذلك ماضيهم بالذات(9).
وبجانب هؤلاء وأولئك، يقطن بمدينة هذا الأرخبيل القصصيّ، جيشٌ عرمرم من المخبرين ورجال الشرطة، على اختلاف رتبهم ومهامهم ومسؤولياتهم. وهم لا يسكنون ليسكن إليهم الغير، وإنّما يزرعون الخوف والرّهبة والخيفة في القلوب، إلى جانب ما يرسمونه على أجسام الغير من أثلام وأوشام، وما يفرضونه من التزام بما يكفي من الحيطة والحذر بصحبتهم، وهذا ما يجعل ذهن بعض الشخصيات المصابة بالرّهاب، يتروّع ويتلوث كما هو الشأن في قصة الرأس والديناميت، حيث يكشف السارد عن فلسفته في الحياة، التي تنمّ عن قدر كبير من الخوف والذعر. يقول مثلا: «وتيقنت أنّ حذري الدائم في محله، لأني أميل الى الأخذ بأنّ عالما كافكاويا هو معادل لعالمنا في كثير من الأشياء، والعقلية الحذرة هذه تجعلني دائما متحفظا من النقاش المفتوح والثقة غير المبررة».
والى جانب كلّ هذا، تكثر في هذه المدينة أشكال الجريمة، سواء ما كان منها رمزيّا من قبيل ما يسحق الأرامل والخادمات سحقا اجتماعيا واقتصاديا، لا رحمة فيه ولا شفقة: قصة الرغيف وقصة الفتاة والكلب؛ أو تلك الجرائم التي يرتكبها بعض الجناة خطأ، بسبب كبت جنسي واجتماعي راسخ في بين طبقات بنيتهم النّفسية غير السّوية، كما في الشفة الشوهاء؛ أو تلك التي تقترفها عن سبق إصرار وترصد زبانية من العتاة، الذين ينحصر همّهم الوحيد في التّربص بالغير وحسب، كما في قصة المتاهة وغيرها.
وعليه، تقودنا المعطيات السّابقة الى التّأكيد على أنّ مجموعة: سفر في الأرخبيل، تختار التقدّم الى قارئها من منطلق واقعية ذاتية un réalisme subjectif(10)، وهي واقعية تقوم على وصف أغوار الذات ووعيها، وصفا ذاتيا صرفا يرتبط رأسا بثقافة السارد/ الكاتب، وربما حتى ببعض قناعاته، سواء منها ثقافته العالمة أو العامية. الأمر الذي يحيلنا على خريطة من المرجعيات المعرفية، التي تتحدد معالمها الطوبوغرافية في أمكنة معلومة لدى أبي يوسف طه: مراكش بساحتها الشّهيرة وأحوازها مثلا، أو تتحدّد في بعض الأسماء الأدبيّة والعناوين الشّهيرة: كافكا، خوان غويتيسولو مثلا، ثم روايتي محمد شكري وبرادة: الخبز الحافي والضوء الهارب. ومن ثمّ، تندغم ضمن هذه الواقعية الذاتية سيرورة الزمن القصصي، فننتقل في الغالب الأعم من طبيعة خطية الى طبيعة لولبية دائريّة، ومن مسار أفقي للمحكي الى حلقات غائرة في عماد الذات وعمودها، وهو ما يعطي للبعد القصصي في كثير من النصوص، صبغة شاعريّة تنزاح بها عن التّقريريّة، ويجعلها في لحظات معيّنة أقرب الى قصائد شعرية تراجيديّة، تلهج ببعد مأساوي يكشف عن بنية السقوط العامة، التي طالت كل شيء، وانطلت على الجميع.
وبالجملة، فإنّ نصوص هذه الأضمومة القصصيّة الشّيقة، بقدر ما تحكي عن أحلام كائنات محطمة وجدانيّا واجتماعيّا، وتكشف ببلاغتها السّرديّة الكثير من الأوهام المنكسرة، سواء بلغة المُحبَط المستسلم، أو المتشكّك المنشغل بشحذ سَنّ السّؤال بين أركان الذات، أو من خلال مسافة المرتاب الذي يكتفي بوصف واقع التفسّخ العام، بآلية عالِم التّشريح الذي ألف التعامل مع الجثث المشوهة، دون إبداء أيّ تعاطف يستفاد منه سُلو أو تأفّف؛ بقدر ما تجعلنا أيضا نسلّم بأنّ الزمن المغربي لم يراوح لحظة السقوط والانتظار بعدُ، من خلال غمز دلاليّ وفنيّ ثاقب، يكشف فيه الكاتب من خلال سفره في هذا الأرخبيل، بأنّ مجموع الجزر المجتمعيّة معطوب، وينذر «بانهيار عالم باذخ من الترتيبات ومن الطمأنينة الفردوسية»، كما تقول قصة حارس القيم.
* تقدّمت بهذه الورقة ضمن أعمال المهرجان الوطني السّادس عشر للقصّة القصيرة، الذي خصّصت دورته هذه السّنة للاحتفاء بتجربة الأستاذ أبو يوسف طه القصصيّة، بمدينة مشرع بلقصيري، أيام 28/29 يونيو 2025.
الهوامش:
1) طه أبو يوسف: سفر في الأرخبيل، منشورات اتحاد كتاب المغرب، الطبعة الأولى، 2014.
2) المُتنشّط هو الرّجل «إذا كانت له دابّة يركبها، فإذا سئم الرّكوب نزل عنها». وما يهمّنا في هذا الكلام هو لفظة سئم، التي تشير الى الحالة/الحالات النّفسية، التي تنتاب عددا لا يستهان به من شخصيات «سفر في الأرخبيل» لأبي يوسف طه. أنظر مادّة «نشط» في: لسان العرب لابن منظور، دار صادر، بيروت/لبنان، الطبعة الرابعة، 2005.
3) ابن منظور، لسان العرب (مادة سفر)، نفس المعطيات السّابقة.
4) نفس المادة والمعطيات أعلاه.
5) صحيح أن أحداث بعض القصص تجري خارج المدينة، إما في ضيعة تقع بناحية إحدى المدن، أو في بادية أو صحراء، إلا أنّ أغلب القصص لا تنفصل عن دائرة المدينة. أنظر على سبيل المثال، قصة «حكاية حديدان»، و»المتاهة» اللتين تجريان خارج مجال المدينة.
6) كما في قصة: المدينة وسقوط العقل.
7) أغلب الشخصيات في المجموعة يناوس بين ظاهر لا يعكس الباطن أبدا، لأن ذلك مجرد قناع بعيد كل البعد عن جوهر الشخصية. ولعل السبب في ذلك يؤول الى سلطة الجور الكاسرة في المدينة، التي فرضت على الكلّ التعامل تقريبا بهذه الازدواجية، حتى لا تقع الشخصيات في مطبّات غير سارة. تقول إحداها، مبرّرة الخوف الذي ينتابها من البوح، وتحفظها على إظهار ما تؤمن به بكيفية مفتوحة وواضحة: «العقلية الحذرة … تجعلني دائما متحفظا من النقاش المفتوح، والثقة غير المبررة» ص: 70، قصة الرأس والديناميت.
8) يستعمل الكاتب لفظ «سقوط» بشكل متواتر في أغلب القصص، سواء بكيفية صريحة أو من خلال أفعال مرادفة، من قبيل فعل: هوى، وقع، انهار، انبطح، هطل،،، الخ.
9) كمثال على ذلك شخصية سلمى، في قصة دائرة اللهيب الأزرق، التي تحارب من أجل نفي اسمها القديم بالذات: عبوش!
10) يرتكز عمل أغلب المنظرين الذين نحتوا هذا المصطلح، على أعمل غوستاف فلوبير Gustav Flaubert سواء في روايته: «مدام بوفاري» أو «التربية العاطفية». أنظر في هذا الصدد مقالة الناقد الفرنسي: ميشيل رايمون Michel Raimond الموسومة بعنوان الواقعية الذاتية في رواية التربية العاطفية: Le réalisme subjectif dans «l’éducation sentimentale» المنشورة خلال شهر مايو 1971، ضمن كراس الجمعية العالمية للدراسات الفرنسية AIEF العدد: 33، باريس (بالفرنسية). وتقوم الواقعية الذاتية على تمثّل الواقع، تمثّلا منزاحا عن الواقع الموضوعي، وذلك من خلال عدسة وعي الشخصية وإدراكها المفعميْن بمشاعر وعواطف وانفعالات ذاتية صرفة، تترجم في الأساس وعي الكاتب وإدراكه؛ بخلاف الواقعية «الموضوعية» أو الطّبيعية.