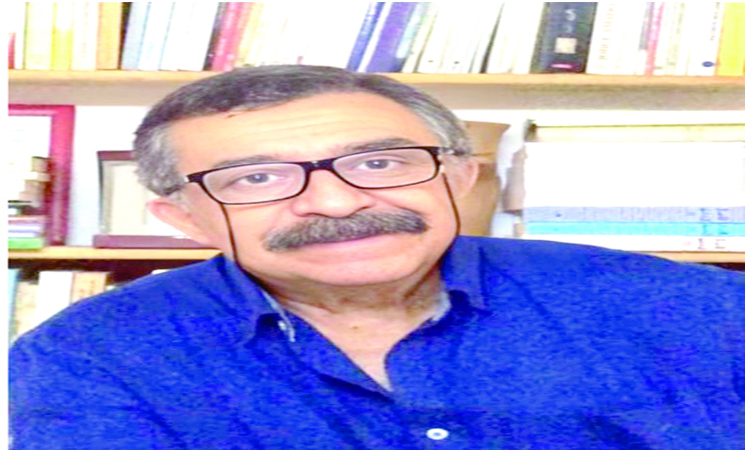على خلاف مجمل أنساق القراءات التي تتأول الاستعارة كناظم « تجميلي « في صوغ النص الشعري، نذهب في تأويلنا منحى مغايرا يتناظر ( من النظير) مع مذهب جون برغوس في كتابه « من أجل شعرية للمتخيل «(1982) الذي يعتبر الاستعارة محفلا أو ترهينا( instance) جذريا لتأسيس المعنى.
إنه يعبر بوعينا البلاغي من حد النظر إلى الاستعارة ك(صنعة – تنميق- ornement- fabrication) إلى أفق وعي يجعل منها فعل(خلق – création)،لتكتسب بذلك دينامية اشتغال نصي يفجر مبدأ القياس التشبيهي الذي يروم مضاعفة الواقع بالمجاز ، مؤسسا لـ»واقع جديد « يجعل التخييلي والمتخيل موطن الحقيقة الشعرية، باعتبارها المعنى الاصل –المؤسس.
عادة ما أقول مثل هذا الكلام بالانطلاق من النص الشعري كاستدلال مرجعي، وذلك لأني لا أجنح جنحة النقد الأدبي(الإسقاطي) الذي يضع النظرية سابقة على النص الإبداعي شأن من يضع العربة قبل الحصان، لذا أوضح في هذا السياق أن «التقديم والتأخير» وهما – كما تعلمون- من فروع علم البلاغة من مقاصدهما البيانية والمنهجية التأكيد والرجحان.
ذلك أن قراءتنا الأولى (القراءة – المسودة) لديوان الشاعرة حفيظة الفارسي «خوذة بنصف رأس» أثبتت لنا هذا التأكيد والرجحان، الداعي للقول بأن أبرز مدخل لقراءة هذه التجربة الشعرية يكمن في «فيض الاستعارة المؤسِّسة»، التي تأخذ شكل نسق نصي بان للحمة متخيل إبداعي ينهض على ارتكاز دلالي مهيمن، لا يتوقف فيه الأنا الشعري (وهو يطرح سؤال الذات) عن تأسيس تمثلاته المجازية البانية والمؤسسة من خلال استعارة الغيرية لذات ووجود وواقع (آخر) مفارق واختلافي.
نقرأ من الديوان :
«ثمة
نشيد مبحوح
في حاجة إلى شفاه
ثمة
أشياء ضائعة
تحتاج إلى ترميم») ص72)
يختزل هذا النص في بنيته النووية، مبدأ تأسيسيا بوقوفه عند متلازمة الفقد والحلم. ثمة في مشهد الحاضر-الآن: ذات في كمون الصمت – الغياب تحلم بلغة ثانية، وواقع يتشظى في الضياع والفقد يحلم بإعادة البناء.
النص تجسيد لـ»لحظة طللية «لكن على خلاف النص الشعري الجاهلي ليست مقيدة الأوابد إلى زمن النسيان كمحو يصبو لاستعادة الماضي، بل هو نسيان من داخل النص يتمفصل مع ما يسميه دريدا بـ «يقظة الكتابة»، في الغور العميق لما يعبر عنه موريس بلانشو:» أن أفقد نفسي بحيث أجد نفسي يوما ما! «حين يصير الشعري رغبة جديدة في التحدث عن صمت الحقيقة الذي يحتجب عنا.
تمثل قصيدة «رئة ثالثة» إشعاعا مرآويا لتشاكلات المعنى الشعري المطارح لسؤال الكينونة بين حدي الفقد والتأسيس، وهي قصيدة تتشعب فيها الصور المتخيلة للاستعارة الغيرية :
«أحفر
وأحفر
أين الضوء الذي يقودني إليك
إلى صوت الله في المحارة
إلى انمحاء الأثر في العبارة
إلى رعشة الومضة
حين تنفتح السماوات السبع
بين راحتي درويش
أنا الآن أكنس الأنقاض
بعد أن تفحمت رئتي
أطرد الهواء المثقل بالغبار والحرائق
أرمم وجه المرآة
أعيد تركيب الشظايا في دمي
فينبت لي جناحان من زجاج
أنا الطائر الذي ضيع السرب
فعاد إلى عشه
الجناحان
رجاء معلق بالهواء
والريش
رحْلُ المسافرِ
فكيف يزهر الغناء
من لحاء الشجر» ( ص35-37)
تتجوهر الاستعارة الغيرية كمجاز عبور من حد العدم(أنا الآن أكنس الأنقاض) إلى انبجاس رؤيا التكوين(أرمم وجه المرآة لأعيد تركيب الشظايا في دمي). ويستفيق صوت الكينونة من خلال متخيل إشراقي صوفي :
– الضوء الذي يقودني إليك
-صوت الله في المحارة
-انمحاء الأثر في العبارة
-انفتاح السماوات السبع بين راحتي درويش
وأيضا من خلال الترميز ب»صورة الطائر الذي ضيع السرب وعاد إلى عشه» ، ولا أدري، هنا، هل تعمدت الشاعرة التناص مع مجازات «منطق الطير»لفريد الدين العطار، أم هو فقط أثر من لا وعي النص، فالمعنى هو ذاته ( مسعى وسفر الذات اقتفاء وبحثا عن مطلق اكتمال).
لا تنشأ الاستعارة الغيرية كاستجابة لأنظوم محاكاتي، بل كفعل خلق وتأسيس، لأنها متحررة من القياس (أنا أشبه هذا..) آخذة معنى (أنا هذا.. )، يكتنز القول الشعري بمحمول هذا المعنى في قصيدة « لا بيت لي «، نقرأ منها:
«لا ظل لي
كالنار
أتآكل
دون أن أترك ندوبا
على وجه الليل
يدي الأولى مشغولة بنحت اليأس
والثانية تلوح لنجمة في الذاكرة
فمن أشعل النار إذن؟!) ص15- 16)
الخيال الاستعاري في هذا الاستدلال الشعري بتفكيك نصانيته المجازية يكشف عن دينامية اختراق وعبور تتجسد في قلب للمعنى والدلالة من اللوغوس إلى الميتوس، إذ تلجأ الشاعرة إلى تناص رمزي مع أسطورة الكهف الواردة في كتاب الجمهورية لأفلاطون. تحل النار محل الشمس، ويحل الليل محل الجدار، لكن ينتفي مبدأ الانعكاس المحاكاتي بقول الشاعرة «أتآكل دون أن أترك ندوبا على وجه الليل»، لتتولى الاستعارة التأسيسية متمثلة في قول الشاعرة
«يدي الأولى مشغولة بنحت اليأس/ والثانية تلوح لنجمة في الذاكرة / فمن أشعل النار إذن ؟!»،
هكذا يتم تقويض مبدأ المماثلة بتجذير المعنى في صلب شعرية للنفي ( (Poétique de négation تؤسس لصورة كينونة اختلافية مغايرة، كينونة تنحت ميلادا وجوديا من «صرخة اليأس»، والترميز هنا تضميني يستعيد أسطورة سيزيف الذي حكمت عليه الآلهة بالشقاء الأبدي، وتنحت ذات الميلاد من «ومض نجمة في الذاكرة»، حيث تتبدى لحظة الميلاد متجذرة في الزمن الغسقي الميثي، وحيث الذات والكون يكشفان عن تولدهما في العبور البرزخي الدائم بين الآنية والذاكرة / المطلق، في وهج الرؤيا التأسيسية بين نفي القدرية ورهان الاحتمال والسيرورة.
تنتصر الشاعرة لـ»الوظيفة الأسطورية» في التكوين الجينيالوجي لمتخيلها الرمزي، وفي شعرية التأسيس الأسطوري تصير الاستعارة طين وماء و نار وريح مبدأ المجاز المؤسس.
يتوحد هذا الإدراك الشعري بالرمزية الكبرى لقول ف.هوغو الشهير»خلق الله العالم شعرا» للدلالة على أن وظيفة الشعر اليوم ليست محاكاة العالم بل خلقه وتأسيسه . الشاعرة تتلمس في إدراكاتها وتبصراتها مكامن هذا الوعي وتؤمثله قائلة:
« خذ كل شيء
واترك لي العاصفة
أقلبها في فنجان قهوة
وأنا أرقب قصيدة تتهجى يتمها
وتمسح خدها بين الجمل والفواصل») ص13)
«أبحث عن حروف اسمك بين الضمة والأخرى
عن قلبي بين الكسرة ونقط الحذف التي
تباغتني في الغياب) «ص53)
«وأنا أمضي في الطريق إليّ
لا تلتفت
ربما سقطت ريشة من جناحي
رجاء لا تلتقطها
واتركها ترمم هذا الجسر الخرب
الذي يفصلنا» )ص20)
اليتم، الغياب، الخراب مجازات كينونة منتزعة الجذور –Déraciné)، تبدو كلها فضاءات فقد، لكن إذ تخترقها استعارة الغيرية تتحول إلى مسكن لمجيء المعنى: مسكن (Demeure) بالمعنى الهوردليني كما يتأوله هايدغر.
ديناميات هذا الخيال الاستعاري المؤسس نجد لها تمثلات وتحققات نصية في تجارب عدة من الشعر المغربي، سأكتفي باستشهادين:»سلالم الميتافيزيقا» لعبد الله زريقة ، و»وصايا ماموت لم ينقرض» لمحمد السرغيني»، وهي كلها تجارب تتشاكل في ترجيع الغاية التي عبر عنها جون بول روسي:» لا يمكن للشاعر أن يحاول البحث عن جواب للغز وجوده الخاص».