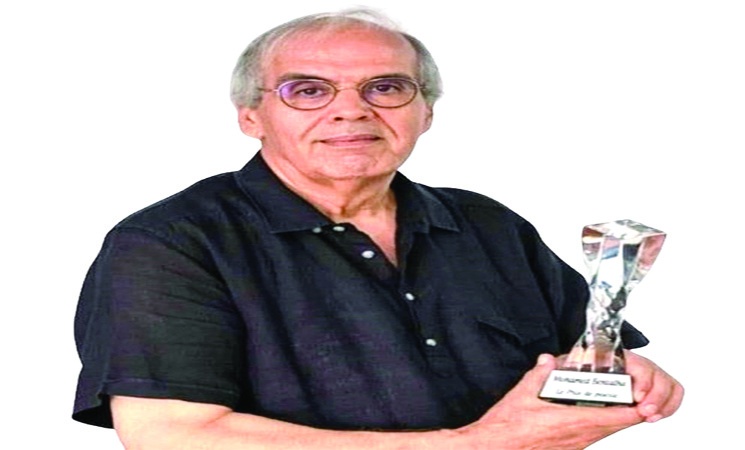أعجبتني، أيّما إعجاب، فكرة جمع إنتاجين شعريين للشاعر المغربي مبارك وساط، أحد أبرز الأسماء التي أعادت تشكيل خرائط قصيدة النثر في المغرب، وأعادت الاعتبار لطاقتها على فتح نوافذ جديدة في الحساسيات الجمالية. فالاحتفاء بمجموعتيه «محفوفًا بأرخبيلات» و»راية الهواء» بدا كما لو أنه احتفاء بعودة الشعر إلى صوته الأول، ذلك الصوت الذي يتردّد في الروح أكثر مما يستقر على الورق.
التحليق مع وساط، في الواقع، ليس مغامرة لغوية فحسب، بل تجربة وجودية محفوفة بالفخاخ: فخّ موت لا يأتي أبدًا، وفخّ هواء يتجاور مع الفراغ حدّ التماهي، كما لو أن الشاعر يكتب من حافة عالم آخر، ويتقدّم إلينا من منطقة بين-بين، حيث تعجز المفاهيم النقدية المألوفة، من بلانشو إلى باشلار، عن الإمساك الكامل بما يحدث هناك. فقصيدته ليست بناءً بل انهدامًا مُضيئًا، وليست معنى بل أثرًا يُخلّفه المعنى أثناء هروبه.
يكتب مبارك وساط بيدين «ساحقتين». يدٌ تحفر في اللغة كما لو كانت تستخرج بقايا زمن غابر، ويدٌ أخرى تنثر الدهشة في الهواء فترتدّ القصيدة إلى صمت يتخلّق منه الكلام. يدٌ هي أثر الصنعة، ويدٌ هي أثر الغموض. وهذه الثنائية تُذكّرنا بما أشار إليه بول فاليري حين كتب: «الشعر هو ذلك الشيء الذي لا يكتمل إلا لينقضّ على نفسه». وهكذا يبدو وساط، يكمل نصّه ليعيد تفكيكه، يرفع المعنى ليتركه معلّقًا في فضاء بلا يقين.
لغته، وإن بدت مشغولة بشهوة الانفلات، هي في العمق لغة ذات هندسة سرّية، تتغذّى من خيال تناصي يحوم فوق أرخبيلات من الذاكرة الشعرية العالمية: من سيوران إلى رامبو، من أدونيس إلى إمبرتو سابا. لكنها لغة لا تخضع لأي جهاز مفهومي جاهز؛ بل تصنع جهازها الخاص، ذلك الذي يقيم عند تخوم الغرابة، في منطقة يتجاور فيها الوعي بالعالم مع شكّه، والخيال مع هشاشة الوجود.
وعلى عتبات نصوصه، تتكاثر شرودات وتأوّهات تبدو مثل نُذُر صغيرة، إشارات إلى تلك التحيزات الوجدانية التي تظلّ اللغة عاجزة عن ملامستها بالكامل. فوساط يكتب وهو يعرف أن كل محاولة للمعانقة محكومة بالفشل، وأن الشعر، كما قال هايدغر، «موطن الكينونة» لكنه أيضًا موطن انزياحها المستمر. لذلك، تبدو قصيدته دعوة للتماس مع ما ينفلت، والإمساك بما يتفلّت، والإقامة في فجوة لا تُملأ.
إنها كتابة لا تريد أن تُقنع، بل أن تُربك؛ لا تسعى إلى الوضوح، بل إلى فتح المسارب نحو ظلال جديدة. كتابة تُعيد إلينا وعينا بأن الشعر ليس مرآة، بل رجةٌ في المرآة؛ ليس وصفًا للعالم، بل سؤالًا حائرًا يُلقى في وجهه.
وهكذا، يصبح الاحتفاء بمبارك وساط احتفاءً بواحد من الأصوات التي فهمت أن قصيدة النثر ليست شكلًا، بل مصيرًا، وأن الهواء، حتى حين يُرفع راية، يظلّ أكثر وفاءً من أي يقين.
هندسة الصمت… وتصدّع الأبدية
في ديباجته الأولى على حافة الأرخبيلات، لا يكتفي مبارك وساط باستدعاء صورة المكان، بل يفتح متاهة الألم كما لو أنه يجرّ الكون إلى جرحه الداخلي. إنها تلك الشرارة التي تهمس في زمنٍ لا نصيّ، حيث الكلمات مجرّد بقايا لشيء أكبر، وحيث القصيدة تكتسب شكلها من ارتجاف الحلم وهو يُبتر على حافة الآتي. كأنها كتابة تفتّش على طريقة موريس بلانشو، عن المسافة الفاصلة بين العيش والكتابة، بين الألم وصداه، بين ما يحدث وما يعجز عن الحدوث.
في قصيدته «الأبدية» يواجه القارئ بياضًا مدمّى. بياضًا يذكّر ببياض باشلار حين يصبح «مكانًا لارتعاش الذاكرة»، لكنه هنا بياض ينزف، تتحرك داخله زوابع غامضة تفرّ نحو حتفها بلا مقاومة، كأن الأبدية نفسها لم تعد وعدًا بالدوام، بل مسرحًا لفناء دائم. كل شيء في نص وساط يتقدّم نحو نهايته، حتى وهو يكتب بدايات لا تُحصى.
أما البقاء في «الغرفة النظيفة» فهو استعادة لمعنى العزلة بوصفها فضاءً للتطهّر لا للهروب. غرفةٌ تضيء من الداخل، لا لأنها معقمة، بل لأنها تتيح للشاعر أن يرمّم فوضى العالم بحركة قلم واحدة. فالعزلة لديه ليست انسحابا، بل شرطا للوجود، كما عند هنري ميلر، حيث تُخلق الحرية في مساحة مغلقة، ويصير الصمت أكثر صدقًا من اللغة.
يكتب وساط بروح أخرى، روحٍ تُقيم خارج حدود الخيال وضمنها في آن، كما لو أنه قابل للانفجار في أية لحظة. قصيدته متوترة دائمًا، متحفّزة، تسير بدون أشرعة ومع ذلك تحمل سفينتها عبر مياه غير مرئية. قصيدته ليست مجرد نصّ، بل كيانا نابضا، عاصفا، يهدد بالانفجار في أي لحظة، انفجار المعنى، لا اللغة. انفجار الصمت، لا الكلام.
ولهذا تبدو قصيدته الكثيفة، المعتقة، الصامتة، كطلعات طائرات انتحارية صغيرة، تومض في الأبعاد النائية المظلمة، تحمل أنوار التبدد أكثر مما تحمل الهدى. إنها قصيدة تُقام في المنطقة التي يصفها «لاكان» بـ»الواقعي الذي يستعصي على التمثيل»، حيث العيون التي تقرؤها لا ترى النص وحده، بل ترى ظلّه، وترمق ارتجافه في صمت مهيب يشبه انتظار شيء لن يحدث أبدًا.
وفي نصّه «هامش لصهيل فنار» يتخذ الصمت شكل ملاذ مبعثر، ملاذٍ يكسوه صدأٌ عطِش، وكأن الريح نفسها تخاطب صداها في مرايا مكسورة. هناك، بين التنائي والإبرام، يتخذ المعنى وضعية الحلم: لا يتحقق، ولا ينفلت. قصيدة تُستباح لغتها في إيغال خفيف، كمن يلامس بحنان جدارًا متهالكًا يدرك أنه سينهار لا محالة. وبهذه الحركة الدقيقة، التي هي في ذاتها جمالية وساطية، يروض الشاعر المعنى كي لا يستقر، ويمنح الكمال في لحظة فقدانه.
هكذا، يتحول الشعر عند مبارك وساط إلى تجربة هدم وبناء، إلى غواية لا تسعى إلى إقناع القارئ، بل إلى زعزعة يقينه. قصيدة تُكتب من منطقة التماس بين الصمت وضرورته، بين الوجود وغيابه، بين الضوء وهو ينطفئ، والظل وهو يزداد امتلاءً.
ما يسترعي الانتباه هو هذا التغافل العميق للزمن، تكلّسه وانشداده إلى أفقٍ ثاوٍ، حيث تتشكّل لحظات الشاعر خارج هندسة الانتظار. كأن الزمن يتحوّل إلى علامة مستعارة لكبح صيرورته، أو كأن الشاعر يمارس دهاءه الأخير ليحوّل الوقت إلى مجرد وهم يتداعى. فخلال هذه الرحلة، يظل الشاعر باحثًا عن فعلٍ قادم، عن مجهول يستعصي على القبض، كأن الوجود نفسه مؤجل إلى إشعار غير مُعلن.
فـ»الفجر مجروح مصفّد» وقد تحرّر من الخرافة، بينما «الأمسية» تمتزج فيها موسيقى خافتة مع «مطر» يسقط من شرفة الذاكرة، و»بهلوان» يقف على حافة تأويله، و»جثث طافية» تعبر مجازات العدم، قبل أن تتحلق خلف المعرّجات المبدِّدة لأسئلة الانتظار. وفي هذا التوغّل الموحش، يصبح الغرق مشروعا وجوديا، حين «نمسح عن الصخور سقمها»، ونروي «حكايات بمكبرات الصوت كي تلتقطها آذان الغرقى»، كأننا نعيد ترتيب الخسارات بطريقة أكثر يقينًا.
ويمتد العمر هنا كمسافة إضافية لا تُقاس بالخطو، ولا تنتهي بانتهاء الشكوك والارتيابات، بل تتسع كلما ضاق المعنى، وتكبر كلما انكمش الضوء، في دورة لا يخرج منها الشاعر إلا ليعود إليها أكثر عطشًا، وأكثر شغفًا بمطاردة الظلّ الذي يفلت في كل مرة.
وبينما ينقّب الشاعر وساط في كينونة الزمن، يقلب طبقات تأويله المبطّنة كما لو أنه يمارس تعرية غائرة لأتون الروح ذاتها. تلك النار الغريبة التي تأكل كل ما هو سائل، لا تهدأ؛ «تسعل كالساعات»، وتحتقن بـ»سُلّ قديم»، وتدمدم بجنون يفوق احتمالات السرعة. ينتظر الشاعر مرآته كي تنفلت من نمطها، من ذلك القضاء المقيد للذات، لعلها تستريح في «الصيحة الأولى»، الصيحة التي تتقعّد أواصرها على تخوم الذاكرة قبل أن تنشطر إلى كائنات مستفزة وقاسية. إنها حدوسٌ تحكي قصصها الفريدة، ثم تؤوب إلى أنفاس الصيف، إلى تلك «الحاشية» التي تتمترس خلف ضحكة الجبل، حيث الفيالق المستيقظة منذ زمن سحيق تخوض حروبها الصغيرة، غير آبهةٍ بشداد الآفاق القابعين في زوايا العراء.
وحتى «لا ننسى» تلك الرزايا الجائفات، يكتب وساط: «يحدث إذا ابتعد الأعمى، محفورًا بهسيس الظلام، أن تنبثق من بؤبؤيه عصافير براقة»، أو «تتفتّح عيون الطلّ، وتتقمّص الأزهارُ شفاهَ الغواني». هنا يصبح العمى ضوءًا آخر، ويغدو الظلام نفقًا يتلألأ من الداخل.
وفي «مرثيته للصباح الصغير»، يجوب الشاعر شوارعه المستهامَة، يهيم على خطى سقراط، كصباح هشّ يمشي تحت صراخ أسنانه، يفكّر «في الأسى الذي يولد في سهوم الأظافر»، بينما يسري في ذلك الثقب المخفى «سرّ حلم وجيز، كجدول ضوء تبدّده الشموس المنطفئة».
شعرية الانخطاف وميتافيزيقا الجرح
من ينقاد إلى دهشة الشعر، لا يعود كائنا عاديا، بل يتحول إلى ما يشبه كائنا حدوديا، يعيش في ما يسميه فوكو «المنطقة الرمادية بين الخطاب والصمت». فالشاعر الحقيقي، من يتقن فن تفكيك ذاته. يعرف أن الحقيقة ليست مرآة، ولا صورة، ولا يقينا، بل هشيم معنى يتطاير كلما حاول الإمساك به. إنه يُدرِك، كما قال موريس بلانشو، أن «الوجود يُرى فقط حين يتوارى». وما يراه الشاعر ليس الحقيقة، بل ضوء الحقيقة وهي تفرّ منه.
ولذلك، فالبحث عن الحقيقة وسط خرائب العالم ليس فعلا معرفيا، بل مغامرة وجودية محفوفة بالألم. إذ إن المآسي لا تُلقي بظلالها فحسب، بل تسحب معها الروح نحو حافتها، وتجُرّ خلفها سلسلة من الهواجس، والتصدعات، والانكسارات الداخلية. وكلما استيقظ وعي الشاعر، ازداد جرحه اتساعا. وهنا تتخذ الشفافية، التي يلوّح بها وسّاط، معناها الأكثر عمقًا. إنها ليست وضوحا، بل تعريا. ليست معرفة، بل كشفا موجعا يشبه ما يسميه باشلار «ارتعاش المادة الأولى للروح».
فالروح الشفافة ليست تلك التي تملك النور، بل التي انكشفت لها ظلماتها دون ساتر. ولهذا تكون الشفافية عند الشاعر ثمنا باهظا، ثمنا يدفعه في جراحات ذاته وهو يحاول الإمساك بطرف الحقيقة، كمن يحاول القبض على الماء.
الروح هنا تتعلّق بصفادها، تبحث عن تخوم توقظ حواسها من العدم، كأنها تستجيب لفكرة هايدغر بأن «الإنسان موجود نحو الانكشاف»، مهيأ دوماً لأن يُصدم بالوجود.
وفي هذا الأفق، يأتي صوت مبارك وساط، لا بوصفه شعرا، بل بوصفه ممارسة للكينونة. قصيدته ليست نصّاً، بل كيانا يتنفّس داخل هباء الزمن. إنها قصيدة منعمة بـ»رياح الثورة»، لا ثورة الشارع، بل ثورة الداخل، ثورة الأنا ضد بنيتها المطمئنة، ضد سكونها، ضد ما يخدّرها من طمأنينة زائفة. إنها يقظة تشقّ نومًا ثقيلًا، يقظة تُشبه ما يقصده دولوز حين يصف الفن بأنه «رجّة تُربك الكائن وتدفعه إلى الانفلات من واقعه الثابت».
هنا يكتب وسّاط: «جسدك شفّاف كمزاج ينبوع». هذه العبارة ليست وصفًا، بل عملية شقٍّ لمعنى الجسد. الجسد لا يعود مادّة، بل يتحول إلى مزاج، إلى تدفق، إلى ماء يلمع في الظلال. كأن الجسد يُعاد صياغته ليتحرّر من صلابته، ويصبح كائنًا سحريًا، يتكوّن من شفافية الفكرة، لا من كثافة اللحم.
ثم يضيف: «عظام من نحاس تنذر بوميض صباحات باردة على الفم». إن النحاس هنا ليس معدنًا، بل صوت الوجع حين يتحوّل إلى مادة. كأن الشاعر يعيد كتابة الجسد كأثر سمعي، كجرسٍ تنبعث منه الإشارات الأولى لصباحٍ بارد، صباح لا يمنح الدفء، بل يهدّد بانطفاء الصوت.
ثم تأتي الريح: «الريح الغريبة تنشر هوسها على الخطى، تحقن دمها في أسى الزمن العاتي.» هذه الريح ليست حدثاً طبيعياً، بل علامة فوكوية، قوة تتسلل كالخطاب، تحتل اللغة والخطى والذاكرة. إنها ريح تحمل معها «عنصر الاختراق»، ذلك الذي يجعل الزمن يتلوّى، ويجعل الخطى هشّة، غريبة، لا تعرف إلى أين تسير، ولا لأي قدر تنقاد.
ثم، في مواجهة هذا الارتفاع القاسي للذات في جرحها، يستدعي الشاعر «الخدينات». إنهنّ لا يظهرن ككائنات حسية، بل كأصداء لجمال بعيد، جمال خرج من الزمن وأقام على نمارق المحيط. إن حضورهنّ يفكّر بالذاكرة، لا بالجسد. وبالحنين، لا بالحضور. كأن الشاعر، في لحظة الانكسار، يستدعي الأنوثة بوصفها ملاكًا للعزاء، أو بوصفها «الهواء الأول» للوجود.
ثم ينهض «المجنون» كشاهد على عالم محطّم، تذكّر كيف صادر «الدهاة» صيحاته، وكيف احتجزوا أجمل ما نطق به، وكيف حشدوا صوره من كل المرايا التي مرّ بها، وكيف حمّلوه شهاباً ليعود به إلى مسقط رأسه.
إنه ليس مجنوناً في المعنى العيادي، بل هو كائن فوكوي بامتياز، ذلك الذي تُعرّيه السلطة وتسلبه صوته، الذي يتحول إلى «جسد للهيمنة» دون أن يفقد لمعانه الداخلي. ولا يلتئم القرار، ولا يكتمل الوجود، إلا عبر ما يسميه هايدغر بـ»الشفافية الوجودية للإمكان». فالإمكان هنا ليس وعداً، بل مأساة مؤجلة. إنه نافذة تُفتح على احتمال لا يتحقق، لكنه يظل يهدّد بأن يجيء، كأن الوجود نفسه معلق على خيطٍ من ضوء.
ثم يأتي صعود الشاعر إلى «حقل الأبدية»: صعود ليس نحو الخلود، بل نحو الاختفاء في المعنى. نحو ما يسميه بلانشو «الكتابة كفعل موت». وحين يبني وسّاط هرمه من الأوابد، فهو لا يشيد أثرًا، بل يقيم حجارةً للحيرة، حجارة تُنحت من قلق المعنى.
يكتب: «أنفاس الظهيرة عوسجها كثيف». العوسج هنا هو خنق الزمن، هو لحظة التواء الظهيرة على نفسها، حين تتحول الأنفاس إلى شوك. إنه مجاز مرعب عن اشتداد الكينونة، عن لحظة الضغط القصوى، حين يصبح الهواء نفسه مادة جرح.
ثم ينحرف الطريق: بدل أن يصعد الدرج إلى بابه، يجد نفسه يعتلي جبلاً، حيث الموتى يتعجبون: «لكلّ ميث جثتان». جثّة للكائن، وأخرى لمعناه. جثّة للجسد، وأخرى للخيال الذي سكنه. كأن وسّاط يعيد طرح سؤال ريكور: هل للذات أكثر من موت؟
وتتوالى الرغبات الخافتة، تلك التي ترتجف في أعماق الكمون، كمون دولوزي، كمون لا يظهر إلا حين ينشقّ السطح ويهوي المعنى. وترتعش اللغة حين يلتقي الجسد النيء بصفائه، كما لو أن الغريزة تجد طهارتها في أقصى درجات الشفافية.
ثم يختم الشاعر أرخبيله المتشظي بلحظة تراجيدية: الرقص فوق الجثث. لا بوصفه احتفالاً، بل بوصفه رقصة الموت الأخيرة، تلك التي تتحرك على «ميزان الرمانة»، ميزان الحلم، ميزان الخيال. فالحمى تضرب العقل، والعقل يرتجف، والشفاء يتوارى خلف أوهامه. لن يأتي فجأة. سيأتي، كما يقول وسّاط، «متدرّعًا بالنصائح المرة»، متوغلاً في «كمنجات الغواية».
وفي اللحظة القصوى، اللحظة التي ينكشف فيها الوجود عارياً، يسأل الشاعر: «لكن، ما الذي أفعله الآن، وقد بدأ هيكلي العظمي يرقص بجانبي، على إيقاع القشعريرة؟»
هذا السؤال هو ذروة الفلسفة، لا ذروة الشعر. إنه سؤال الكائن حين يرى ذاته من الخارج، حين يرى عظامه تتحرك، حين ينفصل عن ذاته ليشهد رقصته الأخيرة. إنها لحظة العدم حين يُمسك بكتف الوجود ويقول له: أنا هنا.
الذاكرة والنسيان كمسارات للوعي
إنّ هذا التنقّل الموارب لرغبة الشاعر مبارك وساط، في ربط الأرخبيل بعزلة الهواء، ليس مجرّد استعارة عابرة أو جنوح لغوي يسعى إلى المفارقات، بل هو تأسيسٌ لميتافيزيقا جديدة للقصيدة، حيث تتجاور الجغرافيا مع الروح، ويُعاد صياغة المكان بوصفه امتدادا لارتجاجات الذات، لا كحيّز خامد يُقاس بالحدود والمعالم. فالأرخبيل هنا ليس مجموعة جزر تنأى عن بعضها، بل هو صورة لوفرةٍ تتشظّى، وغنى يتوزّع بين يقينٍ يتبدّد وغيابٍ يتكثّف. وما الهواء، في هذا السياق، إلا جوهر شفاف لاهوتي، لا تتحدد قيمته إلا بقدر ما يصبح قادرا على حمل المعنى، وعلى نفخ الحياة في هشاشة الكائن وهو يبحث عن سبل خلاصه.
من هذا الافتتاح تتولّد صدمة الشاعر الأولى، صدمة الضحك الذي ينساب في غير موضعه، أو لعله ضحك الوجود الذي يتلمّس من خلاله الإنسان شرخَه الداخلي. يقول وساط: «متكئًا على جدار من صبوات، قرب ربابة، تنسج كسوفات من ألياف أحلامها.»
وهذا الضحك ليس فعل انشراح، بل هو ضرب من الانخطاف الوجودي، إذ يطلّ من خلفه زمن لا تحكمه المعايير، زمنٌ يعمل على تجويف المعنى وتحويل كل يقين إلى سؤال. وهكذا يصبح الضحك هنا أداةً لخلخلة الثابت، واقتلاع الحضور من أشكاله الصلبة.
ثم ينقلنا الشاعر إلى مشهده التالي: «في عيني اليمنى، تلال تثغو، وقرب قدمي الزمن، أشقر ماكر، يعرض على السماء قمرًا مزيّفا».
فمن يكون هذا الناظر؟ إنه ذاتٌ تتهرّب من تعريفاتها، ذاتٌ لا تعيش اغترابها بل تستثمره كقوّة تأملية. وهذه الذات تجيب بأنها قادمة من أرض ليست جغرافيا، بل رمزًا للخصب، للدهشة الأولى: «أرض وهاجة، بعذابات الحجر، ترفّ عليها أجنحة بيضاء خلال أصائل بيضاء… من هنالك جئت، ولم يكن في طريقي من مفاجآت، سوى أن بضع شجيرات، من فرط الدهشة، كانت تتحوّل إلى كمنجات».
إننا هنا أمام شاعر يرى العالم بعينين لا تكتفيان بوصف العالم، بل تعيدان خلقه، فتتحول الشجيرات إلى آلات موسيقية، ويغدو الحجر كائنًا متألّقًا يرفّ من فرط الألم.
عين وساط الأليفة الثاقبة لا تحتمي بالورود إلا لتُدرِج في قلبها أشواك الدهشة. فهي عينٌ مترعة بملح الليل، تتجرّع المرارة بوصفها علاجا، وتختبر النسيان بوصفه دربا إلى الذاكرة. إنها عين تُراوغ كما تراوغ الكائنات جراحها حين تخشى الفضيحة. وفي هذا المعنى يستدعي الشاعر صوتًا آخر في داخله: «لا تنس، ما دمنا سنرحل، أن نأخذ السكاكين الذهب؛ فثمّة في طريقنا جبل صامت، يكنز أنفاس العصافير، ويرمي المدلجين العُزّل بأعين الجرائم».
وهنا يدخل النص منطقة أكثر خطورة، إنّه جبال الماوراء، حيث لا يمكن للكائن أن يتسلّح إلا بحدّة رؤياه، وحيث يصبح المطر نفسه ملاذا للتخفّي. فالمطر عند وساط ليس ماءً فقط؛ إنه حكمة سائلة، حياة متحوّلة، قدرة على غسل الظلام وإعادة الأشياء إلى جوهرها الأول. وربما لهذا يجد الشاعر نفسه غير معتذر عن وحشته، بل يجعل من الوحشة بيتًا للمعنى، ومن الألم وقودا لسفر لا يعرف وجهته.
إنه شاعر لا يتردّد في تشبيه الخسارات بـ «طائرات من شمع ذابت في عيون موتاها». وكأنّ كلّ انطفاء يفتح في الروح نافذة، وكلّ فناء يفيض بمعنى آخر. وهو يقول بجلاء: «وما تأسّفت، فقد تعوّدت أن يتكاثف الحنين في أظافري، أن تغرق في مياه أعماقي.»
وهنا يصبح الحنين عضواً من أعضاء الجسد، ينمو مثل ظفر، يتقشّر، يتساقط، ثم يعود في هيئة أخرى. ويبلغ النص ذروته حين يكتب: «نجمع ضوء الوهم، بأهدابنا نتضامن، مع دم العصفور».
هذا التضامن مع دم العصفور ليس هروبا نحو الرثاء، بل هو إعلان عن مسؤولية الكائن تجاه هشاشته، وعن قدرة الشعر على أن يجعل من الوهم نورًا، ومن الدم نغمة، ومن الهشاشة وطنا. ورغم كل هذا الترهّل، وهذا التيه، وهذا الغياب الذي لا يلين، فإن الشاعر ينتظر يأسه الخاص ليشارك في صناعته. ينتظر التيه ليذوب فيه. ينتظر الخفوت ليعيد تشكيله. إنه شاعر يبذل أقصى ما في العتمة من ضوء، وأقصى ما في القلب من حكمة، ليُسقط عن نفسه أمانةً لا يريدها، ويمنح القصيدة أبديةً لم تكن لتحظى بها لو أنه اختار النجاة.
خاتمة:
حين نغلق هذه الرحلة في أرخبيلات مبارك وساط، ندرك أن الشعر عنده لن يكون للقارئ ملاذا للواقع فحسب، ولا متنفسا للجمال الخالص، بل ممارسة للوجود بذاته. تجربة تتقاطع فيها الصدمة بالدهشة، والانكسار بالارتقاء، واللغة بالغياب. إن نصه يذكرنا بأن الحقيقة ليست شيئا يُنال، بل ضوءاً يتفلّت كلما اقتربنا منه، وأن الوعي ليس مجرد إدراك، بل انخراطا حادا في خضم الزمن والهواء والفراغ، حيث تتقاطع الذات مع هشاشتها، والخيال مع مأساة وجودها.
القصيدة عند وساط هي صيرورة مستمرة، حركة من التفكيك والبناء، من الهدم والنحت، من الرغبة في الإمساك بالعدم وإدراك لذة التلاشي. إنها فضاء تتأرجح فيه الكينونة بين حضورها المادي وغيابها الرمزي، بين جسدها وهشاشتها، بين الصمت الذي يصرخ واللغة التي تتهاوى أمامه. تماما كما ينظر هايدغر من أن «الإنسان موجود نحو الانكشاف»، ووساط هنا يطبّق ذلك على الشعر: الكائن يختبر وجوده في كل كلمة، وفي كل صمت، وفي كل ارتجاف للنص.
إنها تجربة مضاعفة. شعور بالرحيل نحو الفضاءات المفتوحة في الوعي، وفعل مواجهة داخلي مع الموت والغياب، مع الأنا الممزقة والحنين المتأصل. وهنا تكمن عظمتها، في قدرتها على تحويل الألم إلى تأمل، والغياب إلى فعل شعري، والهواء إلى حامل للمعنى. كل مشهد، كل صورة، كل رمزية، هي محاولة لفك أسر الذات، لتجربة الحياة في أقصى حدودها، دون السقوط في وهم اليقين.
يمكن القول إن الاحتفاء بمبارك وساط ليس مجرد قراءة شعرية، بل تجربة فلسفية متجددة، دعوة للتفكّر في هشاشة الوجود، في ضوء الحقيقة وهي تتفلّت، وفي قدرة الشعر على أن يجعل من الصمت ضوءًا، ومن الظل مساحة للتأمل، ومن الموت لحظة تستدعي الحياة. إن نصه، في انكساره وانفلاته، يعلّمنا أن القصيدة ليست مجرد شكل أو عبارة، بل مصيرا للكائن الذي يجرؤ على مواجهة هشاشته، وعلى أن يكون حاضرًا في لحظة لا تُسجّل إلا في ارتجاف الروح.
ووفق كل هذه الاستدعاءات يصبح وساط صوتًا للتيه المشرق، وللغموض الذي يسكب الضوء على معتمات الوعي، صوتًا يجعل من الشعر ممارسة كينونية، ومن اللغة جسدًا ينبض في الهواء، ومن الضحك انخطافًا وجوديًا، ومن الحنين خيطًا يربط بين الأرخبيل والسماء، بين الجسد والروح، بين الصمت والمعنى، في رقصة مستمرة على حافة الأبدية.
*»محفوفا بأرخبيلات ـ راية الهواء»، مبارك وساط ـ ط2 رقمية، منشورات منارة 2025 (84 صفحة)