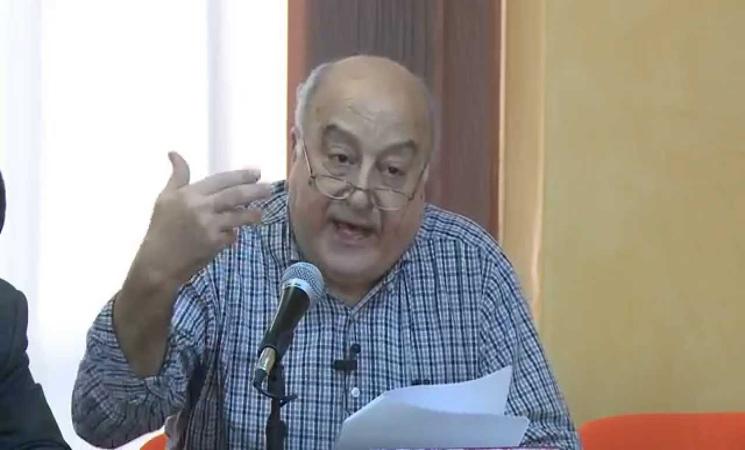سأقف، في هذه الورقة، عند مفهومين أساسين في فكر الأستاذ محمد سبيلا، هما: الحداثة والحداثة البَعدية، وذلك بالنظر لما يحتله هذان المفهومان في النسق الفكري والمعرفي الذي يبلوره الأستاذ سبيلا منذ كتاباته الأولى.
والمُلاحَظ أن الأستاذ سبيلا لا يقارب المفهومين من زاوية غائيّة، كما أنه لا ينشغل بما بات يُعرف بتأصيل المفهوم والبحث عن جذور غير موجودة. إنّ الانشغال الرئيسي للأستاذ سبيلا انشغال معرفي وإبستيمولوجي، وبالتالي لا ينظر إلى الحداثة، مثلا، باعتبارها مجرّد تاريخٍ ووقائع فقط. لذلك فإنه لا يعتبر الحداثة حقيقة مطلقة وبنية مكتملة، مثلما لا يعتبر ما بعد الحداثة ّهدما» للحداثة وردّة عليها وعلى مقوّماتها، كما يقول آخرون.
في كتاب الحداثة وما بعد الحداثة، يوضّح الأستاذ سبيلا الفرق النظري\الإبستيمولوجي والتاريخي بين «الحداثة» و»التحديث»: الحداثة تتخذ طابع بنية فكرية جامعة شاملة، في حين يتدثر مفهوم التحديث بمدلول جدلي تاريخي. وبالتالي، فالحداثة تظل فكرة نظرية تتمظهر في شكل تحديثٍ يتفاعل مع واقع يتعدد ويتنوّع.
التحديثُ لا يمرّ عبر القطيعة ولا عبْر استنباتِ مفاهيمِ الحداثة داخل التراث. ذلك أنّ آليات الحداثة والتحديث، هي في نظر أستاذنا، آليات مركَّبَة، إنها في الآن ذاته قطيعة واستمرارية، قطيعة مع التصوّرات العتيقة المرتبطة بصورة العالم في الوعي والثقافة التقليديين؛ لكنها كذلك استمرارٌ وتطوير ووصل مع بعض عناصر الحياة في التقاليد والتراث. كما ترتبط هذه الفرادة والأصالة التي تطبع موقف الأستاذ سبيلا من إشكالية التقليد والتحديث بخصوصية منهجه غير الأحادي وغير الدوغمائي في مقاربة الإشكالية، هو منهج متحرّر من النزعة المركزية للفكر الغربي وللثقافة الإسلامية، يمارس عليها نقداً مزدوجًا ويتجاوز مجرّد التفسير إلى مستوى الفهم والتأويل. وهذا يعني أنه بدلا من أن ينظر إلى مسألة الحداثة، والأصولية الدينية، من منظور خارجي براني، ينظر إليها من منظور مقاصد الفاعل الواعية واللاواعية، و يسعى إلى تفهّم أسباب وظروف ومناخ نشأتها وبنية فكرها.
هل كانت الحداثة مكانًا ورهانا لصراعات وتحوّلات أساسية مختلفة طبعت عالمنا المعاصر؟ كلمة محملة بدلالات واستراتيجيات: يمتزج فيها التاريخي بالمجتمعي والتقني بالفني والأدبي، والتحديث التقني والصناعي، والتحولات المجتمعية والقيمية الخ. لكنْ، رغم الموضة التي ترغب في جعل الحداثة مفهومًا متجاوزًا، عفا عنه الزّمَن، فإنّ المشاكل التي يطرحها هذا المفهوم تظلّ قائمة، في مجتمعنا على الأقلّ. فلا زالت مجتمعاتنا التقليدية تفتقر إلى العقلانيّة والتقدم من خلال العلم والتكنولوجيا، ونبذ الفكر التقليدي والتفسير العلمي للتاريخ، الخ.
إن التعدد الدلالي الداخلي الذي ينطوي عليه المفهوم، والتشويش الذي تعرّض له، هما المنطلق الذي أسس عليه الأستاذ محمد سبيلا مقارباته الغنية والمضيئة.
إنّ الحداثة براديغم كلّي متعدّد الاتجاهات والمستويات، هي بنية عامّة عملت على خلق تحوّل جذريّ في التاريخ والمجتمع والأفكار والآداب والفنون. وهذه البنية عندما تلامس بنية اجتماعية تقليدية فإنـها تصدمها وتكتسحها بالتدريج ممارسة عليها ضربا من التفكيك ورفع القدسية.
غير أنّ هذا البراديغم لا يشتغل من تلقاء ذاته، بل إنّ له آليةً امبريالية (بالمعنى البنيوي للكلمة) في التوسّع بكل الأشكال والوسائل: بالإغراء والإغواء عبر النماذج، والموضة والإعلام، أو «عبر الانتقال المباشر من خلال التوسع الاقتصادي أو الاحتلال الاستعماري أو الغزو الإعلامي بمختلـف أشكـاله إلى غير ذلك من القنوات والوسائل». لذلك تشعرُ المجتمعات ذاتُ البنيات التقليدية بما أسْماه أدونيس «صدمة الحداثة».
غير أنّ الأمر مع تحليلات الأستاذ سبيلا يتجاوز مجرّد الصدمة إلى ما تولّده الحداثة من تمزّقات بلْ وتشوهات ذهنية ومعرفية وسلوكية ومؤسّساتية كبيرة، وبالتالي تخلق حالة فصام وجداني ومعرفي ووجودي معمم. وذلك بسبب اختلاف وصلابة المنظومتين معا. فللتقليد صلابتُه، وأساليبُه في المقاومة والصّمود أمام الانتشار الكاسح للحداثة، وطرائقه في التكيف معها ومحاولة احتوائها؛ كما أن للحداثة قدراتـِها الخاصة على اكتساح وتفكيك المنظومات التقليدية، وأساليبها في ترويض التقليد، ومحاولة احتوائه أو استدماجه أو إفراغه من محتواه. فالصراع بين المنظومتين صراع معقد وشرس بل قاتل.
وقد سبـق للأستاذ سبيلا أن تحدث عن العلاقة الاستعارية بين التقليد والحداثة. فكثيرا ما يتلبس التقليد لبوسَ الحداثة ليتمكن من التكيف والاستمرار، بينمـا تتلبس الحداثة بالتقليد أحيانا لتتمكن من أن تنفذ وتفرض نفسها. وهذا التزاوج نشهده في كافة مستويات النسيج الاجتماعي، نشهده في التلاقح بين منظومتي القيم، وفي المستوى الإدراكي، والسلوك الفردي، في المعرفة، في الاقتصاد وفي السياسة. ففي المجال السياسي مثلا يحصل تمازج بين مصدرين للشرعية السياسية: الشرعية التقليدية المستمدة من الماضي، والتراث والأجداد، وشرعية المؤسسة العصرية القائمة على أن الشعب هـو مصدر السلط. وهذا التمازج والاختلاط يطال الخطاب السياسي والإيديولوجي، والسلوكات السياسية، ويطبع المؤسسات السياسية، والثقافـة السياسية برمتها. وهو على الرغم من كل مظاهر التعايـش تمازج صراعي في عمقه».
وباختصار، لقد أسّست الحداثة لانتقالات في غاية الأهمية: انتقالات إلى سلطة العقل والنقد والاستدلال العقلي والبرهان التجريبي والنزعة الموضوعية، أو «الموضوعانيّة»، كما يقول الأستاذ سبيلا، وفكرة التقدم وسلطة القانون والعلم والآلة الخ.
الحداثة البَعدية،
ما بعد الحداثة
إن هذه ال «ما بعد» لا توحي بالانقطاع أو الانتقال الزّمني. ومن ثمّ، فإنّ ما بعد الحداثة لم تلغِ هذه المشاكل المحايثة للحداثة، بقدر ما عملت على حجبها وتعميق التشويش بشأنها أحيانا، وعلى إعادة مقاربتها نقديًّا وتوسيع مكوّناتهان بعيدا عن أيّن نزعة انفصالية راديكالية. وبالتالي فإنّ ما بعد الحداثة هي مناسبة لتقديم حصيلة مزدوجة: حصيلة الحداثات المتحقِّقة في الفكر والمجتمع، وحصيلة ما بعد الحداثة التي هي دائما وما تزالُ قيْد التشكّل. يتمّ ذلك، بطبعية الحال، عبر محاورة النّقّاد الذين يقدّمون الحداثة باعتبارها شيئا صعبا\مزعجا، وباعتبارها داءً مجتمعيا، وبالتالي فهي منذورة للفشل والانتهاء، والتركيز بالتالي على انتقاد الحداثة باعتبارها إفراطًا غير متوازنٍ قائمٍ أساسًا على العقل والإنسان، وتأكيدها على التاريخ باعتباره حتمية، ورفضها للمتخيل والأسطوري ولما هو رمزي، الخ.
لذلك يبيّن الأستاذ سبيلا أنّ مفهوم ما بعد الحداثة (الحداثة البَعدية) مفهوم مضلِّل لكوْنه يوحي بالتجاوز والنهاية. فهي تمثل بالنسبة له «مجموع الانتقادات التي وُجّهت إلى الحداثة كبنية فكرية وكنظام فكري مغلق. فتيار الحداثة البعدية ينتقد البنيةَ الفكرية المغلقة للحداثة وارتكازَها على العقل وتمجيدَها المطلق للإنسان وتصنيفَها للتاريخ وللحتمية التاريخية وإنكارَها للمتخيل والرمزي. فتيار الحداثة البَعدية يمثل نقداً لأساطير الحداثة (الأساطير هنا بالمعنى الإيجابي) المتمثلة في العقلانية والتقدم والتطور وفاعلية الإنسان وغير ذلك من أقانيم الحداثة. من هذا المنظور، إذن، فإنّ تيارات الحداثة البَعديّة هي استمرار لمنطق الحداثة وتعميقٌ لمنظورها» (دفاعا عن العقل والحداثة، ص. 63).
ومن ثمّ، إذن، فإنّ الحداثة البعدية، استمرار للحداثة نفسها باعتبارها مشروعا لمْ يكتمل، على حدّ تعبير هابرماس. إنّ المنطق المحرّك، هنا وهناك، هو ما يذهب إليه الأستاذ سبيلا معتبرا أنّ الحداثة اليوم قد وصلت إلى أعلى مستويات القوّة، مستندة إلى فكرة النقد المستمرّ، بوصف النّقد مبدأً اساسيا في عمل ودينامية الحداثة.
ربّما هذه إحدى مميزات الفكر الغربي المعاصر الذي «يعيد النّظر بشكل متواصل في أكبر مسلماته وفي أكبر انتصاراته، بما في ذلك التي حققها بتضحيات هائلة». وإعادة النظر هنا تعني إعادة قراءة الأسس والمبادئ التي قام عليها الفكر الغربي، أي إعادة قراءة مكتسبات الحداثة أو التنوير.
الحداثة البَعدية إذن تعني نقد الحداثة أي «نقد النقد». مع ما بعد الحداثة ما «من شيء إلا ويمكن نقده حتى النقد ذاته في نقد النقد، حتى الحداثة نفسها، وهي أعز ما أنتج الغرب، أصبحت موضوعاً للنقد في نقد الحداثة لصالح ما بعد الحداثة. وما بعد الحداثة نفسها يمكن نقدها لصالح التفكيك الشامل والقضاء على منطق العقل لصالح وداعاً أيها العقل». فمع هذا التيار الفكري «أعطيت الأولوية للمتغيرات دون الثوابت. بل لم تعد هناك ثوابت على الإطلاق إلا التغير نفسه. لم تعد هناك بؤرة واحدة أو منظور واحد…. ثم انتهى الأمر من كثرة التغيرات والتعديلات إلى النسبية والشكية واللاأدرية والعدمية. إذ لا يوجد شيء يمكن معرفته بيقين». ومن معاني مصطلح ما بعد الحداثة إلى جانب المعاني السابقة التي ذكرناها هو «رفض الأساس» أي رفض الميتافيزيقا، ففكرة الأساس «ذاتها هي جوهر الميتافيزيقا، والمطلوب الآن هو الارتباط بالصيرورة ورفض الأساس، والتطهر تماماً من أي أثر للميتافيزيقا».
في مختلف مقارباته لهذين المفهومين، يؤكد سبيلا على أنّ المشاكل هي ذات طبيعة إبستيمولوجية وإستتيقية وإثيقيّة وسياسية واقتصادية متداخلة. مشاكل جيو-بويطيقية وجيو-سياسية، على حد تعبير هنري ميشونيك، بعولمتها وخصوصياتها.
ففي كتاب الحداثة وما بعد الحداثة، المشار إليه سابقا، (ص. 99) يوضّح أنّ «مصطلح «ما بعد الحداثة» مصطلح مطليّ بالصابون، فهو منزلِق الدلالة ويشي بالخداع. ما بعد الحداثة يوحي بأن الغرب المتقدم قد قطع مع الحداثة، و تركها وهو الآن في مرحلة ما بعد الحداثة». ويرى أن اللغة العربية تسعفنا في التمييز بين ما بعد الحداثة والحداثة البعدية، وهذه الأخيرة ليست إلا الحداثة في مرحلتها الثانية أو اللاحقة، لأنها وسّعت مكتسباتها وإنجازاتها ورسختها، وسعت مفهومها للعقل ليشمل اللاعقل، ووسعت مفهومها عن القدرات الإنسانية لتشمل المتخيل والوهم والعقيدة والأسطورة وهي الملكات التي كانت الحداثة الظافرة المزهوة بذاتها وبعقلانيتها الصارمة، قد استبعدتها. وبالتالي، فالحداثة البعدية هي حداثة أعمق وأرسخ قدماً لأنها أصبحت أكثر مرونة، وأكثر قدرة على احتواء نقائضها، وفي ذلك تجاوب عميق مع ماهية الحداثة نفسها كتجاوز مستمر.
لقد أصبحت الأولوية في ثقافة الحداثة البعدية للغياب واللامعنى واللادقّة. إنها نوعٌ من تجاوز المركزية الغربية والمركزية اللغوية والثقافية. وذلك بإضافة عناصر أخرى ومكونات ثقافية أخرى غالبا ما تمّ تهميشها باسم العقلانية أو باعتبارها «لا ثقافة»، عناصر مثل الأبعاد الروحية والرمزية والأساطيرية والمتخيلات الجماعيّة. من هنا يدعونا الأستاذ سبيلا، في كتابه دفاعا عن العقل والحداثة (ص، ص. 95، 98) إلى فهم محاولات هيدغر ومدرسة فرانكفورت ونقد ديريدا للميتافيزيقا الغربية ولمبدأ الهويّة.
بهذا المعنى، فإنّ معرفة الحداثة البعدية هي معرفة لا تومن بالحدود، مهما كانت طبيعتها. هي معرفة تروم المجهول في المعرفة، وخلق معرفة أخرى تنافذيّة interpénétrable بين مختلف العلوم واللغات والهوامش والمحكيات. إنها ترسيخ لثقافة الاختلاف والنسبية والتشظّي. الحداثة البعدية ليست هدما للحداثة ولمكوناتها، على فرض أنّ الأمر يتعلق ببناء، كما أنها ليست لعبة لغوية أو أدبية، بقدر ما هي موقف واعٍ يسعى إلى تقويض أو تفكيك نمط معيّن من إرادة الخطاب التي أسّست عليها المركزية الغربية كل سلطاتها على بقيّة البشرية وسمّتها الحداثة. الحداثة البعدية هي موقف من سلطة المعرفة.
لذلك يخلُصُ الأستاذ سبيلا إلى أنّ الحداثة البعدية هي حداثة من درجة ثانية بالمعنى الجبري لا بالمعنى الحسابي، حداثة تحاول أنْ تستبدل العقل الأداتي المسيطر بعقل مطاط ولزج، وأن ترشّ القانون بالأخلاق، وأخلاق المسؤولية بأخلاق الضمير، والمجتمع الميكانيكي بمجتمع عضوي، والعقل بالحدس، والعلم بالأسطورة، والحقيقة بالجمال، الخ.
بعبارة أخرى فإن شق الحداثة البعدية ضمن الحداثة هو محاولة لإعادة التوازن الداخلي في الحداثة بعد أن طغى، بشكل مجحف، الطرف الأوّل المادي الآلي العقلاني الأداتي، على الطرف الثاني الغائي الإنساني الأخلاقي و الجواني .
وبقدْر ما كانت الحداثة (ولا زالتْ) في عمقها توترا وهدما وتجاوزًا لا ينقطع للبنيات التقليدية الراسخة ولبنياتها هي كذلك، بقدر ما وسّعت الحداثة البعدية نطاق هذا الهدم اللانهائي.
إنّ الرّهان الفكري للأستاذ سبيلا هو تعقّل الحاضر من أجل المستقبل، وبالتالي يبقي على الأسئلة مفتوحة، متوازنة، وذات بُعد نقديّ مزدوج موجه للذات وللآخر بكيفية جدلية وحوارية.