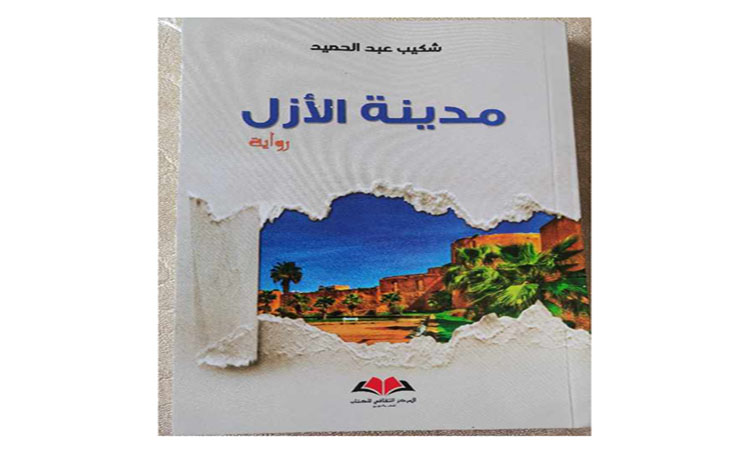بين جنس سير ذاتي بخبرة حكواتي، وبين رغبة في تجنيس المكتوب بالعمل الروائي، انطلق شكيب عبد الحميد في روايته «مدينة الأزل» من نقطة السفر إلى موگادور الحالمة، مؤسسا سفره على عشق قائم على صور ولقطات عن مدينة البحر والأحلام والرياح، حيث كان دخوله إليها دخول عاشق وقف على أسرار جاذبية الصويرة وإغراءاتها الغامضة، هو القادم من مدينة الجديدة أو مازاگان بتسميتها القديمة، لذلك لن يستغرب القارئ هذا العشق غير المشروط لمدينة أسطورية احتفت بها مقدمة الرواية ونهايتها، وجعلتها نقطة انطلاق واختتام لعوالم تحتاج لعين عاشقة مدربة على مطاردة أسرار غواية البحر وسقالته ومرساه في الليل كما في النهار.
وما بين الحديث عن حب موگادور وإبراز أسباب ودواعي الزيارة المتمثلة في المساهمة بأمسية أدبية خاصة بكتاب «ولدت غدا» للكاتب مراد الخطيبي احتفاء بعمه عبد الكبير الخطيبي، لا ينسى الكاتب التنبيه بنوع من التحدي المتعمد إلى اختيار فني ارتضاه تجنيسا لروايته، في الصفحة 19، نقرأ له: «كل شيء ممكن، فما نحن سوى صفحات فارغة لنملأ السواد ونبحر بعيدا في أنفسنا وذواتنا، أواصل تأملاتي وأسئلتي بصمت: الذات هي المبدأ والمنتهى، وما هو خارجها سراب، هل أنا فعلا أعيش اللحظات، أم مجرد سرنمة تقودني إلى الوهم؟ هل ضروري أن أتعلم السباحة كي أسبح؟ أم أقتفي أثر الولي مولاي بوعزة وأطوي البحر طيا؟»
وفي الصفحات الموالية، يستمر التأكيد والإلحاح على أن الكتابة خاصة في صنفها الروائي هي مجرد سيرة ذاتية يستأنس بها الكاتب في محاولة لنسيان همومه، حتى حين يتوهم الكاتب إبداع رواية عن الآخرين فهو يظل دائما سجين سيرة ذاتية تزينها توابل التخييل، في الصفحة 21: «يخجل كثيرون من السيرة أراها أنا الكاتب لا من خارجها، الروايات ذاتها التي تحسب أن الكاتب أبدع فيها من خياله ماهي إلا سيرة مدسوسة، وما الحياة الواقعية إلا سيرة الآخرين اقتنصها قلم بارع فغدت حيوات من نسج الخيال.»
وعليه.. كانت العودة إلى أزمور، وتفاصيل دار هي مسقط رأس الراوي، ومأوى طفولته الموزعة بين دار الوالد وبين دار عمه في قلعة الجديدة، في وصف إثنوغرافي لحياة مدينة سيدي وعدود ونهر أم الربيع، دون تجاهل الحديث عن بعض أناسها الطيبين ونهاياتهم المحزنة بسبب الإدمان وتبعات شرب الخمر وتدخين الحشيش، أسماء مثل بولعوان وكوكو، ظلت راسخة في الذاكرة بسبب تميزها في ريعان الشباب وضياعها فيما تبع ذلك، ومع انسيابية التذكر الحر يعرج للحديث عن زياراته المتكررة للقاص والروائي المتميز محمد زفزاف في خلوته الفوضوية بمعاريف الدار البيضاء.
وقبل هذا وذاك، لابد من الإشارة إلى أن شكيب عبد الحميد قد قسم الرواية على ثماني عشرة فقرة، واضعا لكل فقرة عنوانا كدليل يحدد جغرافيا المقروء، ومرشد يفصح عن طبيعة المضمون ومجالات تحركات الأبطال والشخصيات.
من الزمن الجميل، ذكريات الشباب وشغب التلاميذ، أسماء أساتذة وأستاذات كلهم أجانب من جنسيات فرنسية وبولونية وبلغارية وغيرها من انتماءات نساء ورجال تعليم جلبهم المغرب من وراء المحيطات لتلقين جيل ما بعد الاستقلال مواد الفرنسية والرياضيات والفيزياء، ذاكرة حية قوية احتفظت بوظائف الأساتذة وأوصاف الأستاذات واختلاف الملامح والأمزجة عند سادة التعليم التى تبقى موشومة في ذاكرة تلاميذ يميلون أكثر إلى تذكر وتخيل ما كان يشعل استيهاماتهم المراهقة.
ذاك كان الماضي، وحاضر كتابة السيرة تقاطع مع رغبة سميحة بن سيمون اليهودية بنت أزمور في كتابة سيرة طفولتنا وشبابها بمدينة بوشعيب السارية وهجرة عائلتها إلى إسرائيل، ثم انتقالها إلى فرنسا هروبا من شقاء العيش داخل كيان صهيوني قاس يمارس عنصريته تجاه السكان الفلسطينيين الأصليين ويهود الدول العربية.
وفي ما يشبه الرغبة في الحفاظ على تفاصيل منقوشة على صخرة الحياة، واستحضار أثر عزيزٍ يسترجع لحظات تجمع الوالد الفقيه بأبنائه، وبعدها ينهمر التذكر كسَيْلٍ جارف يمتح من الأسلوب الشعري واستعاراته وعمقه، كأوجاع سيزيفية تمهد للانتقال إلى مرحلة ما بعد الدراسة، حيث وحش البطالة وقلة ذات اليد يستقبل غير المحظوظين، ويواصل التهامهم باعتبارها فرائس تعاني من انعدام الشغل، وتقترب من الجنون لولا صدفة النجاة من مصير المنبوذين الساقطين في هاوية الإدمان والتلاشي.
ولأن الحنين جارف، كان لابد من العودة لماضي أزمور كأقدم تجمع حضري مديني في تاريخ المغرب، مدينة هادئة جميلة انتشى عاطلوها بشرب الخمر على ضفتي نهرها الخرافي، وتنقلوا بين نشوة الغياب وطلب الحضور والوعي بواسطة تنظيم لقاءات ثقافية تكسر جمود حاضرة احتلها البدو وهجم عليها الفارون من قساوة جفاف الأرض والأرحام.
ولا يخفى على القارئ اللبيب، أن السيرة في ردائها الروائي لا تلزم كرونولوجيا الأحداث كما وقعت بتعاقبها في الزمن «الواقعي»، بل تختار محطات محددة وأماكن لها حضور قوي في وجدان الطفل الذي كان، الحفرة مكان الولادة والحبو والبدايات، القلعة والانتقال عند الأب الثاني والعمة اللذين تبنيانه ومنحاه العناية والحب والتربية، والصويرة حيث العودة والمشاركة في ملتقى وطني للقصة القصيرة ولقاء الصديقة الصويرية الفايسبوكية والدردشة حول الكتاب والكتاب.
وكلما كبر الحنين، فتشت الأصابع في صور الماضي البعيد لتأمل الملامح والأحوال وما يقترن بهما من أحداث راسخة في البال.. يحضر عبد الحي الأب البيولوجي الفقيه في «الحفرة» بأزمور، وتحضر أكثر العمة السعدية العاقر و»الأب دحمان» الأب بالتبني القاطن ب»القلعة» بالجديدة والمنحدر من سلالة القائد المقتول أواخر القرن التاسع عشر بقبيلة أولاد بوعزيز الدكالية وزوجته ياقوت العراقية الأصل التي كانت في ملكية قائد سلاوي اشتراها ممن سبوها زمن السرقة واستعباد البشر.
والواضح أن» الأب دحمان» بمحكياته المتمحورة حول عائلته وتجربته في الجندية والحرب العالمية، وإيمانه بالتفتح على مستحدثات الغرب كالسينما والراديو مثلا قد ساهم في فتح عين صاحب السيرة على عوالم لها ارتباط بغدر الأقارب ووقت الحرب وقساوة هتلر وقدم بتنشئته وتربيته على النمط الفرنسي أساس وعيه بالمحيط وكيفية التعامل مع العالم الآخرين.
وبسلطة الروائي المتمرد على احترام متواليات السيرة الذاتية، يتذكر أنه ملزم بمساعدة سميحة بن سيمون الصحفية على كتابة سيرتها الذاتية والبحث عمن عايشوا أسرتها وبقية الأسر اليهودية التي عاشت في أزمور، واستحضار علاقات الجيرة والود بين المسلمين والمسيحيين واليهود قبل رحيلهم إلى إسرائيل القائمة فوق تراب فلسطين المحتلة.. وللأسف صعب على السارد وصديقه المختار العثور على من يمدهم بمعرفة عن الأسر اليهودية الزمورية، واكتفى بزيارة محراب الفنان التشكيلي العالمي عبد الكريم الأزهر، ووصف بيته المدهش بتنوع معروضات فنية تملأ أرجاءه وتجعله متحفا راقيا تفوح منه رائحة تقديس التشكيل وعشق الشعر.
ومبرر هذا الاحتفاء الفاضح بالسيرة وليس الرواية هو اقتناع الكاتب بعد تجاوز سن الخمسين بضرورة توثيق يوميات سابقة، وتفاصيل ترسبت في قعر ذهنه المؤمن بقرب الشيخوخة وبالتالي الاقتراب من الموت كنهاية حتمية ينتصر عليها بوشم كلمات تتجاوز عوادي الزمن، وتصمد كي يتوهم السارد خلوده ولو عن طريق المكتوب، وما عدا ذلك فالكل إلى زوال، نقرأ في الصفحة 123:
«تستطيع أن تعبث بأوراق الماضي وأنت في أحضان الفراغ، لاشيء يستحق الانتباه، ووحدها عقارب الوقت تزحف نحوك، قد تفزعك أحيانا، صفحات حياتنا متناثرة كأوراق الشجر حينما تسقط ورقة تعد فصلا انتهى من حياتك. الحياة فصول، والعمر كتاب، والسيرة مراجعة لحياة مجهولة لم تنتهي فصولها بعد، لا أكثر.»
وأنا ألتهم أوراق «مدينة الأزل»، ظل السؤال الفضولي المُحيِّر ينغص عليّ أحيانا متعة القراءة والتلقي، ما الدافع وراء تصنيف شكيب عبد الحميد لكتابه بالرواية رغم تأكيده غير ما مرة إلى أن الكتابة في عموميتها لا تعدو أن تكون سيرة؟! لماذا الإصرار على إلصاق تهمة السيرة بمكتوب يتمرد على الاكتفاء بما هو ذاتي محض؟!!
معلوم أن السيرة الذاتية كجنس أدبي لها ملامح وأوصاف وتقنيات يتفق حولها عشيرة النقاد وجزارو سرير بروست ومشرحته الدموية الحقيرة، لا شيء ينفلت عن عقال الأنا والذات، قد يكتبها مهتم محايد أصابه داء البحث عن معلومات شخص ما، أو تكون شهادات واعترافات عن مسارات حياة يخطها صاحبها وفق تراتبيتها الواقعية في المعيش اليومي، من الولادة إلى الطفولة والدراسة والشباب والكهولة إلى شيخوخة العمر الطويل.
ولكن.. منذ ثمانينيات القرن الماضي، أزعم أني أعرف جيدا الكاتب شكيب عبد الحميد واهتماماته الأدبية والحياتية، وازداد يقيني بما أعرفه عنه بعد قراءة «مدينة الأزل»، لنقل أن التواطؤ بيننا قد ساهم في استقبال عمله بنوع من الحب والرغبة في الغوص عما يجعلنا قريبين من بعضنا البعض أكثر. لم أراهن على المتعة، لأنها مضمونة، ولم أشك في غيابها عن النص، لكن الخلط المتعمد بين السير ذاتي والروائي لدي استمر غصة تحتل حلق التلقي بين الفينة والأخرى، وفي الأخير اقتنعت وقلت، إنها رواية جميلة ممتعة يا صاح، له هو حرية الاختيار ولنا نحن سلطة التصنيف والتجنيس ضد أنفه وقلمه الشيق.
لتحقيق رغبة الكاتب في العودة إلى جذوره الأزمورية، انزاحت الرواية السير ذاتية إلى رصد حنينه لأماكن وشمت حضورها في الذاكرة، وصار النص حفرا في هويات مدن شاطئية هي توائم اشتركت في ارتباطها الجغرافي بالبحر والنهر وبالتاريخ ومعالم سكنتها الخرافة واقترنت في أذهان عشاقها بالحب والحلم وبساطة العيش، هكذا نستعيد مع الكاتب طبيعة الجديدة وأزمور والصويرة ومعهن نقبض على بعض أسرار جمالهن وجاذبيتهن، لذلك نسمح لأنفسنا بوصم الكتاب بأنه إبداع ممتع احتفى بحواضر بهية وأعاد الاعتبار روائيا لجديدة الحب وأزمور أم الربيع وسقالة الصويرة كمدن فاتنة هي أهل للحب والعشق والتعلق الوجداني الصوفي.
وقد تقاطعت نية الكاتب في العودة للأصل مع رغبة صديقته الفايسبوكية سميحة بن سيمون الصحفية العاملة في جريدة «لوموند»، والتي ظلت تحتفظ بحب جارف لمسقط رأسها أزمور ومدينة أعمامها الجديدة، ويتجلى ذلك في الأوراق الأولى من سيرتها الذاتية خاصة فترات ولادتها وطفولتها ومراهقتها وتفاصيل كثيرة تخص المدينة القديمة والملاح، وتعايش المسلمين واليهود في رقعة واحدة قبل الهجرة لأرض الوهم وليس الميعاد، وأوشام السنوات الاثنتي وعشرين مشكلة من ملامح الأب اليهودي العطار العاشق للصيد بالقصبة في أم الربيع ،وقصة حبه المثالية وزواجه حسب الشريعة والأعراف اليهودية، واستعراض دقائق الدراسة الموزعة بين أزمور ومراكش والرباط وباريز، دون نسيان الحب الأول لحماد الأمازيغي القاطن بالصويرة والقادم من حاحا واستحالة إنهاء هذا الحب الممنوع بين يهودية ومسلم، لنجد أنفسنا أمام وثيقة ثمينة عن يهود مغاربة عاشوا وسطنا وهاجروا، وظلوا مشدودين لكل ما هو دكالي مغربي أصيل وما هو صويري رومانسي حالم.
ختاما، يقول المفتي المجنون: «من لم يعش الحب في الجديدة والصويرة لا يحق له الحديث عن زلازل العشق وبراكين الاشتياق، هناك.. توأمان جعلا الحلم والحب والبحر خرافة واقع لها شهداء وشهود!»
هامش: مدينة الأزل (190 صفحة) ــ شكيب عبد الحميد ــ المركز الثقافي للكتاب ــ الطبعة الأولى (2024)