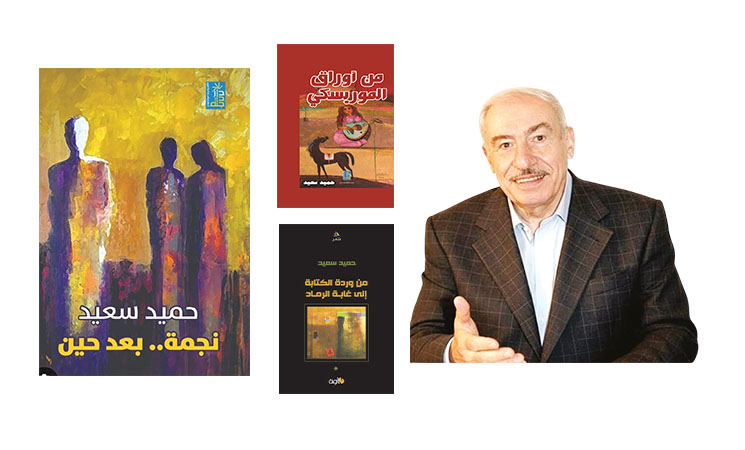تُكَلِّلُ أختُنا الشاعرة القديرة أمينة المريني مشمولها الشعري الباذخ «مكاشفات» بما يفتح الشهية للقارئ كي يتأمل لوحاته، ويصغي إلى نبراته الرحيمة الصاعدة من نار الفرح، وجنة الشجن، في عبارة النفري : «انظر بعين قلبك إلى قلبك، وانظر بقلبك كله إلي».
وعندما يسامرها القارئ تحت أشعة قمر معلق من جهة الوفاء لروح الشعر والصدق الإنساني في أرقى مدارجه وأجمل أبعاده مسامرة الساري للنجوم والمطالع والإشارات على الطريق المؤدية إلى ينابيع الماء، يكتشف أن هذه المكاشفات أغنى وأعلى من الإكليل نفسه.
في مواقفه، يأخذنا النفري، في استباحته لدم الواقع، إلى التأمل والنظر باختزاله لكل ما يعتمل في العالم من تناقضات وجزئيات ومكابدات، في صور كلية شبيهة بالبرقيات، ممهورة بخواتم التجريد، كأنه يقول لنا: فسروني ! هنا، استئذان، بمهارة صياغة العام، إلى أن نحيا الجزء في الكل، كأن النفري يقودنا تحت قوس الرؤيا إلى اكتشاف عوالم أخرى على درب العوسج أو الحرير.
وفي مكاشفاتها، تأخذنا أمينة المريني؛ إلى أن نحيا الحياة، بكل ألوانها وأفراحها، موقفا موقفا، حالة حالة، سهرا سهرا… تحكي عن النار من قلب النار، وعن إصرارها وعنادها، ولكنها تحكي كذلك عن الرماد، في الحضور وفي الغياب، وعندما تتربع، هي نفسها، على سدة البوح، لا تحكي عن أعراضها وأغراضها وطقوسها، حصرا للخارجي فقط، ولكنها تحكي عن ذاتها وامتدادها في الزمن، توسيعا للأفق الروحي، كأنها تقول لنا: شاهدوني! هنا، استئذان، بمهارة صياغة الخاص جوهرا وعرضا، إلى أن نحيا الكل في الجزء، كأن أمينة المريني تصعد بنا من دهاليز فاس السرية ودروبها الضيقة وأحيائها القديمة بنجاريها وعطاريها وسماريها وصفاريها ونحاسيها وصباغيها ونقاشيها… إلى أعلى؛ كي نطل على العالم الفسيح من تحت قوس باب الخوخة.
وفي بوح آسر، ولغة مقدودة من رق الرؤيا، تفتننا الشاعرة بقصائدها المكشوفة كأنها مقطوعة من الكبد، لأنها لم تختر أن تصوغها بنفسها، ولكن، لأن القصائد الحاكمة بأمر القلب اختارتها هي نفسها للنيابة: كيانا للاقتطار والاختمار والمكابدة، وخيالا للتجميع والتنضيد والتركيز والبلورة وصيد الأوابد والشوارد، وذاكرة متوقدة تستند إلى جدارها لتمدها بما يلزم من أدوات ورخص لتلحيم عناصر الجملة الشعرية بالحكي والتشبيه والمقارنة، ومنطقة عليا لضخ الموسيقى في صلصال العبارة، وعقلا يقظا لتوليف العناصر كلها ومزجها وطبخها على نار هادئة مع إضافة توابل فنية مضادة لعسر الهضم، ونقص الشهية.
العالم، الزمان، المكان، السماء، الكواكب، البحار، الجبال، الأرض، التاريخ، المجتمع، الواقع… كلها كائنات كونية فيزيقية مادية طبيعية موضوعية تريد أن تمارس فعل الحياة والحب والغضب والثورة والقوة والنمو والاستمرار والامتداد، فتختار الشاعر الأمين كي تضع أسرارها في قلبه ووجدانه وتقول له: دوّن هذا الذي أحيا الذي تحيا، أنا التي أملي على رهافتك إيقاعاتك، وأسوي أوتار العود في يديك لتعزفني، لست سوى ممثل لإرادتي وطقوسي وأنفاسي وأنغامي وشموسي وظلالي.
ولأن العناد، المشاكسة، التحدي، المغامرة، المواجهة، المغالبة، بصم الذات على لوحات للرؤية؛ ليست للبيع، البوح، الإرادة، فلتات الخيال العميقة الرقيقة الدقيقة… هي ملكات فطرية أكبر من أن ترى بالمجهر، متجذرة في طبيعة الفرد وطبعه، فأحرى أن يكون ذا نزعة شعرية متعالية متمنعة، فإن الشاعرة تأبى في ظل هذه الإدارة: الإرادة المستبدة للكائنات الأخرى، إلا أن تواجهها بذاتها الرافلة في العناد والممانعة والحلم: ما دمت أيتها الكائنات الخارجة عن طوقي تفرضين علي رسائلك وإشاراتك، بوعدها ووعيدها فإنني سأنقلها بأمانة، ربما لأنك عجماء، صماء، بكماء، ولكن لي حريتي أنا ! حريتي في التصرف الشخصي غير القابل للمساومة والمقايضة، سأسبغ عليك من ذاتي بأحلامها وآلامها، وأحولها إلى لغة يفهمها من كُرِّم بالعقل والفهم وأعجنها بماء نغمة الصبا أو الحجاز أو النهوند… حينذاك سأشبهك ولا أشبهك، أبوح بك ولك وأبوح بنفسي ولنفسي، أحكي عنك، وأحكي عني، وإلا تحولت إلى مجرد صدى للسماء وظل للكواكب، ورد فعل غير مباشر للكائنات الأخرى، ألستُ من عجينة أخرى باطنها روح وموسيقى وظاهرها تبر وتراب؟ ! ما أنا بوصافة أو وصيفة !!!
على عشب هذا الحضور الكلي، يحدثها قلبها من داخل مقام الإرادة: أسر إليك/ بكل عيوني/ أريدك/ فيورق في ربيعك/ كي ينحني في اشتهاء المثول مريدك.
لترسم دمها الخاص على لوحة الأرق في جهد منفلت كالسهم.. من مكبس المألوف للتخلص من هيمنة السماء، بقدر ما تمنحنا من سخاء مصبوب في عناقيد مائية، ومن سطوة الكواكب، بقدر ما تنفحنا به من لغات مسكوبة في أشعة فوق رقمية كي تقرأ لها بيان الروح: لي إرادتي في الكتابة والحياة، لي شرعيتي الشعرية، لي حريتي في اختيار ألفاظي وتراكيبي، أنا لم أسخر منك لأسخرك كألفاظ ومركبات معجمية أعرض بها ذاتي وأحلامي على طبق من ماس أو مرمر!
لقد قبلت بموجب شرعية صبغتي الأولى: قطرة الفطرة، رهان الجوار والحوار والمودة والتناغم والتعاون بيني وبينك، هكذا أنطقتك وأدخلتك إلى داخلي فأخرجتك لآلئ شعرية تنتزع الإعجاب حتى من خصومي، والتصفيق حتى من غريماتي وهن نائمات، كما أنطقت بك أنت أفراحي وأشجاني وأرسلتها موقعة على قيثارتي من شرفة الروح للعشاق جميعهم، وما كان ذلك شيئا يدخل في بنود المصالح المتبادلة.
في البداية، اقترحتْ علي كينونتي الشعرية الأولى اجتراح أغراض معروفة على سبيل التجريب والمراودة، نفختُ فيها من روح القدماء أكثر مما نفخت فيها من روحي، فتدربتُ على حياكة منسوجات لغوية لكائنات كانت تطلب «الأوتوستوب» إلى الشهرة وتلميع صورتها، كان يحكمها شرطان: شرط المناسبة المفروضة، وشرط الوقت المفروض، وإلا فالعزل منفاي! !
بعد انقشاع الضباب في ذهني وقلبي، بعد النزول إلى مطهر الذات، مغارة الوضوء الأولى، بعد التمرس الخيميائي في مختبر اللغة والخيال على طقوس الكتابة، ومعرفة الدروب والصوى المؤدية إلى اكتشاف أسرارها، أصبحتْ ذاتي هي الموضوع. مفارقة عجيبة أن تتحول الذات إلى موضوع! تنافس هذان الضدان القادمان من فضاء الجدل، وتعاركا ثم تصالحا في النهاية وتوحدا على أرضية الروح وتشكلا في جوهر واحد ووحيد اسمه: القصيدة.
بهذا العبور الذي لم يكن سهلا، ولا سلسا، بهذا المرور إلى الألق الروحي، بهذا الخضوع لإرادة الرفض: ألا أكون نسخة طبق الأصل، أو طبعة منقحة ومزيدة للسماء وبناتها والأرض وأخواتها، استجبتُ، ودون سماع محاضرات ودروس من أحد، لما يمليه علي القلب، لم تكن تهمني التوصيات المباشرة وغير المباشرة التي أملتها الكائناتُ الاخرى على قلبي، بقدر ما كان يهمني أن أحصر اهتمامي فيما ينطق به ويأمرني به، مع الدخول إلى أدغال نفسي والقيام بجولات طويلة وقصيرة في جغرافيتها ذات التضاريس الصعبة، وفي سياق احتكاكي بالناس وإصغائي إلى آلامهم ، صرتُ أتعلم مفردات جميلة وجديدة، وأقترب في رحلة لغوية ملحمية من حدود قلبي ومحيطي وعصري بألفاظ حديثة؛ حين كان لابد أن تكون الحداثة الصادقة شرطا من شروط استمرار موهبتي وشخصيتي وإضاءة لجوانب عديدة من أصالتي دون استدرار لمديح أو إيحاء بأجرة !
أمينة المريني؛ شاعرة وُلدتْ تحت نجمة الوعد، ولما اندلق الندى في طبعها كالقطرة، خرجتْ لتقتحم بحر الشعر، وجرتْ بعضُ الرياح بما لا تشتهي سفينتها، لم ينل من إرادتها في اكتشاف كنوز ذلك البحر وجماله ولآلئه المخبوءة في طبقاته وجيوبه السفلية، صخبُ الأمواج والرياح العاتية، ظلت تراقب المشهد البحري- الشعري بتؤدة وحكمة وصبر البحارة المدربين على قراءة تضاريس أعالي البحار، تحني رأسها للعاصفة، وتتلمس أقربَ طريق للخلاص بعين الحدس أحيانا، وعندما استعاد المشهد صفاءه وهدوءه، لم تنخدع بظلالهما، ظلت هي هي! بقدر ما كان البحر هادئا كانت هي أكثر هدوءا لأنها أدركت بفطرتها المحررة من أدران الضغينة، وروحها المحتلة بحب الناس، ذهابا وإيابا، ذلك الإكسير الذي يجعل القلب لا يصدأ، الحب الذي لا يقبل الطرح أو القسمة… أن الهدوء الذي يتماهى بالوداعة، قد يجلب لها من الدمار، ما لا تجلبُه الرياحُ الهوجاء!
وفي رحلة الألف ميل، راحتْ تُجربُ بحكم المنبت والمحتد وأرومة المقام، ودورة الزمن، وحركة الكواكب، والحليب الأول، وسحر الآس المندلع من أكمام فاس، لعبتَها العموديةَ في الشعر، وتمنحُها ما يليق بها من زينة وحلي وغدائر سابحات على الرخام، وأنطقتها بما تيسر لها من فنون وأغراض، وما امتلكته من هواء لغوي قادم من واحات بلادنا العربية ذات المائة مليار نخلة ونخلة، عندما هبت عليها نسائم أخرى، وآلفت بحركة ضوئية بين اجتذابات الماضي وغيوم الغد المنبئة بالتحول، لتصنع حاضرها أو زمنها الشعري الخاص، أضحت تمنح لعبتَها الشعريةَ ذلك التوازن- لتفادي السقوط – الذي لا يُفقدها بطاقةَ الهوية وحالتَها المدنيةَ وبيتَها الدافئَ المطلَّ على ساحة الأصالة وساحة المعاصرة في الآن نفسه وأصبحتْ قصيدتُها متخففةً من بعض حليها وزينتها كأنها تعيش «حالة تقشف» !
وعندما راحتْ تغالب زمنَها الراهن، في أن تكون مواكبةً له، ولمطالبه ولاستفزازاته أبتْ إلا أن تبصم انتصارها على حوافره، هي معه وضده، لأنها في سباقها مع انزياحه ورياحه، تحمل في ذاكرتها الزمنَ الذي عاشته بنفسها، الزمنَ المحفور في طينة اللغة التي أورثوها إياها، لكنها انسربت في مجرتها الذاتية واللغوية حتى النخاع. فأن نجد في «مكاشفات» مفرداتٍ يندر استعمالُها في الديوان الشعري العربي الراهن من قبيل: رشأ – ستر- سلسل- برود- لظى- وامق- غلالة-غرير- كاعب- سرر- جوى- وجد-ظبي- فتك- شذاء- أصاخ- ثبج- شجو- شذاء- جنى- بيد-جبة-فاغم- محاجر- مدلجون- عفاف- سلو… فذلك معناه أن الشاعرة تحيا الزمن الذي ينغلق عليه مخزونُ كل مفردة من تلك المفردات، زمنا لا تُقاس كثافتُه برنينه وألفاظه المعروضة على واجهة الإيقاع، ولكن بدلالته الروحية والنفسية. فحين توظف مفردة «الوجد» أو «الجوى» في نص من النصوص، فإنها تدرك الفارق الجوهري بينهما وبين مفردة «الحزن» لما للمفردتين السابقتين من ثقل دلالي عميق في اللسان وفي الميزان، ضارب في تربة الوقت، يحيل على ظمإ الرمل وحمرة الجمر، وعنت السفر، ولوعة الانتظار في أعماق الإنسان نفسه، يختلف تماما عن سطحية الدلالة التي تشي بها مفردة «الحزن» التي تكاد تكون عادية في حديثنا اليومي.
وفي سياق السياق والسباق، لا يمكن الحديث عن مفردات مترادفة، ولا عن مفردات متشابهة بمعيار واحد. للمفردة ثقلها الأركيولوجي في سياقها، وللتشبيه في سباق المفردات داخل الجملة الشعرية ذاتها، وتنافسها كالأسماك الملونة داخل حوض مائي شفاف وهي تتطلع إلى ناظرها، سلطةُ البريق والحظوة لدى المتلقي، ونَواقصه ونقط ضعفه كلما تقدم المشبه عن المشبه به بأكثر من سنة ضوئية وحقبة جيولوجية، وله أجنحة سابحة في الأبعد، لا يحفها مقص، ولا يطاردها خيال مدرب على القنص كلما تأخر المشبه عن المشبه به، ولو بفارق نقطة.
بهذا العمق، تريد أمينة المريني أن تحيا بروحها في جذر المفردة الدالة، وأن تُقيم خيمتَها الجمالية فيما تعنيه بالتمام على سفح الاحتفال بالذات وبالآخر معا. لا تريدنا أن نتغذى على ملح ناقص، ولا على سكر زائد، ولا على فاكهة نُفخ فيها بالرش الكيميائي في كل ما تقدمه لنا من وجبات باذخة لا تنفد في «مكاشفات»، تتوسل بالمفردة المحسوبة على ما هو راهن، عندما يفرض المقام الشعري عليها استحضارها داخل النص، بكامل اللباقة، كما تتوسل بالمفردة الضاربة في لا شعور مجازنا العربي عندما تكون هناك دعوة كريمة صادقة عميقة لاستحضارها بكامل الأناقة، وفي غير تلكؤ أو تردد، لأنها ترى في استدعائها الذي لا يشبه استدراج الطيور إلى الفخاخ بذريعة «الرحمة»، عمق الدلالة الثرة الذي لا تراه في استدعاء مفردة سواها. أليس اسم «فاطمة» رغم رنينه الممتد إلى عتمة القدم أكثر جدة وإشراقا من بعض الأسماء التي تزعج سمعنا بضجيجها وفقرها في وقتنا الراهن؟!
أليس اسم «ليلى» المشتق من هبة الدوالي، المحمول على هودج قصائد قديمة وماتعة وخالدة كقامات أصحابها أقربَ إلى قاموس الغد، وما بعد الغد؟!
هل يجري الزمن وفق خط ممدود وغير محدود؟ أم يجري وفق نمط دائري أو لولبي؟ كأن الكائن مشدود إلى صخرة الحاضر بأمراس كتان قادمة من لحظات الفجر الأول للإنسان! !
وفي لحظات التأمل الذي يسبق الغد إلى أمس، يبدو لي وأنا جالس على صخرة الحاضر أن الزمن التكنولوجي والعولمي الدقيق الذي يهيمن على حواسنا؛ يُكلّس شعورَنا ويُبلد أحاسيسنا ويستهلكنا بجمالية وبوحشية في الآن ذاته، ويجعلنا نرمي عواطفنا بسرعة إلى ثلاجة لا تقل برودتُها عن ستين درجة تحت الصفر، مخافة أن تستيقظ، فيلقى القبض علينا بتهمة الاحتفاظ بالعواطف التي هي من رواسب البداوة والبراءة وطفولة البشرية، وبتهمة الإساءة إلى الحضارة الرأسمالية التي جاءت لتطحن كل شيء تحت عجلات السرعة والربح السريع.
هل هي خطوة أخرى على طريق تجفيف منابع الإبداع وضرب الألق الروحي في الصميم تحت طائلة ربح الوقت في كل شيء، وضمانا للسرعة في تلبية حاجياتنا وأغراضنا فلا تغدو مفرداتنا ومعها لغتنا سوى إشارات سريعة منتهية الصلاحية، يبتلعها التنين الالكتروني، ونغدو نحن، وتغدو أفعالنا وأقوالنا، وأحلامنا إذا كان لها الحظ في أن تبقى أحلاما إلى حين، مجرد أرقام لأرقام، يصبح الشعر معها في خبر كان؟
في العموم، تبقى القصيدة الجميلة خالدة، لأنها ليست كـ»المنظومة» التي تموت في زجاجة المناسبة، وأصحابها لن تنال من رهافتهم وهاماتهم استراتيجيات النبذ والإقصاء أو التدجين والاستغلال والاستهلاك المحلي !
للختام مذاق العودة إلى البدء، وفي البدء كانت الكلمة.
إذا كان النفري في مواقفه لا يتقدم في مضمار المعرفة إلا بالمعرفة «وقال لي إذا كنت من أهل المعرفة فلا خروج من المعرفة إلا بالمعرفة»، فإني أقترح على المتلقي أن يقرأ «مكاشفات» أمينة المريني بذائقة خاصة وأن يطارد رفرفاتها بروح شعرية، وأن يتحسس مواطن الصور والإيقاعات الجميلة السلسة العذبة والمعاني المشعة كقطع البلور، بما هو أبعد من الحضور الشخصي الملموس المتعين في الزمان والمكان، فكثير من نصوص الديوان، لا تحتاج إلى تفسير. التفسير آفة الوأد أحيانا، إنها نصوص تُحس، تُشم، تُدرك بالجنان والوجدان فقط.
باختيارها الإقامةَ في الذات الإنسانية، في مكابداتها ومكاشفاتها وتجلياتها الروحية، وباقترابها من الإنسان في بحثه عن الحرية، تكون الشاعرة القديرة أمينة المريني قد اختارت الإقامةَ في حديقة الجمال والألق الروحي التي لا تفنى ، وفي قلوب زوارها الكرام.
«مكاشفات» أمينة المريني أو المرور الصعب إلى الألق الروحي

الكاتب : عبد السلام بوحجر
بتاريخ : 21/04/2017