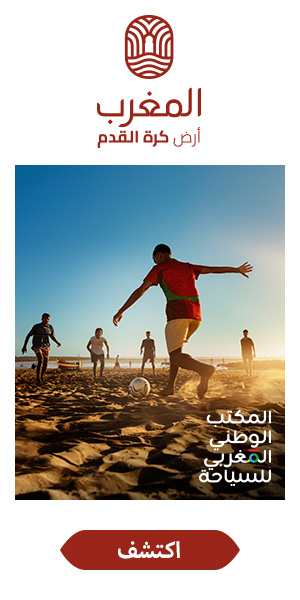احتضنت كلية الآداب والعلوم الانسانية المحمدية يومه الخميس 24 أبريل 2025 ابتداء من الساعة 9:30 بقاعة فاطمة المرنيسي يوما دراسيا نظمه مختبر الدراسات المقارنة في اللغات والآداب والثقافات والتاريخ، وفريق تاريخ وتراث المغرب في بعده المتوسطي و الافريقي في موضوع « الحجابة و الحاجب في تاريخ المغرب». و قد أكد أعضاء اللجنة المنظمة على أهمية عقد هذا اللقاء الفكري كلحظة تكوينية لفائدة الطلبة والباحثين وتمكينهم من التفاعل مع هكذا مواضيع بحثية خاصة مع مشاركة أحد أهم أعلام الكتابة التاريخية في بلادنا وهما الأستاذان مصطفى الشابي وعلال الخديمي كعلمين ساهما في التأصيل لعدد من الظواهر والمؤسسات المغربية التاريخية بحثا وتأليفا. وحري بالذكر أن المنظمين كانوا حريصين في التأكيد على أهمية دراسة تاريخية ممارسة الحجابة كمؤسسة رسمية تنظيمية تقليدية لا تزال حاضرة في المشهد المخزني للدولة بمفهومها التاريخي، بما تحيل عليه هذه الخطة ( بكسر الخاء) ذات القواعد التنظيمية الصارمة من ذاكرة تاريخية ووطنية، تحتاج اهتماما بحثيا حقيقيا، رغبة في إنجاز أقصى درجات التراكم المعرفي المنشود والشارح لتاريخية عدد من التنظيمات المخزنية في المغرب.علما وحسب نفس الاشارات، فإن سرديات ذاكرة التاريخ المغربي ، المعاصر منه والراهن على وجه الخصوص، تنطق بأدوار مركزية اضطلع بها حجاب سلطانيون، ساهموا في تشكيل لحظات مفصلية معينة في التاريخ السياسي لبلادنا، بما مكن من خدمة مؤسسة السلطان و تقوية حضورها داخل النسيج المخزني العام.
ثلاثة محاورموضوعاتية، يبدو أنها حركت بشكل عام مناقشات هذه الندوة الفكرية التي أدارت أشغالها أستاذة التاريخ بنفس الكلية مليكة الزهيدي.
الحجابة في تاريخ الدولة السلطانية بالمغرب
ساهم الموقع الجغرافي للمغرب في جنوب حوض المتوسط وشمال غرب إفريقيا في جعله تاريخيا منخرطا بشكل دينامي في حركة تأثير وتأثر سمحت بانتقال عدد من التنظيمات الادارية في الحكم الى ساحة التنظيم السلطاني للدولة بالمغرب، وهي تنظيمات أكدت الأركولوجيا التاريخية عراقتها الممتدة الى حضارات الشرق الأقصى كالفارسية و المصرية القديمة الى جانب حضارات متوسطية كالإغريقية. وكما تمت الإشارة إلى ذلك، فهذه التنظيمات انصهرت بدورها في تجربة الحكم بالخلافة الاسلامية بالمشرق ابتداء من الأمويين، قبل أن تجد لها موقعا في دواليب أجهزة الحكم ببلاد المغرب الكبير. وهو ما يعني أن مهمة الحجابة ومنصب الحاجب داخل المشهد السلطاني بالمغرب، هو نتاج تلاقح حضاري لتجارب الحكم التاريخية ببلادنا مع تنظيمات وافدة وهو ما ظهر بشكل جنيني إن صح التعبير في تجربة الدولتين المرابطية والموحدية خلال العصر الوسيط ببلادنا . مع العلم أن الحديث عن إمكانيات رصد بدايات الظهور الحقيقي لممارسة الحجابة في المخزن المغربي يظل عمليا صعبا، على اعتبار أن الخصوصيات المحلية التي أفرزت مشروع الدولة بمعناها التاريخي في المجال المغربي، كانت قادرة على ما يبدو على توليد أحكام سلطانية بشكل ذاتي و تلقائي من داخل بنية نظام الحكم المخزني نفسه بحكم مقتضى العمران البشري حسب التعبير الخلدوني( جزء من مداخلات مصطفى الشابي ومليكة الزاهدي وهشام أبورك). ولربما تأتي صعوبة التقاط بدايات بروز الحجابة كممارسة مخزنية للدولة في بلادنا، اذا أخذنا بعين الاعتبار معطيين أساسيين أولهما، أن الحضارة العربية الإسلامية نفسها أبانت حسب تعبير البعض عن قدرة في استيعاب ودمج عدد من التنظيمات الادارية في هيكل الدولة القائمة والتي كانت تنتمي الى جغرافيات ثقافية كونية متنوعة بشكل يجعل تمييزها صعب. وثانيهما، أن عددا من المصادر الإخبارية في تاريخ المغرب إلى جانب بعض الدراسات الحديثة ، تؤكد أن ممارسة الحجابة في هيكل النظام المخزني للدولة كان قائما دون أن تكون هناك حاجة لتمييز منصب الحاجب وتسميته، على اعتبار أن طبيعة الأدوار التي كان يضطلع بها عدد من هؤلاء الحجاب كانت تدخل عمليا في ممارسة الحجابة، ما يدل على ذلك بعض النعوت و المسميات المحلية اللسان الأمازيغي مثل منصب مزوار أو أمزوار. إلا أن هذا لا يعني إغفال أن معطى تأثر التجربة السلطانية للحكم ببلادنا تاريخيا وتناغمها مع بعض التنظيمات الوافدة، يظل قائما بحكم المساحات المتداخلة منالتواصل المتبادل التي ما فتئت تجمع المغرب التاريخي، بفضاءات حضارية أخرى كالأندلس و المشرق العثماني( جزء من مداخلتي لمياء جبير وحميد فاتيحي ومليكة الزهيدي).
الحاجب السلطاني
في المغرب: قراءة
تاريخية في الأدوار
اضطلع الحاجب السلطاني في تاريخ المخزن المغربي، بأدوار مهمة وهو ما يفسر الشروط الصارمة التي كانت تفرض التعيين في هذا المنصب، أهمها الولاء المطلق لشخص السلطان الحاكم مع الاتصاف بنوع من النباهة السياسية، أخذا بعين الاعتبار الانتماء إلى أسر بعينها لها حضورها القبلي أو الشرفي أو الاقتصادي الواضح، وهو ما أفرز دينامية معينة في إنتاج أدوار حجابية مارسها عدد من الحجاب السلطانيين في تاريخ المغرب من المهام التقليدية المتعلقة بتدبير الحياة الخاصة للحضرة السلطانية بمفهومها الأنتربولوجي داخل القصر، وحجبها عن نظر باقي أعضاء الجهاز المخزني في الدولة و العامة، إلى الإشراف على عمل عدد من الموظفين المخزنيين خاصة منهم المسؤولون على مهام الحراسة والأمن بالقصور السلطانية، وصولا الى لعب دور بنيوي وظيفي في الجهاز المخزني ككل عصبه المساهمة في الحفاظ على حالة التوازن، التي كانت تفرزها طبيعة الدولة نفسها والمتمثلة في التجاذب بين مراكز النفوذ القائمة وهاجس توزيع مساحات السلطة كما هو الشأن في تجربة الدولة المرينية ما بين منتصف القرن 13 و 15 ميلاديين.( جزء من مداخلات علال الخديمي ولمياء الغزاوي و صالح الشكاك ولمياء جبير). وقد سمحت هذه الأدوار لعدد من هؤلاء الحجاب السلطانيين بتجاوز المعنى الشرفي الذي يمكن أن يحيل عليه معنى المنصب سيميائيا الى توظيفه فعليا لكسب هوامش من النفوذ داخل ساحة القرار المخزني وهي سلطة كانت تمنحها تلقائيا و رمزيا ملازمة هذا الحاجب أو ذاك لشخص السلطان. وهي مساحات نفوذ ارتبطت جدليا بمدى قوة حضور شخصية السلطان نفسه داخل المشهد المغربي ككل، مع تسجيل عدم تجاوز الحاجب لمساحة الظهور والفعل المخزني التي كانت تمنحها له سلطة السلطان نفسها. (جزء من مداخلة حسن الصادقي وحميد فاتحي ومصطفى الشابي ولمياء العزاوي). وقد سمحت هذه الدينامية لعدد من الحجاب السلطانيين بلعب أدوار يمكن وصفها بالمؤثرة في لحظات مفصلية في تاريخ المغرب أمثال حاجب السلطان السعدي أحمد المنصور الذهبي(1578-1603م)عزوز الوزكيتي. لكن تبقى شخصية الحاجب السلطاني أحمد بن موسى أو «باحماد» كما هو معروف في السردية الدارجة والذي امتد شغله لهذا المنصب خلال جزء كبير من فترة حكم السلطان المولى الحسن الأول( 1873-1894م) وفترة السلطان المولى عبد العزيز(1894-1908م)، مثالا عمليا للأدوار التي مارستها الحجابة خلال هذه المرحلة الحساسة من تاريخ مغرب ما قبل الاستعمار، خصوصا على مستوى تمكن هذا الحاجب المدعوم بخلفية الانتماء الى أحد أهم فرق جيش المخزن وهم بواخر المولى اسماعيل( 1672-1727م) من الحفاظ على توازنات النفوذ داخل مركز القرار المخزني ضمانا لبقاء مؤسسة السلطان كفاعل رئيسي خلال العهدين المذكورين، خاصة على مستوى تدبير عملية البيعة الشرعية لأهل الحل والعقد والانتقال السلس للحكم داخل الأسرة الحاكمة، وهو ما تعبر عنه تدابير باحماد لضمان انتقال الحكم الى المولى عبد العزيز بعد وفاة أبيه المولى الحسن بمنطقة تادلة، وهو في طريق عودته الى فاس عقب قيامه بحَرْكة سلطانية الى بعض المناطق المغربية في الجنوب من أجل ضبط أحوالها والقضاء على بعض نعرات التمرد فيها( جزء من مداخلات علال الخديمي و مصطفى الشابي ومحسن أوشن). كل هذا يعطي دلالة على أن منصب الحاجب السلطاني بقدر ما كان محاطا بهالة مخزنية خاصة، بقدر ما كان وظيفة سامية سعى أصحابها الى الحفاظ على مركزية شخص السلطان وحضوره المرغوب والقوي في صناعة مشهد الأحداث داخل البلاد، وإن اعتبر البعض أن أدوار مثل هذه ما كانت إلا لتمنح لهؤلاء الحجاب نفوذا قويا لم يكن يحد منه عمليا إلا وجود نفوذ أقوى خاص بالسلطان كما أسلفنا القول.
من الحاجب السلطاني
إلى الحاجب الملكي: قراءة
في رمزية الاستمرار
عديدة هي الدلالات الرمزية بمعناها التاريخي، التي يحيل عليها استمرار وجود منصب الحاجب الملكي في المغرب الراهن اليوم، وهي دلالات شكلت موضوعا للبحث والتأمل من طرف كتاب أجانب خاصة الفرنسيين، سواء كانوا رحالة أو صحفيين منذ القرن 19م وإبان فترة الحماية الفرنسية على بلادنا في النصف الأول من القرن 20م. والملاحظ حسب الإشارات التي جاءت في هذه الندوة أن عددا من تلك النصوص العديدة إما أنها ذهبت في التأكيد على الرمزية القوية التي يحيل عليها منصب الحاجب داخل القصر السلطاني، أو أنها اعتبرت أن هذه المهمة لا تعدو عن كونها حافظت على مدلول برتوكولي شرفي لا غير كما هو الشأن في القصور السلطانية إبان زمن الحماية الفرنسية على المغرب ( جزء من مداخلات عادل يعقوب وآسية الوردة). والملاحظ أن استمرارية هذه الوظيفة المخزنية في مغرب اليوم، خاصة في أبعادها البروتوكولية الطقوسية داخل دار المخزن، سيظل مشحونا برسائل الاستمرار الرمزي الدال على عراقة تجربة الدولة أو المخزن كبنية متكاملة للحكم في البلاد المغربية.(جزء من مداخلة صالح الشكاك و محمد مزيان). مع العلم أنه في المقابل يظل الأمر أيضا قابلا للتثمين على مستوى البحث التاريخي من خلال جعل منصب الحجابة السلطانية مدخلا ممكنا للبحث في تاريخية أدوار عدد من الأسر ذات الانتماءات القبلية المتنوعة في تشكيل جزء من تاريخ المغرب، عبر منهجية كمية بيوغرافية تلامس ما هو بنيوي عميق، يجعلنا على ما نظن نتجاوز سلطة سرديات الأعلام في حال ظلت مقاربتنا البحثية تلامس ما هو حدثي على السطح فقط ( جزء من حديث تفاعلي بين لمياء الغزاوي وصاحب المقال). وتأتي الصورة التلفزيونية أو السينمائية لتمنح ممكنات جديدة أمام الباحثين للحفر سيميائيا في ما تنطق به تاريخية بعض الوظائف المخزنية بالمغرب، خصوصا أن تجربة المسلسل السوري «ربيع قرطبة» قد أثبت قدرة مخرجها نسبيا على تحويل محكيات من سيرة الحاجب الأندلسي المنصور محمد بن أبي عامر إلى مادة قابلة لمعالجة درامية تقاطع فيها ما هو تاريخي موثق، بما هو متخيل، و هي سيرة حاجب حظيت سيرته خلال هذه الندوة بعروض خاصة (جزء من مداخلتي محمد الكداري و محمد أجردي).