نـــــيـــــاحـــــةٌ
( عميق نهر حزني لأجلك خالتي. عميق بلا قرار. لأنك رفعتني من حيث ضعتي، وأعليتني، ووشوشتني أسراراً لم توشوشي بها أحداً غيري. أحس بالضياع كأنني طفل يتيم. كأنني شيخ هرِمٌ بلا حول، وأرملة بلا معيل ). م. ب
محفوفة بأفراد من عائلتها المقربين، وجيرانها لأوفياء، وصواحبها اللاّتي سلخن معها عمرا في الحلو والمر، وفي السراء والضراء، وجمع من المؤمنين؛ مرفوعة فوق نعش ملفوف في ثوب أخضر مكتوب على حاشيته: ( كل نفس ذائقة الموت ). كانت لا إله إلا الله تتعالى في عَنان السماء، وتزداد تعاليا من قِبَلِنا حتى خلنا ـ لحظة ـ أن الملائكة معنا، داخل صفوفنا، قدامنا وخلفنا، ترعاها وترعانا، مشيعة إياها رفقتنا. وصلنا المقبرةَ مشيا على الأقدام، بعد أن قطعنا قرابة الكيلمترين أو يزيد.
أنزلنا الجثمان الطاهر إلى اللحد، وأُطْبِقتْ عليه صفائح من حجارة عريضة، ثم أهيل التراب، تلٌّ من التراب به رمَسْناهُ ريثما تنقش الشاهدة باسمها حتى لا يندكَّ أثر القبر، ويُسَوّى بالأرض فتمحى مرتين.
قرئت سورة ياسين. قرئت آياتٌ قِصارٌ أُخَرُ. رفعت الأكف بالدعاء للراحلة بالرحمة والمغفرة وقد حلت ضيفة على الموتى، على الترابيين لتستقر إلى الأبد بدار البقاء.
عدنا أدراجنا ونحن صمتٌ ووجومٌ، وذكرياتٌ، ونشرٌ بيننا لمناقب المرحومة التي هدَّها مرض لعينٌ غير معروف حارَ في وصفه الأطباء الذين عرضت عليهم حالتها قيد حياتها. بين قائل بمعموديتها المزمنة، وقائل بانتفاخ طحالها، وقائل بسرطان دموي يوشك أن ينهي حياتها. فشهورها قصيراتٌ، بل أيامها معدودات، فوجب أن تخلد للراحة في منزل أقاربها لتتلقى العناية المطلوبة، والخدمة الواجبة.
توقف آخر نبض فيها. خرجت ورْقاءُ من صدرها، وطارت إلى المكان الأسمق، المكان الأرفع، بعد أن رأيتها ورأتني: تبادلنا نظرات كلْمى دامعة في دقائقَ، كأنما كانت تنتظر مَقْدَمي من فاس حيث أتابع دراستي بالجامعة. وكان مجيئي فيما أذكر، لغرض إداري، فإذا بأمي ـ وكنت بالكاد أخذت نَفَساً بعد رحلة شاقة في القطار والكار، تستحثني على الإسراع لملاقاة توشه التي تحتضر.
لن أنسى نظرتها الذابلة، واصفرار وجهها الزعروري، وقعر محجريها، وانطفاء شعلة الحياة فيهما. وكيف أنسى ابتسامتها المنكسرة على شفتيها اليابستين اللتين ما فتئت أمي وخالتي الأخرى، تبللانها بقطعة قطن منقوعة في الماء البارد علَّه ينعش روحها، ويملؤها رُوَاءً في لحظات انطفائها الأخير.
كأنها تحادثني في شأن مسارها ومسيرها في الحياة. كأنها لم ترد زَمَّ شفتيها وبُقْيا وجود يرعش في أوْردتها ودمها قبل أن تمتد إليهما يد الموت الباطشة المنتظرة على مقربة منا جميعا، فتغلقهما إلى الأبد، وتخطف روحها، وتسدل الستار على عمر قضته في الأسفار، وبديع الذكريات، وأجمل الأيام.
كأنها انتظرتني أنا على وجه الخصوص لأراها قبل أن يخطفها الغياب بعد أن تُوارى في التراب. وقد سمعت خالاتي، فضلا عن أمي، وكن كثيراتٍ يقلن، وقد تهيّاَ لهن ذلك بعد أن سحب الفقيه الغطاء على وجه توشه، إن توشه انتظرت ابن أختها محمداً ليراها وتراه قبل أن تودع الدنيا. ولو تأخر أياما لظلت في الانتظار. فابن أختها هو من فك أسرها، وأطلق روحها من محبسها.
صدقت خرافتهن النابعة من محبتهن ربما لي، المتصلة بمعرفتهن بعلاقتي بخالتي توشه. إذ كنت أقضي الليالي تلو الليالي عندها في بيتها بدوار أولاد الحاج حيث كانت تعيش جل الوقت وحيدةً من دون رجل يعينها على متاعب الدهر، ويشعرها بستره وظله. فزوجها سي حمّو كثير التنقل بين جرادة وحاسي بلال وكنفودة ووجدة، بائعا للخضر والفواكه، وقلما يعود إليها، وإن عاد فليوم أو يومين، ثم يواصل بعاده وسعيه الدائم الدائب، ضاربا في أرض الله، بائعا شاريا حتى لقيَ ربه.
وخلال الأيام التي كانت توشه تأتي فيها لتبيت عندنا، تسلمني مفتاح منزلها لأبيت وحدي فيه، ألتهم الروايات الرومانسية عربية وفرنسية، التهاما على ضوء لمبة الغاز، أو شمع من الشموع المتوافرة في مشكاة نافذة البيت الطينية ذات المربعات الزجاجية المعشقة.
كان الصمت الذي يجلل المكان، وضوء اللمبة أو الشمعة، فرصة ذهبية، وسانحة ثمينة للخلو بنفسي، والانغماس في ما اصطحبت معي من عدة وعتاد، إلى أول الغَلَس.
ففي بيت خالتي توشه، قرأت بلزاكْ، وفلوبيرْ، وستندالْ، وهيغو، ولامارتينْ في لغتهم. وقرأت ثلاثية نجيب محفوظ: بين القصرين ـ قصر الشوق ـ السكرية. وغيرها. وقرأت يوسف السباعي وطه حسين كروائي، والعقاد.
ما رأيتها إلا وهي في كامل زينتها: كحل وسواك، وعطر، وفساتين ملونة زاهية مرصعة على مستوى الصدر بأزرار لامعة، أو دبابيس مشعة تعكس ضوء القمر، وشعاع الشمس. في معصمها أساور من ذهب إبريز، وحول جيدها سلسلة ذهبية تنتهي بمصحف ذهبي منقوش يصل إلى نحرها. ولم تخلع، إلا نادرا، حزامها الثمين من الفضة الخالصة المموهة بماء الذهب، ولا خلخالها الثقيل الثمين من كاحلها إلا عند الوضوء أو النوم.
كانت الأكثر أناقة بين أخواتها، الأحرص على النظافة والاهتمام بمظهرها، والأوفر نشاطا وحيوية وهي تطير من مكان إلى مكان. فقد سكنت وجدةَ مع زوجها زمنا أيام كنت أعتبر زيارة وجدة من سابع المستحيلات، أو مكانا نائيا أين منه ركبتايَ، وأين منه إرادة أبي في تسفيري إليها لرؤية الحضارة فيها: عمرانها، ومقاهيها، وشوارعها المبلطة الواسعة والعريضة، وقاعاتها السينمائية، وليسياتها، وفنادقها، وأسواقها الممتازة، وحدائقها الغَناَّء، وأشجارها المصفوفة كأسنان المشط، أو كصف المؤمنين في توادهم وتراحمهم؟. وإذاً، سأنتظر سنواتٍ حتى ينادي ليسي عبد المؤمن عليَّ لأراها وأشربها.
أحببت خالتي توشه التي كانت مثالا في النظافة والأناقة، والضحك الذي لا ينتهي، والعطف الذي تغدقه عليّ، وعلى أمي، والدراهم البيضاء في الأيام السوداء التي كانت تنفحني بها سرا وخفية حتى لا يكتشف أمري. لذلك أجللتها وأحببتها.
ولقد تساءلت مع نفسي، وأنا أشيعها مع جمهرة من الناس إلى مثواها الأخير: كيف أمكن للمرض اللعين أن ينشب أظافره فيها، ويمزقها رويداً حتى صارت لحما على وَضَمٍ. وهي التي لم تبخل على نفسها بالعطور الثمينة، والفساتين الزاهية، والبلوزاتْ الوجدية المختلفة الألوان، والاختلاف إلى الحمام أكثر من مرة في الأسبوع، والذهاب إلى المشفى متى ما شعرت بوعكة أو دوخة أو حمى؟ كيف أمكن للموت أن يختطفها على حين غرة كالحدَأَةِ تنزل سهما من السماء على أرنب بلا حول، أو عصفور جميل ساهٍ يأكل من خَشاش الأرض؟
ومتى كان حتى أهملت نفسها، وتسرب إليها ما تسرب فأهلكها؟، وأي طعام فاسد، أو سم دُسَّ لها وضع نهاية محتومة سريعة لأيامها الجذلى الممشوقات؟
لم تلد خالتي توشه. لم تخلف ولدا. وقد يكون ذلك سبباً في أناقتها، واهتمامها بنفسها تجميلا وترفيها حتى صارت مضرب المثل بيننا في الحسن والنظافة واللياقة والأناقة.
حتى أَرِبَّتها ( وكانوا ذكرين وأنثى)، كانوا كباراً لما تزوجت من سي حمو الأرمل. وقد رضيته زوجا، وكنت أعرفه وأرتاح إليه لدماثته، وطبعه الكريم، وطيبوبته، ودروشته، واحترام زوجته، وتلبية مطالبها ورغائبها. كانوا يكنون لها الحب، ويمحضونها التقدير والمودة، رغم أنهم تفرقوا بعد أن اشتد عودهم، يبحثون عما يصنعهم، ويعلمهم الطيران لوحدهم، والسعي في أرض الله اعتمادا على فطنتهم وذكائهم، ومحصولهم العلمي أو العملي.
وتوشه مع لفقيرة فاضْمة جدتي العظيمة، شكلتا بالنسبة لي، في طفولتي وصباي، سندا ودعامة، ومثالا.
فإذا كانت أمي قد أنقذتني من طيش سرى إلى سلوكي، وعمىً إلى دروسي، وكاد يقصمني ويلفظني كنواة خارج التحصيل والموجودية، وأنقذتني من موت محقق وهي لا تَني تجري من ضريح إلى ضريح، ومن مشفى إلى مشفى حتى تعافيت وشُفيتُ، وتحصنت ( أي صرت حصانا)، فإن خالتي توشه وجدتي فاضمة سقتاني المثال، وأعطياني ما به أعتز وأقتدي وأفاخر، وهو التوقير، ومحبة الغير، والإيثار، واللباقة، وحسن الجوار.
لكنما اسم توشه ظل يحيرني. فما معناه؟ ومن أسماها به؟ وهل كان جدي يعلم أنه يقترح ويخترع اسما نادرا، غير مسبوق، وغير مطروق، ولا منشور.
ولم أهتدِ إلى اليوم إلى معناه، وإن كان يتشح فونيتيكيا بمخارج إيقاعية غربية أو أسيوية. لا أعلم. فالمنتشر من أسماء النساء أيامئذ، كان: فاطمة ـ الزهرة، ميمونة، مباركة، أم الخير، الكاملة، بختة، حادة، جَمْعَة، رْقيّة، حليمة.. الخ.
لكني عثرت، مؤخرا على ضالتي. فتوشَه بالفارسية تعني: قوة وحرارة، وتعني أيضا: زاد السفر.
فهل يكون جدي فارسيا من سلالة كسرى أنو شروان، وقد أُعطيَ اللغة الفارسية غيبا بعد أن اختلطت بدمه وجيناته من دون أن يعي ذلك أو يدريه؟
لكن، توشه.. توشه اسم ملموم على غموضه، ملفوف في طلاسمه وألغازه. وهكذا كانت خالتي، وربما سميت لذلك بتوشه. رحم الله توشه
جالتْ على خدها دمعتانْ
وحدها كانت الروح تنأى
وتدخل بيت الأمانْ.
ينزِفُ ، الآنَ، هذا الكمانْ
ينزف، الآنَ، يسكب وردَ الغمامْ
فالسلام عليكِ، السلامُ عليكِ إلى أن يَجِفَّ لساني
ويُطْبِقَ حولي الظلامْ
( محمد القيس)



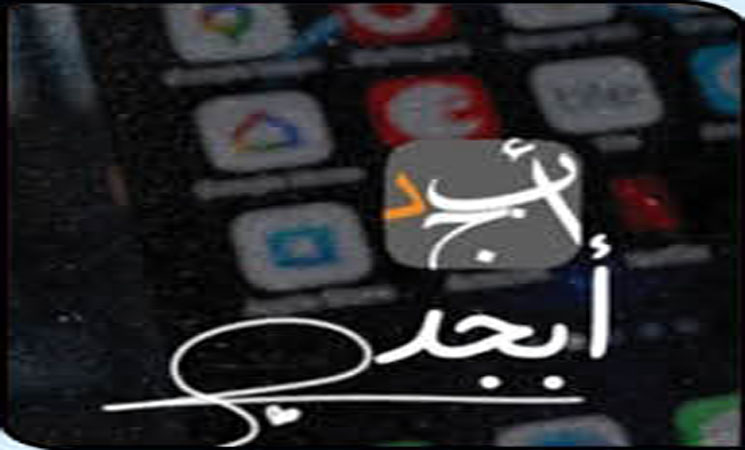



اترك تعليقاً