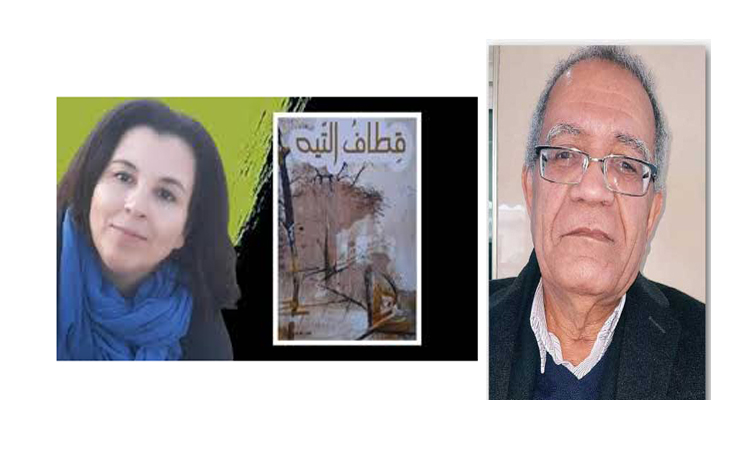أعلل النفس بالآمال أرقبها /// ما أضيقَ العيشَ لولا فسحة الأمل
( لا مية العجم: الشاعر الطغرائي )
أقسمت ألا أعود إلى الكلية، وإلى الشعبة / اللعنة، على رغم إلحاح أسرتي، وأصدقائي، وصديقاتي، ومناضلي الحزب الذين لم ييأسوا في ثَنْيي عما وطَّدْت النفس عليه، ورَدّي إلى « صوابي «، وإعادتي إلى المنطق والواقع، مذكرين إياي بأن الحياة ليست نجاحا كلها، بل إن الأكدار والأوضار أكثر ما يُرَنِّقها فتُسَوِّد عيشنا، وتربك خططنا، وتنسف مسعانا، وتقهقه في وجه ما عقدناه من أمل وأحلام، ضاحكة حتى النواجذ من أوهامنا ولهاثنا وراء رفاه العيش والسكينة، قائلة بالفم المليان: ما أنتم فيه، وما ترونه إِنْ هو سوى سرابٍ ويبابٍ، وما قتل الرجال، وأولي العزم والنضال، غير فائض الغيظ، وشراسة الانفعال؟
ركبت رأسي، وعاندت ما استطعت إلى ذلك سبيلا، لأن في الكلية، في شخص أبعاضها، موانعَ وحواجزَ يضعها ـ بنفس لوّامة، ونيةٍ مبيتة، ويدٍ آثمة ـ أولئك المتغطرسون الناقمون المنتقمون، أولئك الرجال « الجوف « بتعبير الشاعر الشاهق ت.س. إيليوتْ، الذين يسعون بما ملكوا من ضغينة ومكر في اعتراض طريق من يرون فيهم الضوء، ويَشِمون فيهم الإضافة والتفرد والاستثناء.
وربما كان ذلك منّي بعد « عودة « عقلي إليَّ، طيشا وأيّ طيش، ومكابرة مجانية لا تسمن ولا تغني، وانتفاخاً في غير محله كما أدركت بعد أن فات الفَوْتُ.
أكنتُ عنيدا عنادَ قُطْرُبٍ، دَعيّاً، مغروراً، وساخنَ الرأسْ كطنجرة رصاصْ؟
وما للتكرار، مالَهُ، ألاَ يزيدك صلابة وتماسكا، وقوة شخصية وانتصارا، ومجابهة أخرى؟، وكيف تطاوعك نفسك ترك الكلية، وهجر ساحات، وباحات، وأفضية لُذْت بها وأينعت فيها؟. ألا تعلمك العثرات أن الوقت حان لتراجع سلوكك، آراءك، مواقفك، اندفاعاتك، خفة رجليك، وخفة يديك، وخفة لسانك؟ أليس من الأخطاء يتعلم الناس؟
وبِمَ التَّعلُّلُ؟، أَبِالمثل الشهير: ( لكل جواد كبوة، ولكل صارم نبوة )؟. وهل كنتُ جوادا، حقاً؟، وكنت الفارسَ المغوار الذي لا يشق له غبار؟. يا لبشرايَ، ويا لسوء ما حدثتني وتحدثني به نفسي آناء الليل وأطراف النهار؟، أم كنتَ ابنَ فرناس الشاعر الرياضي الفلكي الطيار الذي صار على كل لسان، وسارت بذكره، وبفتوحاته، واجتراحاته، ألسنة الركبان، وذوو الألباب في البر والبحار؟
أجلْ، لقد كنتُه بمعنى ما، أو استلفتُ رمزيته، بالأحرى، ربما في ما بقيَ من مجده، ومن مرايا شموخه: سقطته الأسطورية التاريخية المهيبة التي صنعت منه بطلا ولا كل الأبطال؟. غير أن سقطتي ما هي بالأسطورية، ولا بالتاريخية، ولا بالخرافية، وإنما هي سقطة إذلالية مُدوّية، لم أُحْكِمْ، وأنا اتهيأ للطيران، ربطَ الحزام، وشد الأطراف، وإغلاق الإبزيم، وتفقد الأسانيد والبراغي، والتحوط لكل طاريء، واستباق كل ما من شأنه أن يفسد الرحلة، ويعكر المقام، ويطاح بك كما أطيح بالزعيم « الهمام «.
تمنيت لو أن العطلة الصيفية تطول، لو تتباطأ الأيام، وتَتسَحْلَفُ الساعات حتى أقضي وطري، وأجتني فاكهة الصيف على هواي، وأرتشف بُلالَةً من ماء أُرَوّي به عطشي للراحة والاستجمام، وأنسى، بالمَرَّة، ما عشته قبل أسابيع من مُنَغِّصاتٍ وأعتام.
استبدت بي الحيرة، واعتراني قلقٌ عاتٍ، وهبوط دم لا قِبَلَ لي بهما، وضاقتْ عليَّ الأرضُ بما رحُبَتْ، فلم أحِرْ ماذا أفعل، ولم أهتدِ إلى ما يُرْضيني، ويثلج صدري بعد أن يمسح « هزيمتي «.
يحدث للمرء، أحيانا بل في كثير من الأحيان، ما يشبه الشَّللَ النفسي والمعنوي. شللٌ في التفكير، شلل في التعبير، شللٌ في التدبير، وشللٌ في الحسم والقطع في خصوص ما هو مُقْبل عليه، ومندفع ـ بقوة غامضة ـ إليه. وليس من شك في أن ما يتسبب في غاشية الخنوع واللوعة، والدوخة الغريبة المستريبة التي تنتابنا، والتأرجح المُمِضِّ ما بين هذا وذاك، وهذه وتلك، وفقدان البوصلة، هو حلول مصيبة فُجائية داهمة، أو وقوع شيء غير متوقع، وحصول ما لم يَرِدْ بالبال، وما لم يُتَصوَّرْ ويَكنْ في الحسبان. وتلك آيات الإنسان في كل زمان ومكان: الإنجاز إلى حد الإعجاز، والضُّمور إلى درجة الدُّثور. العَمَى والإبصار، الكر والفر، الفرح والتَّرَح، الهناء والشقاء، الغفران والحرمان.. وَهلُّمَ ثنائيات ضدية، وأزواج متعارضة. أَوَ ليس بضدها تتميز الأشياء؟. أليس بها، وبماهيتها وجوهرها، وجود الوجود، وبناء الكون والأبد؟. ولنا في النور والظلمة، الليل والنهار ما يُخْرِسُنا، ويجعلنا نُسَلِّمُ بالحقيقة الأزلية، الحقيقة الضدية التي تتمثل في ما قلناه، وفي ما يفْجَؤنا، ويعلمنا كيف نحن ـ بني آدمَ ـ ترابيون وطينيون، أمواتٌ وأحياءُ إلى أن يرث الله الأرض ومَنْ وما عليها.
وكنتُ « نموذجا « في ذلك، ما يعني أنني كنتُ مثلاً يُدانَى ولا يُدانى في الإيجابيات والسلبيات: في الإقدام والإحجام، وفي التؤدة والاندفاع. تفترسني الظنون، وتسكنني الشجون، وتعتلي جبيني خطوط الكآبة والوساوس، والغضون. فشِخْتُ قبل أن أشيخَ وأنا في ميعة الصبا، وشرخ الشباب، ما دفعني إلى النأي بنفسي بعيدا عن الزحام والرّغام، عن الأحباب والأصحاب، وكنت الاجتماعي الذي لا يهدأ له بال، ولا يرتاح له ضمير، ولا يزوره فرح ما إلا إذا كان بين أصدقائه، ووسط أهله وخلاّنه. يغمره دفء العلاقة الحميمة، ويملؤه تيها ومرحا، ثرثرةُ المقاهي، ولعب الورق، والشطرنج والنرد، والخوض في ما يخوض فيه العارفون المَمْسوسون، المُكْتَوون بلظى الاستغلال، ونار التسلط والطغيان، أمثالي، وهم يرون أمامهم المفاحم والمناجم الغادرة تطوي أعمار آبائهم، وتُزْهِق أرواح ذويهم وجيرانهم وأصدقائهم.
وكنت، وأنا ساكن طواياي، مستقر في دواخلي، أُقَلّبُ الفكرة تلو الفكرة، وأدير ـ كما في لعبة الخذروف ـ خيطَ ما سوف أفعل في قادمات الأيام، ومقبلات الأسابيع، خصوصا وأن الدخول الاجتماعي، والسياسي والتربوي والجامعي، أزِفَ ولاَحَ.
تَشُكُّني دبابيرالأسئلة شَكّاً فتوجِعُني وتُدْميني. وتلسعني ذبابة سُقْراطْ لَسْعا لأُفيقَ من غفوتي بل من غفلتي. وتطحنني، بقسوة لا مثيل لها، رحىً لا مرئية دوّارة. وتقض الهموم، ليلا، مَضْجَعي. ومُتَسَهِّداً أعُدُّ النجومَ، وأدحرج سبحات الغمة والهموم. تَنْهَشُني الكوابيس نهْشاً. وبين الفينات القليلة النادرة، يزورني حلمٌ يتيمٌ ورديٌّ لكنْ يتهدده التَّصوُّح والذبول، فيتحول إلى فَتيتٍ وعصف مأكول.
فماذا عسايَ أصنع، وقد دثرني الليلُ والويلُ؟، وما السبيلُ القويمُ الذي يوصلني إلى ذاك الضوءِ الذي يلتمع رقراقا كالماء في آخر النَّفَق؟. وأي المطايا أمتطي لأقهر الصعاب، وأتخطى الحواجز، وأكسب قصب السبق والرهان، بعد أن أجُوزَ المضمار عَدْواً، وركضاً، ثم خَبباً راقصاً، وانتصارا؟
تعالَ على ضعفك وصَغَارِكَ. تعالَ على صورة لحمك ودمك، واستعنْ بلسانك وفؤادك لتستويَ فتىً غَضَّ الإهابِ لاَ يَهابُ، فتىً مفتولا، قابلا ومقبولا.
ألم يقل الشاعرزهير: لسانُ الفتى نصفٌ، ونصفٌ فؤادُهُ /// فلم يبقَ إلا صورةُ اللحم والدمِ
( يتبع )