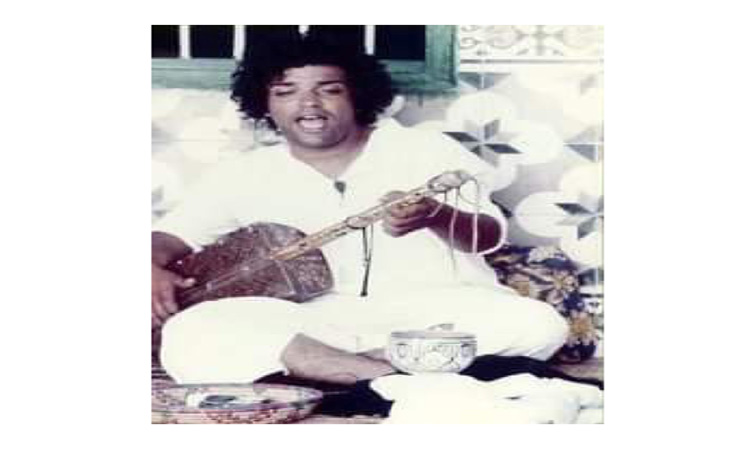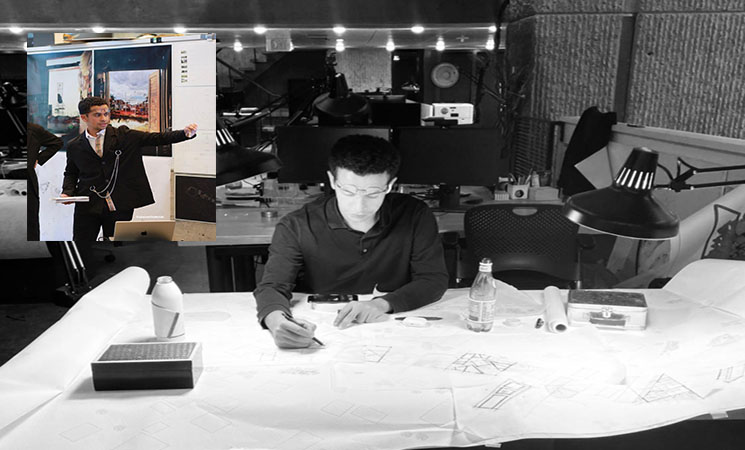باكو ورحلة تاكناويت الشاقة.. في انتظار الفرصة لفتح الأبواب الموصدة
هي مظاهر ومشاهد إما عشناها أو واكبنها كأحداث ، منها ما يدخل في إطار نوسطالجيا جمعتنا ومنها ما هو حديث مازلنا نعيشه ، في هذه السلسلة نحاول إعادة قراءة وصياغة كل ما ذكرنها من زاوية مختلفة ، غير المنظور الآني في حينه لتلك المظاهر والمشاهد والتي يطبعها في الكثير من الأحوال رد الفعل والأحكام المتسرعة ، وهي مناسبة أيضا للتذكير ببعض الجوانب من حياتنا ، وببعض الوقائع التي مرت علينا مرور الكرام بدون تمحيص قي ثناياها…
معلوم أن الهيبي كانوا لا يقبلون بمن لم يصل سنه العشرين أن يلتحق بهم، لكن استثناء، سُمح لعبد الرحمان رغم أنه لم يبلغها بعد، بالانضمام إليهم بفضل مهارة عزفه واستمتاعهم بنغماته النابعة من عمق الفن الكناوي العصي عن الولوج. كان لا يزال يافعا، جميلا، ومحبوبا، وكان جميع من يعزفون في الديابات يخرجون آلاتهم لمرافقته في العزف، فيما كان هو يعرفهم بتاكناويت من دون أن يعلم.
ولأن للكنبري نغمة خاصة تصل إلى دواخل الجسد، فقد كان عبد الرحمان العنصر الأهم في الجلسات بين أصدقائه القادمين من الدول الأخرى. وحتى بعيدا عن عالم الهيبي، كان السياح القادمون إلى مدينة الصويرة يسألون عنه أكثر مما يسألون عن كناوة الحقيقيين، فقط لأنه كان يتجاوب مع رغباتهم في العزف ولا يفرض الطقوس المفروضة في عالم تاكناويت، والتي تتطلب وقتا طويلا في تفاصيل أدائها. وبذلك، أصبح الطلب عليه متزايدا، سواء من طرف الأجانب أو من زوار الصويرة من أبناء الوطن، مما أزعج الطائفة الكناوية، إذ تحول هذا الشاب إلى منافس حقيقي، وشعبيته استمدها من خارج أسوار عالمهم ذي الشروط التعجيزية، حيث إن «تمعلميت» لا ينالها حتى أبناؤهم إلا بصعوبة كبيرة.
يستمر جمال الدين الصالحي متحدثا عن حظ المعلم الكناوي ذي البشرة البيضاء، فقد أصبح باكو مطلوبا حتى داخل أسوار مدينة الصويرة، أي في ساحة الطائفة الكناوية، وذلك بفضل طريقته الفريدة في العزف، التي لم تعتمد في الغالب على النقر على الجلد، بل على خلق النغمات وأدائه الغنائي القوي والمتماهي مع الأنغام. ورغم المقاومة الشرسة التي أبداها الكناويون ضد الوافد الجديد، معتبرين أنه يميع الطقوس الكناوية ويمارسها خارج إطارها الصحيح، لم يكن لعبد الرحمان أي اهتمام بهذه الملاحظات. فقد كان ماضيا في ممارسة شغفه، متماهيا مع وقع عزفه على الراغبين في الاستماع إليه.
كان يعلم أن الأبواب لن تنفتح أمامه بسهولة ليصبح معلما كناويا، ولن يشفع له عزفه أو حب الجمهور الذي صنعه بعفوية تامة، بسبب لون بشرته، شأنه شأن معلمه شباظة، الذي رغم مكانته، لم يُفتح أمامه أي بصيص أمل. بل إنه كان يدرك أن معلمين قبله، من ذوي البشرة السمراء، تم لفظهم من عالم تاكناويت وتحولوا إلى «كريمية». والكريمي هو الكناوي الذي يتجول بآلته، وكم كانوا كثرا في السبعينيات والثمانينيات، يجوبون أحياء المغرب ودروبه، ويعتبرهم الناس «بوهالة» أصحاب بركات، ويقدمون لهم المأكل والمشرب وحتى المساعدة المالية. معظم هؤلاء لم يستطيعوا ولوج عالم تاكناويت الأصيل لأن المعلمين الكبار لم يتركوا لهم فرصة، خاصة وأن «الليلة» أو «الحضرة» تتطلب مصاريف، كما تتطلب أن يكون للمعلم «مقدمة» تشرف عليها، بالإضافة إلى الحاجة إلى «الجذابة» و»القراقبية» وأصحاب الإيقاع. لذا، خرج الكثيرون بما تعلموه إلى الشوارع، وهو ما جعلهم يُلقبون بالكريمية، فيقال عنهم «تيكرم»، أي يطلب الصدقة، وهو أمر غير محمود داخل الطائفة الكناوية.
كان باكو واعيا بكل هذه التحديات، لكنه كان ينتظر فرصته للتمرد على هذا التقليد الذي يقف حجر عثرة أمام شغف أقرانه. لذلك، يعتبره الصالحي محظوظا بولوجه عالم الهيبي وذيوع صيته، لكنه كان محظوظا أكثر عندما تعرف على المقدمة حليمة المراكشية. فقد منحه المعلم شباظة «الصنعة»، وهو أقصى ما كان يمكن أن يقدمه له، لكن المقدمة حليمة كانت سيدة ذات مكانة وسط الطائفة الكناوية وتحظى باحترام الأسر، إذ كانت تشرف على «الحضرة» وتهيئ لها بدرب سيدي عبد السميح داخل سور المدينة، وكان معظم المعلمين يتوددون إليها ويحترمونها.
آمنت المقدمة حليمة بقدرات عبد الرحمان باكو، وجذبتها طريقته في العزف. ورغم كونه شابا، قررت أن تنظم له «الليلة»، وتجلب له المعلمين الكبار ليمنحوه الاعتراف إذا نجح فيها.