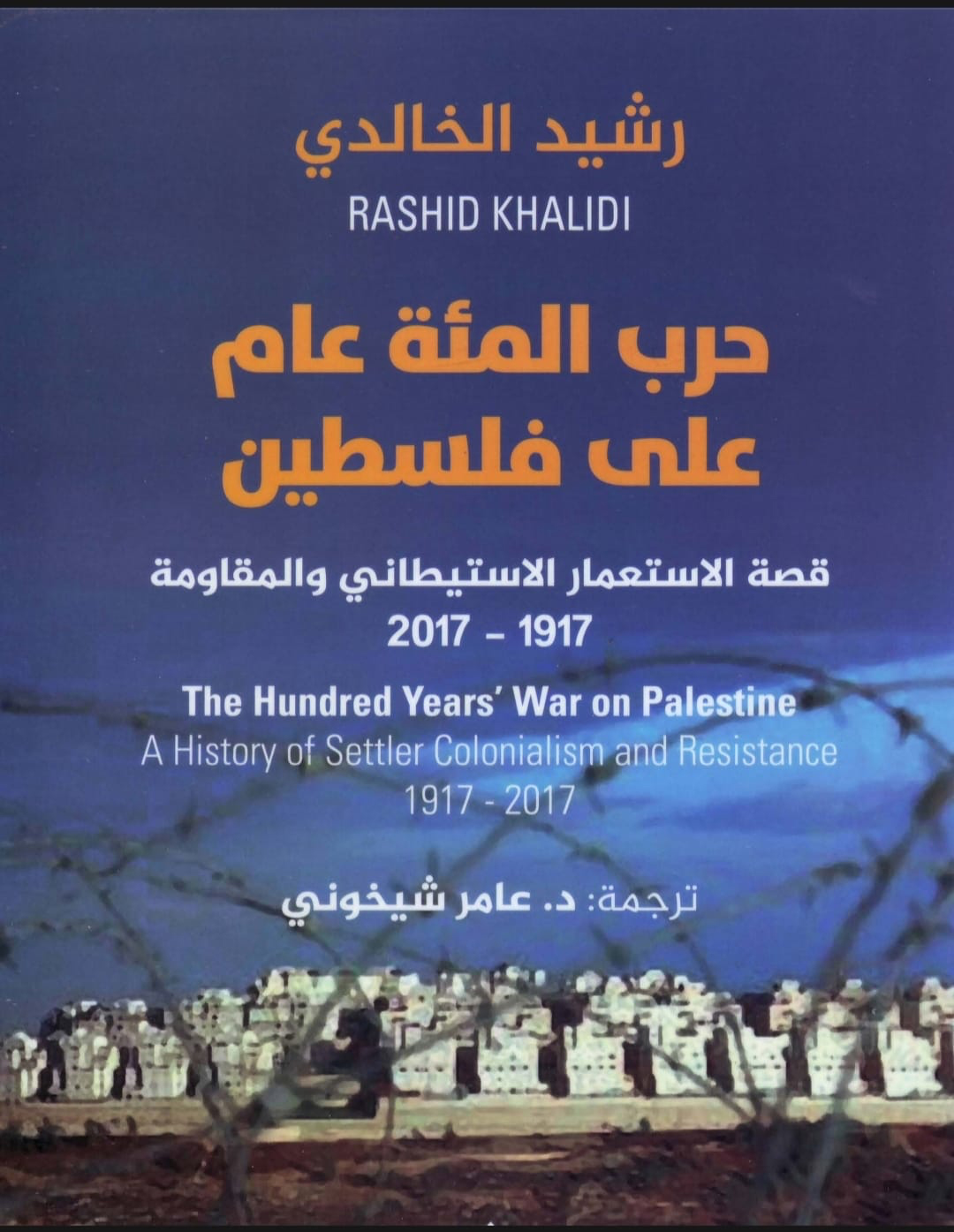بعد الحوار الذي أنجزناه مع المفكر والكاتب عبد الإله بلقزيز في صيف 2015 بجريدة الاتحاد الاشتراكي، وفي تقديمنا لهذا الحوار التزمنا مع المفكر وقراء الجريدة أن الحوار سيكون في ثلاثة محاور رئيسة: وهي الأدبي، والسياسي، والفكري. في صيف 2015 كان الحوار أدبياً وذاتياً. أما اليوم فإننا نطرق بوابة السياسي في إنتاج هذا المفرد بصيغة الجمع. انطلاقاً من كتاباته السياسية التي تدخل ضمن مشروعه النظري والفكري العام؛ حاولنا مشاكسته في بعض القضايا السياسية في راهننا العربي: فلسطين، العولمة، الديمقراطية، الدولة، المعارضة، ثم الخطاب القومي، والربيع العربي، وغيرها كثير.
كلما اقتربت من عبد الإله بلقزيز إلاّ وازداد حباً وتقديراً؛ فهو المبدئي الذي لا يفرط في مبادئه، مهما كان الثمن، يدافع عن مشروعه القومي باستماتة فارقة. فالمتتبع لأعماله سيصل، بالضرورة، الى هذه التقدمية، والحداثية في إنتاجه الفكري، وممارسته المهنية، وانخراطه في الجبهات المناهضة للعولمة والامبريالية… بل أكثر من ذلك فكتاباته السياسية تستشرف المستقبل، ليس لأنه يؤسس نظره على الفكر السياسي، والحداثي، والفلسفي، وإنما في انخراطه الكلي في قضايا العالم العربي. نفتح هذا الحوار لنتقرب من هذا الرجل أكثر؛ الرجل الذي يُحيط زائره بالحبّ والتقدير والكرم. نقول له شكرا لأننا اخترقنا عالمك، وفتحت لنا قلبك للحديث عن أوجاعنا، ومطبّاتنا، وأعطابنا السياسية والتاريخية.
وأقول شكراً للصديق محمد رزيق الذي شاركني في إنجاز هذا الحوار، والشكر موصول الى الاصدقاء الذين قاموا بتفريغ الحوار وكتابته (الإخوة محمد البوقيدي، محمد زكاري، إبراهيم وانزار). أملنا في أن يكون هذا الحوار إطلالة على الجوانب المهمة من فكر هذا الرجل.
o هل التدبير السياسي ل»لإخوان المسلمين» في مصر بعد الثورة، وفشلهم في ذلك، راجع إلى غلبة منطق الجماعة على منطق الدولة؟
n سبق وأن طرُح عليّ شيء من هذا، وسبق أنْ قلتُ إنّ جماعة «الإخوان المسلمين» لم تكن مُعدّة، منذ التأسيس، لكي تكون حزباً سياسيّاً قادراً على تأهيل نفسه لأداء أدوار في إدارة الدولة. أُعِدّت جماعة «الإخوان المسلمين»، منذ مؤسسها حسن البنا، وخلال فترة المرشد الذي أعقبه وهو حسن الهضيبي ومصطفى مشهور وقبله عمر تلمساني وصولا إلى آخر مرشد، أُعِدَّت لكي تكون حركة دعوية تجييشية تحشيدية في المقام الأول لا حركة سياسية مستعدة لأداء دور كبير بحجم إدارة الدولة والمجتمع. ولذلك ما إنْ استلمت السلطة حتى ارتكبت من الحماقات ما اقتضى حِنْق الجمهور ونقمته عليها، وبالتالي إسقاطها في انتفاضة 30 يونيو 2013م. هذه واحدة. الثانية، أنّ فكرة الدولة الوطنية ليست حاضرة في وجدان الجماعات الإسلامية وفي عقلها، مع أنّ حسن البنا اجتهد في عقله في أن يُصالح الإسلاميين مع الدولة الوطنية المصرية، ومن ذلك اعترافه بالدستور، ودخوله في الانتخابات. ولكن نوع التربية التي يتلقاها المنتسب إلى هذه الحركة، وسواها من الحركات، لا يَسمح له بتكوين حركة وطنية. وحتى حسن البنا المرشد المؤسس كانت له فكرة لم يستطع «الإخوان المسلمون» أنْ يبرحوها يوماً وهي أنّ حدود الوطن هي حدود الدين؛ أينما وقف الإسلام يقف الوطن. إذاً الإسلام عابر للأوطان، ففكرة الوطن ليست مقدسة في وعيهم، كما هي غير مقدسة في وعي القوميين والماركسيين، مع فارق أنّ للقوميين حداًّ اسمه «الوطن العربي»، والإسلاميون ليس لهم النظر نفسه؛ حيثُ إنّ الوطن هو الرقعة التي يصلها الإسلام، هي دار الإسلام، فإذا وصل أستراليا فهي باتت من دار الإسلام، وهذا منطقها. لقد أحيا البنا من جديد فكرة دار الإسلام بلغة معاصرة. ولهذا حصل أنّ محمد مرسي حينما كان رئيساً كان أمام ولائين: الولاء للوطن والدستور والولاء للمرشد. وأنا أذكر جيداً أنّ أحد الأصدقاء الصحفيين المصريين طرح سؤالاً على محمد مهدي عاكف، الذي كان مرشداً سابقاً ل»لإخوان المسلمين» أثناء حكم محمد مرسي وسأله: «إذا تعارض الدستور مع رأي الجماعة فهل على رئيس الدولة أن يعود إلى الدستور أو أن يعود إلى المرشد؟». فأجابه المرشد السابق قائلاً: «شرعاً عليه أن يأخذ برأي المرشد». ما الفرق، إذن، بين هذا الموقف وبين «ولاية الفقيه» في إيران؟ فإذاً المرشد، الذي هو رمز ديني، أعلى مقاماً من الدستور، والدولة لا تمثل شيئاً أمام جغرافية أخرى يمثلها هذا التنظيم خاصة وأنه تنظيم دولي وليس حكراً على المجتمع المصري، فحيثما وليت وجهك فثمة فرع ل»لإخوان المسلمين» في العالم الإسلامي. هناك، إذن، نقص فادح في الثقافة الوطنية والثقافة السياسية عند الحركات الإسلامية. وحينما يكون الحديث بالتخصيص على حركة «الإخوان المسلمين»، وهي الحركة الأكثر براغماتية، والأكثر استعداداً للاندماج السياسي في المجتمعات العربية والإسلامية، قياساً بحركات أخرى ذات طبيعة خارجية أو خوارجية تعتبر الديمقراطية كفراً، إذا كان الحديث تخصيصاً عن حركة «الإخوان المسلمين»، وهي من هي في قبولها بالقوانين والدساتير وفي براغماتيتها واستعدادها للمساومة… فما بالك بحركات أخرى لا تؤمن بكل هذا، بل تعتبره ضرباً من التجديف ومظاهر تبعية للصليبية، واعتبارها الأنظمة المعمول بها في السياسة أنظمة نصرانية ويهودية ولا علاقة لها بالإسلام؟
يعني هذا، في المحصلة، أنّنا أمام عقل منسد ومغلق ومتحجر على يقينياته، غير قابل للتأقلم مع التحولات. ولقد يقول قائل إنّ بعض حركات «الاسلام الحزبي»، وبعض قادتها خاصةً، أبدى تكيّفاً ناجحاً مع مقتضيات السياسة وموجباتنها، ومع النظام السياسي والقانوني للدولة، فاختطّ لنفسه نهجاً واقعياً أتاح له ، في ما بعد، أن يحرز نجاحاً في المشاركة السياسية، وأن يخاطب مصالح اجتماعية متعددة بمفردات السياسة. وأنا لا أعترض على مثل هذه الرواية الإجابية عن بعض قليل من القوى الإسلامية. ولكنّي، في معرضي هذا، أنبّه إلى أمور ثلاثة مترابطة: أولها أنّ أول ذلك التكييف جرى فكرياً أو فقهياً في نصوص قادة مثقفين للحركة الإسلامية، والمثال الأجلى والأعلى هو كتابات الراحل حسن الترابي في السودان ومراجعاته النيرة، الجريئة والعميقة. ولن يجاره في ذلك من الإسلاميين إلا تلميذه راشد الغنوشي، وخاصة في كتابه «الحريات العامة في الدولة الإسلامية». أما الذين نحوْا منحى الترابي والغنوشي من الإسلاميين في مصر، فاجتهدوا وتأقلموا مع متغيرات الواقع والسياسة، فهم خارج «الإخوان المسلمين» أو على هامشهم مثل: أحمد كمال أبو المجد، وطارق البشري، ومحمد سليم العوى، وفهمي هويدي، والمرحوم عادل حسين، ولا أجد لهذه القلة القليلة من الإسلاميين نظراء في «الإسلام الحزبي» يضارعهم في إرادة الاجتهاد والتطوير. وثانيها أن التكييف الفكري هذا ظلّ حبيس نصوص القادة (الترابي، الغنوشي) ولم يترجم نفسه تكييفاً لسياسات تنظيماتهم الحزبية، تماماً كما لم تجد كتابات الإسلاميين المصريين، الذين ذكرنا، طريقها إلى البيئات الحزبية الإسلامية وخاصة إلى بيئة جماعة «الإخوان المسلمين»، حتى أنّ الجماعة ضاقت بمعارضيها فضردت قيادات منها، أو دفعتها إلى الانسحاب، مثل محمد السيد حبيب، وعبد المنعم أبو الفتوح، وكمال الهلباوي، وثروت الخرباوي وغيرهم. ثالثها أنّ مؤسسات «الإسلام الحزبي»، المشاركة في الحياة السياسية العربية، درجت على أسلوب ازدواجية الخطاب؛ فهي تستخدم خطاباً سياسياً حديثاً في مخاطبة الرأي العام، قصد تلميع صورتها، والإيحاء بتغيرها، وإطفاء المخاوف منها عند الخصوم أو غير المحازبين لها، وتستخدم خطاباً نقيضاً في داخلها الحزبي مبنياً على المفاصلة وع الخصوم والأغيار، و – بالتالي – فهي تربي جمهورها الحزبي على قيم أخرى غير تلك التي تعبر عنها إعلاميا.
هذه عموماً مشكلات قوى «الإسلام الحزبي» مع نفسه، ومع الآخرين، في مسألة تحرّره أو انغلاقه، تكيفه أو نمطيته الأقنومية، أما بعض الحركات التي أجبرتها توازنات القوة، وليس وازع المراجعات الذاتية، على أن تتعقل أكثر وأقصد هنا: حركة «النهضة في تونس»، و»العدالة والتنمية» في المغرب، وأنْ تتأقلم مع حقائق واقع الأمر السياسي، هي حركاتٌ سيقت سوقاً إلى ذلك بسبب قوتها المتواضعة في التوازن الداخلي، ونحن لا نستطيع أنْ نحكم عليها حكماً نهائياً إلا في الحالة التي تكون فيها «النهضة» قد اكتسحت كل مقاعد البرلمان أو أكثر من نصفها في تونس، أو حينما تكون «العدالة والتنمية» قد حصدت مقاعد البرلمان أو أكثر من النصف في المغرب، وبات في وسعها أن تشكل حكومة منسجمة. حينها فقط يمكن أنْ نحكم عليها في ما إذا كانت، حقّاً، تؤمن بالسياسة وقواعدها، أو أنها تدخل إلى السياسة محمولة على الفكرة الكلاّنية التوتاليتارية، وتمارس تقاليدها الإقصائية على مخالفيها ومعارضيها كما فعل «الإخوان المسلمون». وقد ذكرت لك سابقاً أنّ «الإخوان المسلمين» لم يكلفوا أنفسهم، عندما شكلوا الحكومة في عهد محمد مرسي، حتى أنْ يُشركوا أقرب حلفائهم إليهم وهم السلفيون، وهذا دليل فائض على الأدلة السابقة على أنّ هذه الإقصائية وهذه الإنغلاقية سمة ثابتة في علاقة الإسلاميين بالسياسة والشأن السياسي.
ولكن، دعني –هنا-أوزّع النقد والمآخذ بشكل عادل؛ دعني أعتنق القدر الكافي من قيم الموضوعية والنزاهة التي تسوِّغ لشرعية أحكامي النقدية على قوى «الإسلام الحزبي»؛ دعني أقول، إذن، إنّ هذه الإقصائية والكلاّنية في الوعي والسلوك السيايّين ليستا سمتين خاصتين بالإسلاميين حصراً، وإنما هما يطبعان وعي الحركات السياسية كافة وسلوكها تجاه مخالفيها. نحن في بلادنا العربية لا نعاني وطأة الأصولية الإسلامية وأزعوماتها فحسب، بل نعاني –أيضاً- وطأة الأصوليات العلمانية: الأصولية القومية، والأصولية اليسارية، والأصولية الليبرالية…إلخ. وكما أنّ بين هذه الأصوليات فواصلَ وتمايُزات، بينها جوامع ومشتَرَكات لا تُحصى. القوميون العرب كالإسلاميين، إقصائيون وضيِّقو الصدر بالمخالفين؛ واليساريون العرب كلّانيّون لا يروْن في الصورة إلاّ أنفسهم؛ والليبراليون العرب ديكتاتوريون بامتياز ولا يحملون من الليبرالية والديمقراطية غير الاسم يتدثَّرون به؛ والعلمانيّون العرب، عموماً وعلى اختلاف منابتهم ومشاربهم الفكرية، دوغمائيون حوّلوا العلمانيةَ إلى دينٍ اعتنقوا تعاليمه حرفياً. وإلى ذلك إذا كان وعيُ الإسلاميين سلفياً وثقافتُهم نصِّية، فإنّ للقوميين والماركسيين والليبراليين العرب سلفَهم الصالح أيضاً، وثقافتُهم حبيسة نصوصهم المرجعية. وهكذا تعاني تياراتنا السياسية كافة – إسلامية وقومية ويسارية وديمقراطية – نقصاً حادّاً في قيم التسامح والحوار والاعتراف باتلمخالف، وتضخُّماً مَهُولاً في النرجسية والانغلاق والتعصّب وإرادة السيطرة والهيمنة. ليس في القنافذ أملس، كلّ ما في الأمر أنّ الفرق بين الأصوليات العلمانية والأصوليات الإسلامية في أن الأولى (أي العلمانية) لا تورِّط اسم الله تعالى وتعاليم الإسلام في تبرير تسلطيتها وإقصائيتها كما تفعل الأصولية الإسلامية، وهو «فرقُ عُملة» كما يقول إخواننا في المشرق العربي، أما الجوهر الإيبيستيمي والفكري والرُّؤيَوي فواحد؛ فالأصوليات السياسية الأربع لا تقترح على مجتمعاتنا إلاّ نظاماً سياسياً فئوياً مغلقاً!