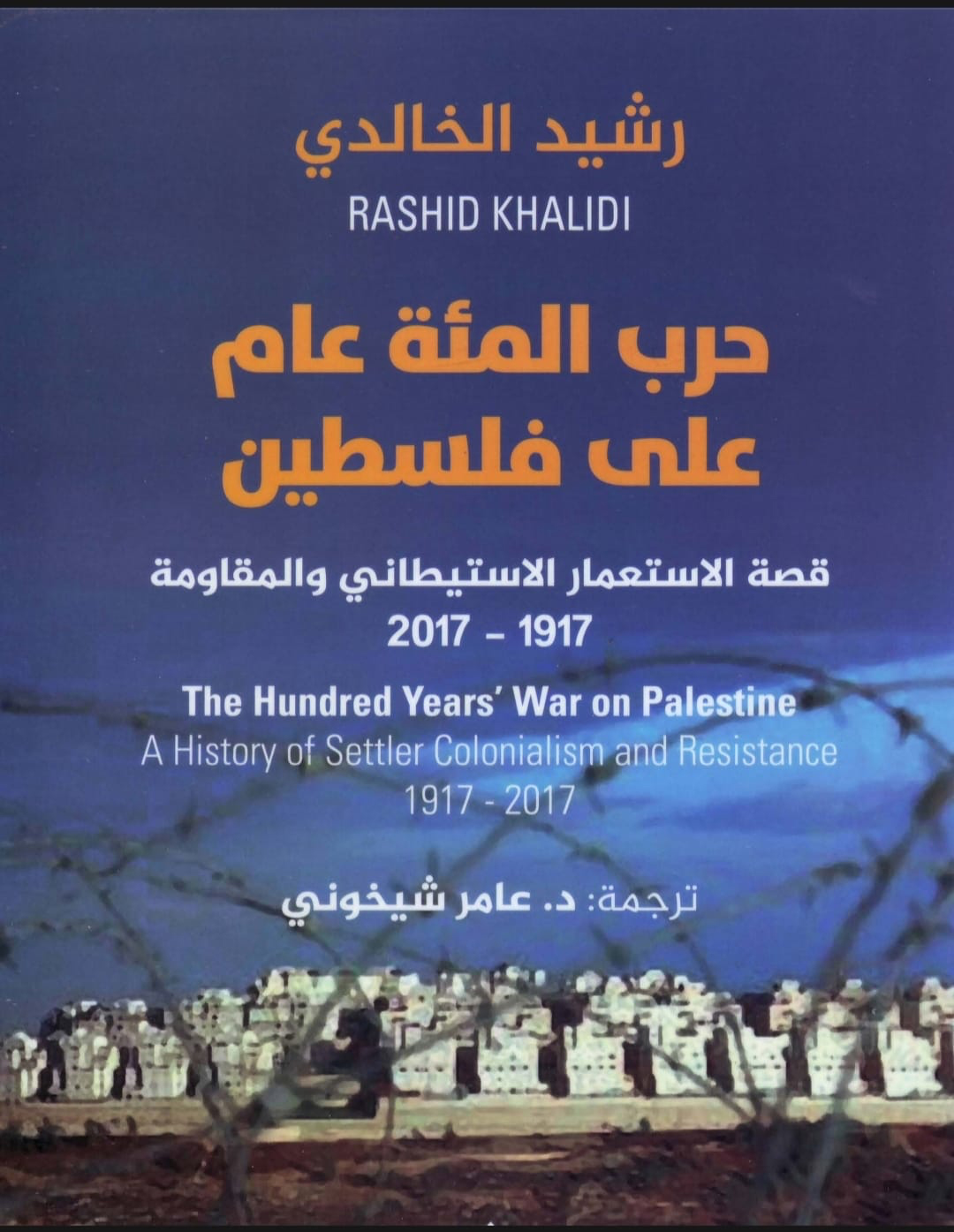الممرض .. العمود الفقري لكل المؤسسات الصحية بمختلف مستوياتها، «الدينامو» المحرك للعملية الاستشفائية، الذي يقوم بالعدد الأكبر من المهام لفائدة المرضى، ويتعامل مع مختلف الفئات والأشخاص، أحيانا حتى ما قبل ولادتهم، عندما تكون المرأة حاملا وتقوم بالوضع، وبعدها في مرحلة الرضاعة، فالطفولة، ثم الشباب، وعندما يبلغ المرء أشدّه، وبعد ذلك أثناء مرحلة الكهولة. طيلة هذه المسيرة العمرية، يحضر الممرض والممرضة، لتقديم حوالي 80 في المئة من الخدمات الصحية.
الممرضون والتقنيون يشكلون نسبة 56 في المئة من مهنيي الصحة، يقومون بمهام جسيمة، قد تنال اعترافا من طرف البعض، وقد تواجه بالجحود والنكران من طرف البعض الآخر، خاصة من الذين ينظرون للممرض نظرة تقليدية، نظرة «الفرملي»، انطلاقا من منظور «تقزيمي»، ممن لا يزالون سجناء زمن مضى وولى، ولا يعلمون بأن الممرض إطار بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وساعد من سواعد النهوض بالمجتمع وبنائه.
الممرض ليس دائما عنوانا للرشوة، للتسويف واللامبالاة … والممرضة ليست هي تلك الشابة التي تهتم بأظافرها، وتضع فواكه في جيب وزرتها، المشغولة بهاتفها النقّال .. وهي الصور النمطية التي تحاول بعض التصنيفات تكريسها وتعميمها، باعتبارها قاعدة وليست استثناء كما هو حال مختلف القطاعات.
الممرض قصة ليست كباقي القصص، يومياته ولياليه حكايات تستحق أن تروى، هو جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع، بإيجابياته وسلبياته، وبالتناقضات التي يحبل بها.
للتقرب أكثر من الممرضين والممرضات، تفتح «الاتحاد الاشتراكي» صفحاتها في فسحة رمضان، لعدد من المنتمين لهذه الفئة، لكي يحكوا عن طبيعة الأقدار التي ساقتهم لاختيار هذه المهنة، أو ينقلوا إلى القراء تفاصيل واقعة من الوقائع التي عاشوها والتي تركت وقعا خاصا عليهم، للكشف عن وجه آخر للممرض/الممرضة غير ذاك المتخيّل في كثير من الأذهان.
أواخر شهر يونيو 2003، كأنه الأمس، رغم مرور سنوات عدة إلا أن الذكرى ما تزال حية في ذاكرتي ربما لأنها كانت لحظة مصيرية تغيرت فيها كل خططي للحياة… فبعد فشلي في ولوج المعهد العالي للصحافة، أنا من كنت أظن أن كل معلوماتي الثقافية التي كنت أتباهى بها في المسابقات العائلية والمدرسية، بفرنسية أقل ما يقال عنها أنها جيدة ثم إسبانية بلكنة مغربية، رغم محاولاتي مضغ بعض الحروف، تؤهلني لولوج مهنة طالما حلمت بها، لأعود من امتحانها بخفي حنين واتجه إلى الخطة باء وهي الجامعة لأتذوق ولسنة واحدة متعة الدراسة في الحرم الجامعي بهيبته آنذاك وقدسيته لدى أبناء جيلي وحصولي على نتيجة جعلتني أحلم من جديد ببناء مستقبل في مهنة التدريس، لتظهر فجأة «الجنية» الطيبة التي ستغير مساري للمرة الثالثة…
أمل هو اسمها، همست لي ونحن عائدتان من الجامعة بعد اطلاعنا على نتائج آخر السنة أن هناك مباراة لولوج معهد تكوين الممرضين هنا في القنيطرة، فرفضت، أجل لم أقبل بالفكرة وقلت وأعتذر عن الجملة لكل ممرض (صاافي بقات لينا غير تفرمليت)، صدقوني لا أعرف للآن كيف أقنعتني بإعطائها أوراقي الت قامت بدفعها، فقد رافقتها وأنا كارهة الأمر، وما إن وضعت قدمي في الساحة الصغيرة للمعهد حيث كان هناك حشد كبير من الشباب في وضعيات مختلفة، واقفون، جالسون، مقرفصون، ينتظرون دورهم لوضع ملفات ترشيحاتهم، ولأن « اللي فيا ماهناني» كما يقال، أذكر أنني قلت لها ساخرة (من هذا القوم كامل غيهزوا سميرة وأمل .. مسكينة كتحلمي).تعليق كذّبه ساعي البريد الذي جاءني برسالة إنتقائي بعد أسبوع لاجتياز الامتحان الكتابي، وبعده بشهر توصلت بظرف آخر يحمل خبر نجاحي ويحدد موعدا لتاريخ أجري فيه الامتحان الشفوي، فوجدت نفسي أول شهر شتنبر من الناجحين الخمسين الذين سيدرسون مهنة التمريض، وإن كنتم تتساءلون عن صديقتي فهي الآن أستاذة اجتماعيات في مدينة أكادير بعد أن كانت فقط سببا في دخولي لهذه المهنة…لم أخترها، لكني أعترف اليوم وأنا في كامل قواي العقلية أنه لو عاد بي الزمن للوراء لاخترتها، وأنا شاكرة وممتنة لكل لحظة ألم، لكل مواجهة مع أوضاع لم أكن أعتقد أنها موجودة، بحكم أني لم أتحرك من وسط المغرب إلى أن جاء تعييني الأول بإحدى قرى مدينة شفشاون، فاكتشفت أن بلدنا السعيد سعادته نسبية، فقد وقفت ولعدة مرات موقف العاجز أمام حالات أقل ما يقال لأصحابها ( ليكم الله…)، ومهما حاولت مسحها من ذاكرتي إلا أنها تأبى ذلك، فقد حفرت بدم ودموع بشر يستحقون لقب المعذبون فوق الأرض….
أطفال بأيدي مشققة، وخدود حفر برد جبال الريف خطوطه عليها، وشعر بلون الشمس و»قطعان» من القمل تسرح وتمرح…نساء بعيون عسلية فاتحة، خضراء وزرقاء، لكن بأصابع تركت فيها «النبتة الحرام» آثارا لا يمحوها صابون ولا ترطبها مراهم .. نساء مازلن يخفن من موانع الحمل ويمتن بارتفاع الضغط وينزفن حتى آخر فكرة، ويأتين إلى المركز الصحي محملات على نعش كمحاولة أخيرة لإنقاذهن …رجال ينظرون إلى كل سيارة تلج إلى داويرهم بشكّ، ثم تنفرج أساريرهم بالترحاب بمجرد أن يعرفوا أنها تابعة لأناس الصحة، فذلك معناه تلقيح لأطفالهم، بضع معاينات طبية وأدوية ستسكت ولو لبعض الوقت صراخ عظامهم من التهاب المفاصل، وسعال قصباتهم الهوائية وغيرها… فأنا وغيري كثير، اعتبروا عملهم في المغرب «البعيد» بمثابة تجنيد إجباري علمهم الكثير، هدم فيهم أشياء وشيّد لديهم قناعات، عن الخدمات .. عن الصحة .. وعن الإنسان…