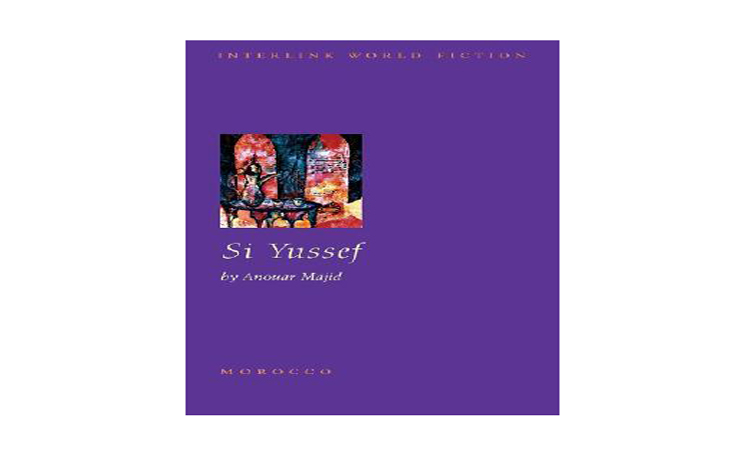أنور مجيد، كاتب مغربي مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية. حضوره في عالم الكتابة وازن ونشيط ومتنوع، همّه الأساس المساهمة في الجدل الفكري الأمريكي والعالمي، إذ تركز انشغالاته الفكرية، التي ظهرت بواكيرها إلى الوجود منذ بداية القرن الجديد، على تفاعلات الثقافة والسياسة والتاريخ في العالم المعاصر. فهو وجه من الوجوه البارزة في مجال دراسة الدين، خاصة مكانة الإسلام في نظريات ما بعد الكولونيالية وثقافات العولمة. كما أنه، إلى جانب ذلك، مهتم بحقوق الإنسان والثقافات والآداب والحضارات العالمية والتاريخ (تاريخ الأندلس مثلا) والسينما، وغير ذلك من مشارب فكرية وإبداعية أخرى ساهم فيها بنظر تأملي بناء ونفَس نقدي ثاقب.
لن يكون هذا الجانبُ الفكري مدارَ الانشغال في هذه القراءة، وإنما جانب مغاير آخر بصم فيه أنور مجيد على تجربة مهمة وغنية بدلالاتها وأبعادها. والمقصود هنا تجربة التخييل التي أبدع فيها- حتى الآن- روايتين بالإنجليزية هما: «السي يوسف»› (الصادرة سنة 1992، وفي طبعة ثانية سنة 2005) وفرصة ثانية في طنجة (الصادرة سنة 2020). لقد اجترح في هاتين الروايتين- على الأقل- هوية إبداعية ذات مقومات تعبيرية وفنية وجمالية خاصة به. تتميز هذه المقومات باهتمامها بطنجة وفضائها المكاني الآسر وإنسانها الكوسمبوليتي وتاريخها العابر لكل العصور والأزمان. كما تتفرد بنفسها السردي الجامح الذي يقود القارئ بسلاسة عبر محطات الرواية وأحداثها ويعرفه بشخوصها المتعددة والمختلفة. لا بد من الإشارة، أيضا، إلى أن أنور مجيد صار، بفضل روايتيه هاتين، ينتمي إلى سلالة خاصة من الأدباء، أمثال، «بول بولز» و»وليم بوروز» ومحمد شكري والطاهر بنجلون وليلى العلمي و»ماتياس إينار» وآخرين، ممن أغنوا تقليدا أدبيا طويلا جعل من طنجة موضوعا أثيرا في الكتابة الإبداعية.
تتناول هذه القراءة روايته الأولى «›السي يوسف»›. تحكي هذه الرواية قصة لقاء جمع بين الطالب الجامعي «لامين» العائد للتو من جامعة ظهر المهراز إلى طنجة لقضاء عطلة قصيرة بين أهله وأصدقائه، وشخصية السي يوسف، هذا الرجل الطنجي المخضرم الذي عركته الحياة، فأكسبته عقلا راجحا وهدوء صافيا. يلتقي الاثنان بمقهى العشاب، لينصت الأول إلى تجربة الثاني الحياتية وإلى مواقفه الإنسانية، فتمتد جلسات الحكي- ومعه السرد بالطبع- لأيام عديدة، حيث يعود السي يوسف بجليسه لامين إلى أيام يتمه الطفولي، ثم يعبر به نحو مرحلة اليفاعة التي فرضت عليه تحمل مسؤولية مبكرة: إعالة والدته وشقيقته الكبرى. ويمثل زواجه بامرأة إسبانية تدعى «لوسيا» حلقة مفصلية في الحكاية، لأن هذه الزيجة أثارت مواقف نمطية سخيفة جعلت السي يوسف يتخلى عن ارتياد مقهى النجمة، ليستبدله بمقهى العشاب، تفاديا لانتقادات بني جلدته وتعليقاتهم، بل وسخرياتهم اللاذعة من ارتباطه بنصرانية ستهجره يوما ما بلا شك، لتعود إلى ديارها. تنتهي الحكاية، التي تمثل فيها الذاكرة عقدة اللعبة السردية، بموت البطل الحاكي، فيتكلف السارد بملء فجوات الحكاية الأصل، إما انطلاقا من استرجاعاته أو من خياله، ويصير صوت السي يوسف هو صوت طنجة، بل هو صوت كل المغرب الذي «يمتلك كل رجل فيه رغبة تضاهي رغبات ثمانية أوربيين،» كما نقرأ في آخر جملة من الرواية.
قد تبدو حكاية السي يوسف هذه بسيطة. لكن قيمتها تكمن في كونها تسلط الضوء على بعض القضايا الحيوية التي تخترق أيضا روايته الثانية «فرصة ثانية في طنجة»، إذ تعكس شخوصها كينونة جوهرية مركبة تؤثثها فلسفة وجودية تصدر من طبيعة الإنسان الطنجي وشخصيته وعقليته، لكنها تقوم على تفاعل مباشر بين الذات ومحيطها، وعلى رؤية منفتحة إلى العالم، كما سنرى لاحقا. كما تتميز هذه الرواية، من الناحية الفنية، بنفسها السردي المركب الذي يجمع في الآن ذاته بين الحوار والتقنية السردية وحكاية البطل السي يوسف؛ وباختيارها الموفق الجمع بين الواقعي والتخييلي في لعبة سردية واحدة؛ وبتوظيفها الذاكرة، سواء في علاقتها بالتاريخ أو بالشخوص والأمكنة؛ وبوصفها خفة الشخصية الطنجية وبقدرتها على ترجمة لسانها المتفرد إلى اللغة الإنجليزية؛ وبجمعها بين الأساطير الإغريقية والمتوسطية والأفريقية والإسلامية في مكان واحد هي طنجة، بل في بؤرة واحدة هي مقهى العشاب.
لا تكتفي الرواية إذن بسرد مسار رجل طنجي عادي، ولا تتوخى فحسب إبراز تقنيات لعبة سردية مركبة سعيا إلى إظهار وجود نقلة نظرية في طرائق السرد الروائي. إنها تحتفي من خلال هذا الرجل العادي بالإنساني في مدينة عملاقة تشهد تحولات دائمة. لا تبدو طنجة في الرواية مجرد مدينة تتفاعل مع محيطها المتوسطي والأطلسي، كما تفعل غالب المدن الحدودية، بل هي قارة كاملة بأساطيرها الموغلة (هرقل) وشخصياتها العالمية (ابن بطوطة، محمد شكري) وامتداداتها التاريخية (الأندلسية أولا، ثم الدولية لاحقا). وهي أيضا طنجة التعدد الثقافي والديني واللغوي، طنجة الحرية والانتماء إلى الإنسانية، طنجة السياحة والإقامة والعبور… لم تتخلَّ المدينة عن هذه الفلسفة منذ أن استقبلت في زمن الأساطير مصارعيها وأبطالها الخرافيين الذين لا يقهرون. صارت طنجة، لاحقا، محطة عبور للغزاة الرومان والعرب والأوربيين نحو الشمال والجنوب. وستصبح طنجة ملاذا آمنا للهاربين من جحيم محاكم التفتيش والفارين من نيران حرب شنها «رجل نحيف ذو شارب مضحك أرعب العالم.» (ص. 110- 111). صارت منذ وقت مدينة الجواسيس والخطوط السياسية الحمراء، مدينة الفنادق والعلب الليلية والكازينوهات ودور العاهرات… هي ببساطة «منطقة حرة»، كما يقول سارد الرواية، منطقة «خارج منطق حياتنا حيث يندفع الرجال دخولا وخروجا، حاملين اللغز ذاته الذي حكم عليهم بحياة الهوامش والأطراف، لأسباب معقدة للغاية ظل فهمها مستعصيا على أي منا…» (ص. 20).
ويتبدى هذا المنحى الإنساني في الرواية من خلال تقمص شخصياتها الرئيسية نزعة إنسانية وإعلان انتمائها إلى أفق كوني وانتصارها للقيم الإنسانية. ورغم أن بطلها السي يوسف رجل متدين يعلن انتصاره الدائم لتعاليم الإسلام، إلا أن ذلك لم يحُل دون زواجه من إسبانية «نصرانية»، بل كان هذا التدين نفسه حافزا على التشبث بزوجته وإعلان الاعتراف بأفضالها عليه ورفض دعوات أبناء جلدته إلى الانفصال عنها، لأنها «ستمص دمه»، حتى إنه «طلق التاريخ»- في إشارة إلى مقهى النجمة- «ليظل مع زوجته.» (ص. 21). تتمتع شخصية السي يوسف بنزعة دينية صوفية روحية سمحة منفتحة على الأديان والعقائد المختلفة، رافضة لتعصب الجبليين وأفكار الإلحاد، ومسكونة بالمعرفة الميتافيزيقية والوجود في الآن ذاته، ومقبلة على الحوار الحضاري المعتدل مع أي كائن مختلف، ورافضة لمنطق الحرب في حل المشكلات، إلخ. تجمع هذه الشخصية بين أمل عارم في بلوغ خلاص أبدي، وبين الإقبال على الحياة، بما تعنيه من جهد في العمل وسياحة واستجمام وتمتع بملذات العيش. تستقي هذا المذهب الحياتي من إيمان عميق بأن الخلاص لا يكمن فحسب في ما يحيط بالإنسان، بل أيضا في ما يقع بعيدا عنه (ص. 83). وهي تتوق إلى تدريس هذا المذهب في المدارس والجامعات، بدل تدريس تاريخ الحروب والأوبئة والمجاعات وأزمات الدول (ص. 59). يتأسس هذا المذهب على فلسفة معاشة، قوامها الانتصار للإسلام بوصفه أفقا إنسانيا لا يخص المسلمين وحدهم، بل يهم الغربيين أنفسهم، وبوصفه ثقافة كونية تخلو من أي تراتبيات اجتماعية، سواء كانت إقطاعية أو أرستقراطية أو غيرها (ص. 97)، والإقبال على متع الحياة، كما سبق القول. يقول السارد هنا على لسان البطل السي يوسف: «اكتسبت حياتي معنى جديدا؛ صرت أكتشف المباهج. كنت في بداية عشرينياتي؛ كنت عاشقا؛ وكنت أكسب ما يكفي من المال لأدعم زوجتي وأمي (…). سافرنا إلى المدن المجاورة، إلى أصيلا وتطوان والعرائش (…). عبرنا المضيق إلى إسبانيا.» (ص. 97).
يتكشف هذا المنحى الإنساني الذي تريد الرواية أن تبرزه من خلال حضور الآخر الأوربي وأثر علاقته مع الذات. تشخص الرواية هذا الآخر من زاويتين: تحتفي الأولى بالعلاقة الإيجابية المتمثلة، من جهة أولى، في زواجه بـ’لوسيا’، وفي صداقته المثالية مع والدها أو مع مشغِّله الفرنسي ‘ساردون’، من جهة ثانية. لكن الزاوية الثانية تستدعي علاقة متوترة مع هذا الآخر الغربي، وتنتقد رؤيته السلبية إلى الذات وتقسيمه البشرية إلى صنفين: البيض وهم صنف «متفوق»، والآخرون وهم صنف «متخلف» يأبى التطور والانعتاق من «وحشيته» و»همجيته».
يتجسد هذا الموقف النقدي تجاه فاشي يدعى «خوان دياث» «يصف بلادنا بأنها سيرك بلا خيمة» ويقول إن المغاربة ليسوا سوى «حفنة من المزارعين المتخلفين المتعصبين للتقليد»، وإنهم «يفتقرون إلى متوسط مكونات النوع البشري المتطور.» (ص. 109) ومما لا شك فيه أن تشخيص هذا النقد روائيا، ينبثق من الاهتمامات الفكرية لمؤلف الرواية نفسه، بل بمقدور قارئ الرواية أن يرى في هذا الموقف البذرة الأساسية لأطروحات بعض كتبه، مثل كشف التقاليد: إسلام ما بعد الاستعمار في عالم متعدد المراكز والحرية والأرثوذوكسية والإسلام وأمريكا، وأن يفترض أنه يختصر القيم الإنسانية التي يؤمن بها الكاتب، وكذا رؤيته إلى عالم يوجد في حالة صراع دائم ومستمر. ضمن زاوية الرؤية المتوترة هذه تقع إشارة الحاكي العابرة إلى الصور النمطية للإسباني «بورقعة» الذي لم يستطع أبدا أن يتجاوز ما خلفه له الأندلسيون من حضارة بديعة، قبل أن ينبه السارد إلى عدم إساءة فهمه، لأنه يحب في الحقيقة هؤلاء «الإسبان الملاعين» (ص. 111).
وأخيرا، يتبدى هذا النزوع في الرواية من خلال تقابلات بين الحضارتين المغربية- الإسلامية والغربية الأوربية- الأمريكية، أو استحضار «صراع الحضارات»، أو تقاطعات البعدين المحلي والدولي في مدينة طنجة. ففي الصفحة 112، نجد السارد يتحدث عن شخصية الحاكي «الموزع بين ولائه المطلق للمرأة التي أحب وفخره بالثقافة التي أنتجته»، كما يعرض رؤيته النقدية إلى ما يسمى بـ»صراع الثقافات»، بوصفها «زوبعة» مدمرة جرفت منطق الإنسان الحديث وأدخلت شعوبا كثيرة في حروب ضارية وشردت الكثير من المواطنين وتركتهم معلقين في أرض مشاع (ص. 112). وضمن جدلية الصراع هذه صار الاحتلال الجديد يتساوى مع كل أشكال الاستعمار القديمة، وهي الجدلية نفسها التي جعلت المغاربة والإسبان ينساقون إلى المنطق ذاته. يقول السي يوسف للسارد هنا متسائلا: «ألم نمكث في إسبانيا طيلة قرون؟» (ص. 113)، كأنه يريد مشاطرة ما قاله السارد من قَبْل حول الحياد والنزاهة الفكرية تجاه أحداث التاريخ. في مقابل هذه الرؤية النقدية إلى العالم، يلفت السارد الانتباه إلى أن السي يوسف ظل يخلد أعياد الميلاد ويحتفل بالسنة الجديدة، رفقه زوجته ‘لوسيا’، خلافا له هو الذي كان ينظر إلى هذه الفترات من السنة بوصفها عطلا مدرسية وفرصا للعب كرة القدم ومناسبات لابتياع أفضل ما يتاح في السوق من بضائع. كما يحتفل بهذه المناسبات، على غرار السي يوسف، أغنياء البلد واليهود ووالمسؤولون الكبار، وتستقطب فنادق المدينة ونواديها الليلة المغنين الشعبيين من مختلف أرجاء البلد، فتتحول عروض رأس السنة إلى مهرجانات تتفوق على حفلات النصارى أنفسهم. سيكتشف السارد، مع مرور الوقت، أنه ما من حرج في أن يتأورب المغربي أو يتأمرك- «ألم يتشرقن الغرب أيضا؟ (…) يقول مؤرخوهم إنهم ظلوا طيلة قرون يقتبسون مهاراتنا ومعرفتنا. فما الخطأ في ذلك إذن؟» (ص. 137)
خلاصة القول، ليست رواية «السي يوسف» مجرد سرد سيري يريد تسليط الضوء على شخصية هامشية في المجتمع المغربي- الطنجي على وجه التخصيص، شخصية عاشت قدرا مختلفا حافلا بالأحداث والتقلبات، واختارت نمطا حياتيا وسلوكيا متفردا يتفاعل مع جميع الأقوام والعرقيات. بل هي سيرة روائية- فكرية تروم إبراز أن هذه الشخصية تحمل هموما وقضايا إنسانية تلتقي مع ما يمكن أن يفكر فيه أي مواطن يتحلى برؤية كونية إلى العالم ويحلم بالانتماء إلى الإنسانية، كما تلتقي مع الأفق الدولي الذي تعكسه مدينة طنجة، وكذا مع تاريخها الإنساني الطويل. قوام هذه الشخصية هوية جامعة لا تنسلخ عن ثقافتها المحلية، لكنها لا ترفض الانتماء إلى الإنسانية- مهما كانت قناعاتها العقائدية والفكرية- والانضمام إلى ‘القرية الكونية’، وهو ما سيفعله «لامين» لاحقا، سارد حكاية «‘السي يوسف’، وبطل رواية «فرصة ثانية في طنجة».
هامش
1 هذه القراءة هي الترجمة العربية لصيغة أصل ألقيت باللغة الإنجليزية خلال لقاء نظمه المركز الدولي لدراسات الفرجة وجامعة نيوإنغلند بمقر فرع هذه الأخيرة في طنجة يوم 18 مارس 2022.