عالم الاجتماع مصطفى محسن:«سردية» التاريخ الشخصي لتجربتي الفكرية
مصطفى محسن: عالم اجتماع، كاتب ومفكر عربي بارز من المغرب، خبير في قضايا التربية والثقافة والتنمية… في المغرب والوطن العربي بشكل عام…
تقلد، منذ تخرجه سنة 1972، عدة مهام تربوية وتكوينية وتدبيرية في حقل التربية والتعليم وتكوين الأطر…
اشتغل أستاذا باحثا «في سوسيولوجيا التربية والشغل والتنمية» بمركز التوجيه والتخطيط التربوي/الرباط، وأيضا أستاذا متعاونا مع بعض الكليات ومؤسسات تكوين الأطر التربوية العليا….
عضو مؤسس، أو مشارك في أنشطة عدة هيئات ومؤتمرات ومنظمات وطنية وإقليمية ودولية، حكومية وغير حكومية، مثل: الجمعية المغربية لعلم الاجتماع /المؤتمر التأسيسي للفضاء المغاربي/ المؤتمر القومي العربي…الخ.
له العديد من الدراسات والمقالات والحوارات والأبحاث والمؤلفات الفردية أو المشتركة. وهي أعمال ينطلق فيها كلها من هدف جعلها تأسيسية متميزة. وذلك حين يحاول إقامتها على ما يسميه بـ »منظور النقد المتعدد الأبعاد« بما هو مرجعية فكرية ومنهجية مؤطرة وموجهة لمشروع الباحث برمته، وبما هو أيضا نقد إبستمولوجي وسوسيولوجي وحضاري حواري وتكاملي منفتح للذات (النحن)، وللآخر (الغربي المغاير)، وللسياق الحضاري باعتباره لحظة تاريخية لتبادلهما وتفاعلهما على كافة الصعد والمستويات. غير أنه، إذ يؤكد على نوعية واستقلالية مشروعه الفكري هذا، فإنه يلح، في نفس الآن، على ضرورة النظر إليه في شرطيته السوسيوتاريخية الشمولية، أي على أنه جزء من كل، أي كأحد روافد حركة نقد عربي فكري وثقافي وحضاري معاصر أوسع وأكثر تمايزا في الأهداف والرهانات والخلفيات والرؤى والنماذج الإرشادية الموجهة… إلا أنها تسعى كلها إلى المساهمة الفاعلة المنتجة في التأسيس الجماعي لفكر عربي حداثي ديمقراطي حواري مؤصل، وإلى تشكيل وعي وثقافة جديدين، وإلى بناء إنسان جديد ومجتمع جدارة جديد…
في هذا الحوار تفاعل السوسيولوجي مصطفى محسن مع كل الأسئلة المطروحة-رغم ظروفه الصحية الصعبة- عن مساره في الفلسفة والتربية والسوسيولوجيا دراسة وتدريسا، وعن التضييق الذي طال شعبة السوسيولوجيا والفلسفة بعدها وتداعيات ذلك على مسار السوسيولوجيين المغاربة أنفسهم. وبوصفه مربيا وفاعلا مدنيا، تطرقنا معه إلى أدوار المجتمع المدني في إشاعة قيم المواطنة والسلوك المدني في الحياة المدرسية المغربية، وكيف يتصور بناء «مدرسة المستقبل» في تشكيل المواطن/الفرد. وإذا كانت هوية مصطفى محسن سوسيولوجية فإن له إنتاجا محترما في المسألتين التربوية والفلسفية. وما يؤطر خطابه، في كل هذا، هو مشروعه النقدي الحواري المنفتح المتعدد الأبعاد.
p كلمة أولى:
nn [سعيد جدا أن أستسمحك، أخي ذ. معطسيم، كي أشكرك جزيل الشكر، ومن خلالك جل أساتذة ومؤطري الفلسفة، بل ومجمل طلبة وباحثي العلوم الإنسانية والاجتماعية عامة، وذلك على احتضانهم التفاعلي والإنساني لأعمالي الفكرية المختلفة: قراءات وبحوثا واحتفاءات تقييمية وتكريمية متعددة الأنماط والأهداف والمستويات والمناسبات…وهو فعل ثقافي متحضر يستحق الكثير من الإشادة والامتنان والتثمين والاعتراف…
أما عن موضوع حوارنا هذا – والذي أشكرك، مرة أخرى، على اهتمامك به قيمة ومضامين…- فإني قد فهمت من خلال حديث سابق معك، أنك تريد أن تركز فيه على مساءلتي حول أبعاد ومكونات وأسس “النقد السوسيولوجي الحواري المنفتح التكاملي المتعدد الأبعاد”، ذاك الذي أجتهد في أن أتخذ منه “مرجعية إرشادية” موجهة، نظريا ومنهجيا، لما أنخرط في غماره من أعمال فكرية متعددة الإشكالات والمواضيع ومجالات التخصص والاشتغال.
غير أنني أود ألا يفوتني في هذه الكلمة المهادية الملمحة أن أسجل بهذا الشأن ملاحظة بالغة الأهمية، كما أرى. فمناقشة المنظور النقدي الآنف، الذي يشكل إحدى أهم الدعامات الرؤيوية المؤسسة لمجمل أعمالي، ليست سوى إجراء عملي ومنهجي للحديث في هذه المسألة النقدية، التي لا تنفصل في عمقها عن مضامين ما عالجته في هذه الأعمال من إشكاليات وقضايا…لذا فسأحاول، في إجاباتي المركزة على أسئلة هذا الحوار، ومتى سنحت لي الفرصة بذلك، أن أزاوج ما أمكن في حديثي بين توضيح وتحليل بعض إواليات وخلفيات وأغراض النقد المذكور، وبين ربط مقتضيات كل ذلك بالكثير من المضامين والتصورات المعرفية والمواقف التربوية والاجتماعية والسياسية والحضارية المباطنة لأعمالي بشكل عام، وذلك في إطار تصور جدلي دينامي تفاعلي للعلاقة بين نظرية ومنهج، وشكل ومحتوى، وخلفية ومضمون…مما ينتظر أن يظل في مجال الفكر، والكتابة بشكل أعم، متواشج التأثير والتأثر والفعل والانفعال…في حضن سيرورة عابرة للتخوم، لا تتوقف عن إنتاج وموالاة إنتاج ضروب متواترة من الدلالات والمعنى…ونامل أن يجد القارئ، في مظان هذا الحوار المتواضع المحدود، ما يقدم له على هذا المنحى بعض ما ينتظره من رؤى وفهوم ومعطيات وإبانات توضيحية متكاملة ومفيدة…واسمح لي، أخي ذ. محمد معطسيم، أن أخلص، بعد ما سبق، إلى محاولة تلمس الإجابة الممكنة على أسئلتك التي أنتظر طرحها علي، مكيفا هذه الإجابة وفق ما تقتضيه، في تقديري، بعض ضرورات “المحاورة” ، مما أتوقع أن يكون فيه بعض ما يخدم، ولو ضمن مواضعات وحدود،”مقصديات” وأهداف ومضامين هذه المحاورة الفكرية…]
p لقد اجتمعت في معظم أعمالك، أستاذ مصطفى محسن، جملة محتديات وحقول معرفية وتخصصات، أهمها التربية والفلسفة والسوسيولوجيا. لكن يبدو أن هذه الأخيرة هي اهتمامك الأساس، إذ تتشبت بها في سيرورات تحليلاتك النظرية والمنهجية ل”المسالة التربوية” في مدلولها الاجتماعي الشمولي، وبما تحيل إليه من مشكلات وأبعاد وأزمات، ومن أسئلة للإصلاح والتحديث والتجديد…كما تستنجد بها في مقاربة “الخطاب الفلسفي” في علاقته بالمؤسسة التربوية تحديدا،:(المدرسة والجامعة)، وبالسياق الثقافي والسياسي والاجتماعي المغربي والعربي بشكل عام، وصولا وامتدادا إلى تناولك النقدي للعديد من قضايا ومستحدثات العولمة وثقافتها وقيمها الجديدة، ولما يرتبط بذلك من أسئلة ورهانات التنوير والتنمية والديموقراطية والحداثة وآفاق التطور الحضاري في الوطن العربي…إلخ. فكيف تتساكن وتتفاعل في تكوينك الفكري وفي عملك ومنجزك السوسيولوجي النوعي هذه المكونات أو المجالات التخصصية الثلاثة بلا تنافر، وبنوع من التناغم الملحوظ في المفاهيم والأسلوب وأدوات الاشتغال…؟
nn لقد تعلمت، من تجربة علاقتي الضاربة في القدم مع غوايات وهموم وشواغل الكتابة والثقافة والفكر على العموم أن طبيعة هذه العلاقة لا تؤسسها عوامل معرفية محض، وإنما تتداخل في إنتاجها، نشأة وتطورا وتحديدا للتوجه والمسار، كما تتجادل في تحديد هويتها ورسم معالمها منظومة معقدة من البواعث والعناصر التربوية والثقافية والاجتماعية أو” الذاتية والموضوعية” المتباينة من حالة ثقافية فردية او جماعية إلى أخرى، بحيث يبدو المثقف او المفكر نفسه “منتوجا” مطبوعا بتفاعلات عميقة لهذه المقومات كلها. غير أن ذلك لا ينبغي ان يغيب عنا أن هناك من البشر-مثقفين كانوا أو غير ذلك- ممن ينخرطون في هذه الشروط، مستندين في ذلك على ما يسميه بعض الفلاسفة (ف. طونيس) ب «الإرادة المنفعلة” المتمثلة في الانسياق أو الانصياع التلقائي العفوي لهذه المقتضيات والظروف، وذلك دون جهد فعلي أو طموح عملي للفعل فيها وتحريكها باتجاه تحقيق أهداف معينة. بيد أن هناك عينات أخرى من الأفراد، ممن يتوفرون على حظ أوفى مما يدعوه (طونيس) نفسه ب “الإرادة الفاعلة”، أي مجموعة الاستعدادات والقابليات التي تجعل من بعضنا دون غيره قادرا على اهتبال بعض التغيرات أو الأحداث الموائمة في حياته، وعلى أن يجترح منها ما هو ممكن من فرص وآفاق لإقدار الذات والتوجه بها كي تكون فاعلة منتجة مؤثرة في عملها ولحظتها تطورا ومقاصد ومشاريع ومصائر مطلوبة محتملة…
وإن كنت لا أزعم امتلاكي لأي اقتدار على موضعة ذاتي ضمن الصنفين الآنفين: فإن مبرر استحضاري هنا للحيثيات الآنفة لا يتعدى تمهيدا-أرجو أن يكون ذا دلالة مفيدة- لما أروم أن يعرفه قراء هذا الحوار المقتضب من عناصر “سردية” التاريخ الشخصي لتجربتي الفكرية، وبالتالي لخلفيات اهتمامي بالمجالات التخصصية المذكورة فيما سلف، أقصد التربية والفلسفة والسوسيولوجيا. وأضيف إليها استكمالا لهذه الخلفيات الموجهة: الثقافة الفقهية وميدان الأدب والإبداع في مدلولهما الشمولي العام.
ربما كانت البداية الأولى لبروز وعيي العفوي بذاتي متمثلة فيما زلت أحمله في ذاكرتي البعيدة حتى الآن من صورة ضبابية الملامح لصبي في الثالثة أو الرابعة من عمره، وهو يقتعد حصيرا متهالكا في أحد كتاتيب مسقط راسي، مدينة آسفي. ومن يومها ظلت حياتي ترحالا دائما بين كتاب وآخر، قدر لي خلاله أن ألتحق في مستهل خمسينيات القرن الماضي بإحدى المدارس الابتدائية للحماية الفرنسية بقرية “جمعة سحيم”؛ ثم غادرتها بعد أيام معدودات لظروف صحية قاهرة. وقد استقر بي المقام بعد ذلك بمسقط رأس والدي بالبادية حيث نقل هناك لدواع مهنية. وفي كتاب دوار أولاد لحسن عباد بقبيلة “تمرة”، (حوالي 30 كلم شمال آسفي)، دام تمدرسي زهاء ست سنوات، تمكنت فيها من حفظ القرآن الكريم، والاحتفاء بختمي له “عريسا” موفور القيمة والاحترام.
وفي مستهل ستينيات القرن الآنف عدت وأسرتي إلى مدينتي، حيث التحقت ثانية بمدرسة عصرية هي “النهضة” التي كانت ذات توجه وطني وقومي على غرار غيرها من مدارس التعليم الوطني المعرب. وبعد سنوات قليلة أمضيتها بها تلميذا متفوقا، انتقلت إلى المدرسة الإعدادية الثانوية “الهداية الإسلامية”، التي أكملت فيها دراستي حتى حصولي، أواخر الستينيات، عل شهادة الباكالوريا. وذلك بعد مسار دراسي حافل بالكثير من التألق ومن “النكبات” الصحية المبرحة. غير أنني لم أبرح فيها أبدا موقع المرتبة الأولى، وأحيانا على مستوى المدينة كلها.
ولما ولجت الجامعة في أواخر العقد المذكور، لم يكن لي من بد أو خيار سوى الحقل التربوي. وهكذا التحقت ب “المدرسة العليا للأساتذة” بالرباط، الوضع القديم، وأيضا ب “كلية الآداب والعلوم الإنسانية، شعبة الفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع”. ذلك أني – وبفعل تنشئتي الثقافية والدينية من الكتاب إلى المدرسة، وبفضل ما مارسته طوال فترة تمدرسي كلها من دور مزدوج لمهنة المتعلم والمعلم المساعد لأساتذتي في آن…- لم أكن أتصور نفسي إلا كمدرس، أو على الأقل كمشتغل بقضايا التربية والتعليم والثقافة بشكل عام. فقد تمكنت التربية على امتداد رحلتي هذه من أن تسكن شغاف الفكر والروح، وأن تشكل مكونا أساسيا ضمن المكونات المحددة لهويتي أو شخصيتي، تلك التي تشربتها منذ صباي كطالب منذور فقط للعلم والتعلم والتعليم… ولعل في هذه الشذرات المتناثرة من “سردية” الذات بعض الإجابة، ولو بشكل عابر ضمني، على جانب من مقتضيات السؤال المطروح سابقا. فلم يكن اختياري للتربية كمجرد مهنة أو حرفة للاعتياش -وخاصة بالنسبة لثلة من حملة الباكلوريا من أبناء جيلي، كانت أمامهم فرص وإمكانات دراسية ومهنية مفتوحة بلا قيود كثيرة- وإنما كان الاختيار قد بلغ عندي زمنئذ درجة “العشق الموله العميق”، مما حفزني لاحقا على أن أتخذ من الميدان التربوي، بمفهومه الشامل- ولا سيما بعد تخرجي واشتغالي بمهنة التدريس- “سكنا فكريا وقيميا ومهنيا”، بل موضوعا جاذبا أثيرا للدراسة والتفكير والبحث والاشتغال… أما بالنسبة للفلسفة، فتعود بداية علاقتي بها إلى منتصف الستينيات الفارطة. ذلك أن نخبة مستنيرة مناضلة من أساتذتي في المرحلة الإعدادية كانت تمدني، تشجيعا لي ودعما لمواهبي الأدبية والثقافية، ببعض الكتب والدراسات المتنوعة. وقد عثرت ضمنها على بعض ما يرتبط بالفكر الفلسفي اليوناني القديم والغربي الحديث، وبالإنسانيات عامة. وهكذا تعرفت، بشكل أولي على أعلام من أمثال: جان جاك روسو، وجون ديوي، وسان سيمون، وأوجست كونت، ودوركايم، وسارتر، وألبير كامي، وأندري جيد…وغيرهم، فضلا عن مفكرين عرب من بينهم: الكندي، وابن سينا، والفارابي، والغزالي، وابن رشد، والعلامة ابن خلدون…، إضافة إلى أعلام عرب معاصرين مرموقين مثل: طه حسين، وسلامة موسى، وزكي نجيب محمود، وعلال الفاسي، ومحمد عزيز الحبابي…كي لا أذكر هنا -للتركيز- أسماء عديد من رجالات الثقافة والفكر والأدب والإبداع… إلا أن أوثق ارتباط لي بالفلسفة، بعد هذه المصادر الأولى لولادة تعرفي المبدئي عليها، قد كان مع ظهور أول مقرر عربي مغربي في مادة الفلسفة. ألا وهو كتاب “دروس في الفلسفة…” للأستاذ محمد عابد الجابري ومن معه. ولعلي لا أبالغ إذا أقررت بأن هذا المؤلف – نظرا لأسلوبه البيداغوجي، ولما يتسم به من وضوح وتناسق في الأطروحات والنظريات ونماذج التحليل والشرح والتفسير…- قد مارس علي قوة هائلة من الإدهاش والسحر والاجتذاب قل نظيرها. مما دفعني إلى الإقبال على التهام مضامينه بنهم يند عن الوصف. ومما حفزني كذلك على إنهاء مقرر الفلسفة بمجهود شخصي، وأنا لم أتجاوز بعد مستوى السنة الأولى من الطور الثاني الثانوي (أي الجذع المشترك حسب التسمية الجديدة). ولا ريب في أن ذلك كان من أهم دوافع اختياري الانتساب إلى شعبة (الفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع) على مستوى الجامعة. كي يتواصل اهتمامي وافتتاني بالفلسفة دراسة وتدريسا، ليتطور ذلك إلى مستوى البحث الأكاديمي الواسع المعمق…
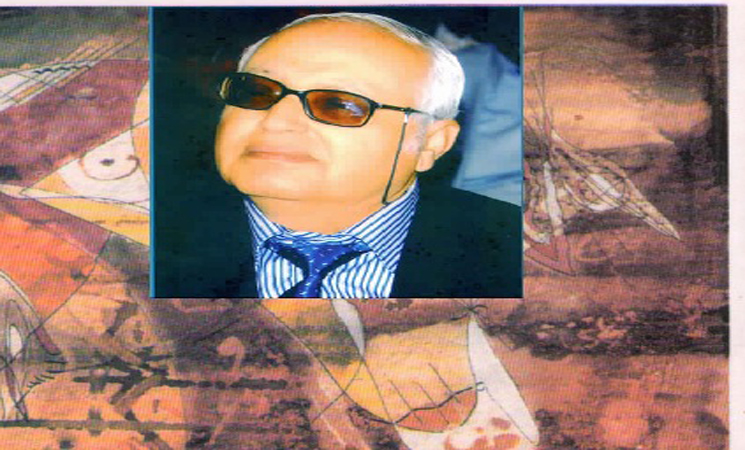





اترك تعليقاً