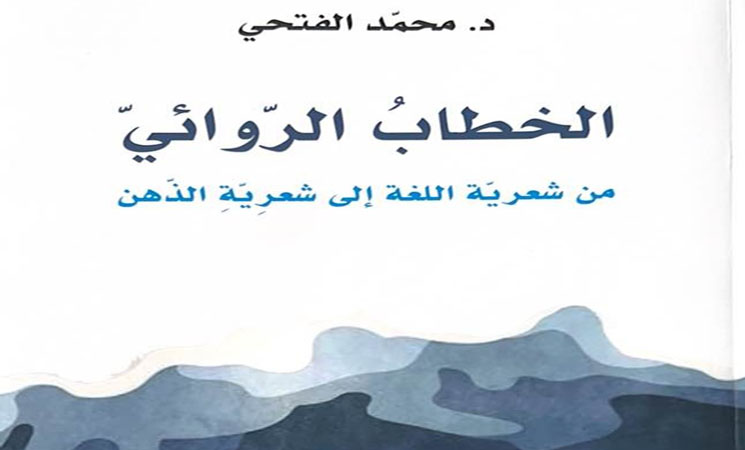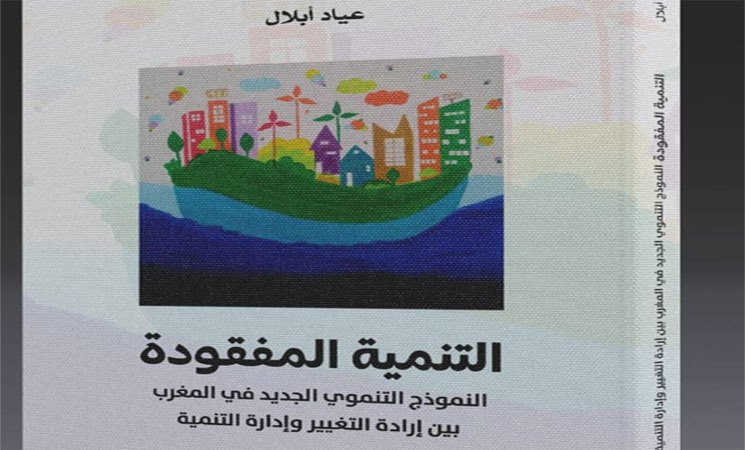إنها لمواجهة حقا، مرئية ولامرئية. مواجهة غير متكافئة بين وَعْل وفيل. وإنها لمنازلة لا كالمنازلات، منازلة ناعمة هادئة تحمل في طيها الوعيد بالمحو والإقبار. صراع جيل من النصوص المطبوعة، والأفكار المشبوحة ورقيا، ينذر بالأفول والرحيل وقد دبت الشيخوخة الظالمة في جذعه وأطرافه وأوصاله، بل وفي جذوره؛ وجيل من النصوص الترابطية الرقمية العابرة ضوئيا عبر الحواسيب العادية والمتخصصة، والهواتف الذكية، والمنصات والمواقع الإلكترونية، يتمدد ويتجدد كل حين، مفتول العضلات، قوي الشوكة والشكيمة. فكيف ينازل هذا ذاك، وما الضمانات لأن يفوزالأب وينهزم الابن؟ والحال أن سنة الحياة، وقانون التطور، وناموس البقاء هو للأصلح دائما.. للأقوى، لصلب الإرادة، لذي العزم والحيوية الفائقة كما رأى الفيلسوف نيتشه مستقطراً ذلك من تاريخ الفلسفة وتاريخ الأفكار، وأوجه التحولات والإبدالات التي عرفها القرن التاسع عشر، كما عرفها قبله وبعده القرون السابقة والموالية. غير أن الصراع بين الجيلين: بين الآباء والأبناء، ولا ضيرَ في توصيف الآلات والوسائل المادية والمخترعات بذلك. بين ما نحن عليه الآن، وما كنا عليه قبل الآن، لم يقضِ بصفة نهائية على أحدهما القضاء المبرم. ولئن كانت الثورة الرقمية ـ حاليا ـ في أوْجِها، فالثورة الطباعية التي عمرها ستة قرون، والكتاب المنسوخ والمستنسخ سابقا، لا يزالان يدافعان عن وجودهما بكل ما أوتيا من قوة وجدية، ونجاعة معرفية، ونوستالجيا رومانسية، وحنين حارق دوما وأبدا. إنها تعيش وتعتاش على الذكرى والماضي والأمجاد التي غيرت وجه التاريخ، ووجه العالم، فأسست ثقافات، وأعلت حضارات. فالنص المنقوش أو المكتوب الصمغي والحبري، الذي كان محتكرا من لدن أقلية « محظوظة «، اغتنت بوساطته، وغنمت الزرع والضرع في أحقاب متفاوتة ضمن دول وامبراطوريات، ولغات، وجغرافيات مترامية ومختلفة، سرعان ما تمرد على حبسه، وخرج ماردا ملعلعا من قمقمه بفضل يوهانس غوتنبرغ مخترع الطباعة الذي قطع بعمله ذاك، مع عهود الاحتكار والاحتقار، وأقبر نهائيا ما درج الناس عليه ـ الرعاع والسواد الأعظم منهم ـ من تقديس للمعرفة، واعتبارها شأنا باطنيا إلاهيا، وإلهاما علويا لا ينزل ولا ينثال إلا على الأصفياء ممن اصطفتهم عناية الآلهة، وبوأتهم، ومكنتهم من أن يحكموا ويأمروا، ويردعوا، ويستغلوا ما تنتجه أيادي « العبيد «، وما يتصبب من عرق جبينهم، ويفيض من سواعدهم. فانتشار النص الورقي قطع ـ إذاً ـ مع عهد بادَ، وسادَ عهد تنويري فتَّح أعين الفئات الشعبية على ما به تعمل وتنصب، وتفكر لتستحق وجودها، وإقامتها في الأرض. علماً أن النص الثقافي والفكري والإبداعي استمر صالونيا أقلويا، ولكن بشكل محا ما رُوّجَ قصدا وظلماً بأن العلم سماوي، ولا يفوز بغيثه ونعيمه إلا من اصطفاه الله، واختاره من بين عباده.
وها هو ذا النص الورقي إياه، يتهدده التقدم العلمي المَهُول، والتطور التكنولوجي العظيم، وتتوعده الثورة الرقمية بالويل والثبور، ودفعه إلى الدثور والقبور. فهو ـ إذاً ـ ينازل خصما عنيدا شرسا مدججا بضوء العلم والتقنيات، والرياضيات، واللوغاريتميات، والفيزياء وغيرها. خصما يطير بسرعة البرق بين القارات، والجغرافيات أنَّى كانت، وحيثما وُجدتْ، تكفي كبسة ( ماوْسْ ) ليحضر النص أو المعلومة الرقمية، بين يديك متفاعليْن متراسليْن مُزَنَّرَيْن بالصورة واللون، والموسيقا المرافقة، مثلما يحضر مارد جبار بحكة للفانوس من علاء الدين، أو بأمر من سليمان الملك / النبي. فكأن الشأنَ أسطوريٌّ، وما هو بالأسطوري، وما أجمل أن يتأسطر العلم، وينغمر بالسحر، ويتعزز بالتعازيم المُمَكْنَنَة، والبصمات المُمَهْنَنة، واللمسات الخفيفة الظريفة المُقَوْنَنَة.
لقد تسربت الثورة الرقمية إلى المكتبات العالمية منذ أكثر من عقد، وفي كثير من بلدان العالم المتقدم كمكتبة الكونغرس الأمريكية، بل والنامي كمكتبة الإسكندرية، والمكتبة الوطنية بالرباط، تمثيلا. وسكنت النصوص المرقمنة، المواقعَ والمنصات الإلكترونية بالإنترنت، لمد الجسور في ما بين ثقافات العالم، وتقليص الفروق العلمية والمعرفية ما أمكن. ويسمح النظام للمستخدم بربط أفلام الفيديو، والنصوص المصورة، والتعليقات، والخرائط، في وحدة سلسلة متكاملة، والبحث فيها من خلال عدد من المداخل المختلفة كالتاريخ والموقع الجغرافي، والموضوع، والوحدة، وما إلى ذلك. ولك أن تستشير محركات البحث مثل ( جوجول )، و( ياهو )، و( بايدو)، وغيرها، لتقف على العجيب والغريب، المتعدد والمتنوع من المعلومات والأفكار، والثقافة والأدب بكل أجناسه وأنواعه، والموسيقا والتشكيل والتاريخ .. الخ قديمة وحديثة ومعاصرة.
كما أن التحميل، تحميل الكتب والمقالات والمجلات، أصبح جاريا.. أصبح « فرض عين « بالنسبة للباحثين والأساتذة والطلبة والتلاميذ ( ات )، يلجأ إليها هؤلاء وأولئك، عوضا عن الشراء والاقتناء. كل هذا وغيره من تداعيات الثورة المعرفية على الكتاب الورقي، ومن عقابيل الرقميات الزاحفات المهيمنات على عقول وعيون المستخدمين في كل أنحاء الدنيا، صغارا وكباراً، إناثا وذكورا، صغُرَ شأنهم أم كبُرَ.
لكن، سيظل المغلوب ـ وهو هنا النص الورقي، الكتاب ـ حاضرا ماثلا ملء العين والقلب والفؤاد، غامرا منتشرا على رفوف المكتبات الكبرى الوطنية أو الجهوية، ومبسوطا يشع حكمة ووقاراً ومعرفة، على رفوف المكتبات المدرسية والمنزلية، قرير العين بما نسبغ عليه من مودة، وصون عهد، وتقدير واستشارة، وهو الجليس الأنيس كما وصفه أبو الطيب المتنبي. إذ لا يزال هو الدعامة الرئيسة للمعرفة علمية كانت أو إبداعية، أو ديداكتيكية، برغم رَكْنه ونسيانه وإهماله فترة قد تطول، بسبب الإلكترون والضوء، والانكباب على الشاشة الفضية والرمادية صباح ـ مساء. لا يزال يحتل المكانة الأسنى لكونه الأكثر قدرة على الاستمرارية، والأكبر احتضانا للمُثُل والقيم الإنسانية، والمبادئ الكونية.
لقد أصبحنا نعاين ـ كمربين وأساتذة ـ تهافت التلاميذ والطلبة إناثا وذكورا، على المواقع الإلكترونية المختلفة، واستمدادهم مما يقرأون ويطالعون ما به يستعينون على ما يكتبون ويدبجون، ويقدمون من أبحاث ونصوص محللة وغيرها. وإذا كان الأمر ـ في حد ذاته ـ مطلوبا ومرغوبا ومشكوراً، فينبغي التثبت مما نستقي بتنقية الشوائب، وما يعتري تلك النصوص من أخطاء لغوية، وهفوات فكرية ودلالية، بل بغربلتها والنظر إليها من حيث قيامُها بالمظنون فيها والمنتظر منها في نطاق الفكرة المحللة، والمعتمد عليها في دعم وتعضيد المبتغى من الرجوع إليها والمتح من متنها. ومن ثَمَّ، أمكن القول بأن القليلين فقط هم من يعرفون كيف يقرأون النصوص الرقمية، والكتاب الرقمي، لخدمة رأي، أو موقف، أو دعم فكرة هي ما يقف وراء المرام من تصفح موقع ما، ومن تحميل نص أو كتاب.
وإذاً، فقد شاعت الخفة والعجلة، وانعدم التحري والتمحيص في ما يقرأ القارئون، والمستخدمون للأنظمة الإلكترونية من نصوص وآراء، ووجهات نظر. وذاع توصيف الحَدَأَة وهي تنزل كالسم من عليائها، على الفريسة منقضةً عليها، ناتفةً في لمح البصر لريشها وأطرافها، وممزقة لطراوة لحمها وشحمها، هارسة عظامها الهشة؛ وكذلك يفعل المتعجلون الرقميون، حتى أن كثيرا من الأطاريح الجامعية التي يفترض فيها الجهد المضني، والاجتهاد العلمي المتبصر، والتؤدة والتأني، والبحث الدؤوب في تقليب المصادر والمراجع للتصفح والاغتذاء والاقتيات، خدمة للعلم فيها، ونجاعة مأتى التفكير المنهجي، والتحليل المدعوم، باتت تطرح ـ اليوم ـ وفي ظل الهجمة الإلكترونية الرقمية، والتحميل العشوائي، أكثر من سؤال حول قيمة الأطروحة إضافيا ومعرفيا، وحقيقة مجهودها العلمي الذاتي من زيفه، وصواب الدفاع عن جديتها وجديدها من باليها ومسروقه وخطله.
أخيرا، لا ينبغي أن يفهم من رأيي هذا، الانتصار للكتاب الورقي على الرقمي. فليس بيدي ذلك، وإنْ رُمْتُه، وصليت من أجله، ورحت أضرب في الأرض طولا وعرضا، داعيا إلى احتضان الأوراق، ونبذ الأرقام، وإلا رُميتُ بالحمق والجنون والجهالة، والعَمَى عما يقوم به الإنسان ويجترحه من إبداع وابتكار، وخَلْق، واختراع، وتحول وإبدال بما يؤكد سُنَّة الحياة، وقانون التبدل، وحتمية التطوروالتغيير.
لكن، سيبقى الكتاب الورقي برغم كل ذلك، في المدى المتوسط والمدى البعيد، لأنه حامل المعرفة والقيم والجمال، وعنوان النوستالجيا، والرومانسية الحالمة المحبوبة. وليس أدل على ذلك من إيلائه الاعتبار بتخصيص جوائز عالمية وعربية لفائدته مما يدحض زعم من يدعي فناءه وانتهاءه.
إشــــــارة:
إذا أنت زرتَ أوروبا، أو أمريكا، أو آسيا، ألفيتَ الناس وهم يعيشون في بلاد مصنعة متقدمة علميا وتكنولوجيا، يقرأون الكتاب الورقي حيثما حلوا وارتحلوا، وأينما وجدوا: في المقاهي، والبارات، والترامواي، والميترو، والحافلات، والمطارات، ومقصورات القطار، وفي المكتبات العمومية، والغابات، وحتى المقابر المَحوطَة رعاية وعناية ونظافة وتشجيرا ونباتا وأزهارا، وهم من هم تقدما وتطورا. ولقد دهشت وأنا في زَوْرَة لجزيرة سان ميشيل بفينيسيا، باحثا عن مدفنيْ العظيمين: جوزيف برودسكي، وإزرا باوند، من رؤيتي لأمريكية مسنة تقرأ كتابا بجوار قبر، والوقت غروب، والسماء رمادية تنذر بنزول المطر، والشهر نوفمبر، والعام 2017.