
رأى النور في أوائل عام 1959، بزنقة العباسيين (زنقة الحبشة سابقا)، التي تفصل كاريان ودرب كرلوطي بدرب السلطان. يتذكر أنه كان مشاغبا، وبأن مستواه الدراسي كان متوسطا. وفي ذلك الحي الشهير بالدارالبيضاء، عاش طفولته ومراهقته. ومثل جيله كان يعشق الموسيقى، وهي التي قادته إلى الكتابة، علما بأنه لم يحلم في تلك الفترة، بأنه سيصبح كاتبا في يوم ما.
بدأ لحسن أحمامة أولا، بكتابة قصائد شعرية باللغة الإنجليزية، بحكم التخصص في هذه اللغة، ولم ينشرها لعدم وجود جريدة أو مجلة تصدر في المغرب باللغة الإنجليزية في ذلك الوقت. وهذا ما دفعه للكتابة باللغة العربية، حيث نشر بعض القصائد الشعرية، لكن اهتمامه كان دائما ينصب على السرد، وهذا ما أفضى به إلى كتابة القصة القصيرة، حيث نشر بعض القصص، بمجموعة من المنابر الوطنية.
عندما كان يمارس الصحافة بدءا من سنة 1987، أجرى حوارا مع القاص والروائي محمد صوف. ومن خلال الأسئلة التي طرحها عليه، أجابه بأنه قد يكون ناقدا جيدا. عندئذ ومثل يقظة النائم، أدرك أن هذا هو مساره. هكذا تحول إلى الكتابة النقدية، وترجمة بعض الدراسات النقدية كذلك، وكلها نشرت بصحف ومجلات وطنية وعربية .
وارتباطا بولوج مترجم «التخييل القصصي : الشعرية المعاصرة» لعالم السلطة الرابعة، فتلك قصة تستحق أن تروى. ففي بداية النصف الثاني من الثمانينيات، كان قد عاد من فرنسا، حيث كان يتابع دراسته في السلك الثالث في الأدب الإنجليزي. ذهب إلى مقر جريدة السياسة الكويتية « طبعة المغرب»، بالدار البيضاء. وبعد اختبار في الترجمة تم قبوله فورا. ولم تكن لديه أية فكرة بالكل عن هذا العالم. عمل بقسم الترجمة لفترة قصيرة، ثم تم تحويله إلى القسم الثقافي، مع الشاعر السوداني «محجوب البيلي». بعد ذلك أسندت له الصفحة الثقافية، ثم الملحق الثقافي. كانت بالنسبة له تجربة جد مهمة في حياته، ربط خلالها صداقات مع العديد من الكتاب المغاربة. و بعد توقف الجريدة مع حرب الخليج، عمل مراسلا ثقافيا، ثم اشتغل في جريدتين وطنيتين أخريين، غير أنه أدرك أن الصحافة مهنة شاقة، تحد من الطاقة الإبداعية، وهذا ما جعله يلتحق بالمدرسة العليا للأساتذة، وبعد التخرج عمل أستاذا للغة الإنجليزية. وحتى الآن لايزال يكتب بعض المقالات الصحفية بين الفينة والأخرى، فمهنة الصحافة تظل لصيقة بصاحبها حتى وإن سعى إلى التخلص منها. ومن الذكريات المرتبطة بهذه المهنة، التي لا يمكن لكاتب : «القارئ و سياقات النص»، أن ينساها أبدا، زيارات العديد من الأدباء والمسرحيين، له بمقر جريدة «السياسة الكويتية»، من بينهم الراحل محمد زفزاف، الذي كان يكتب عمودا أسبوعيا بعنوان « الكلام المباح»، فتوطدت صداقة متينة بينهما، إذ أصبح يزور الكاتب الكبير، بين الفينة والأخرى ببيته بالمعاريف. مرة وجد عنده الناقد المصري صبري حافظ، ومرة أخرى التقى هناك بالصحفي عبدالقادر شبيه، وغالبا ما كان يجد عنده القاص، محمد بوحمام وغيره من الكتاب والفنانين. مرة طلب منه كاتب «الثعلب الذي يظهر ويختفي» أن يرافقه إلى إحدى الوكالات البنكية لاستخلاص راتبه الشهري، الذي يتقاضاه مقابل ذلك العمود الصحفي. طلب المستخدم من القاص والروائي الشهير بطاقته الوطنية، وسأله إن كان يعرف الكتابة، فأجاب هذا الأخير بالنفي. وبرر موقفه عندما أصبحا في الخارج بقوله «نحن الكتاب لا نعرف إلا بعضنا». لم يدرك أحمامة ذلك إلا بعد مدة طويلة، إذ ظل هذا الحادث عالقا بذهنه، وقرر أن يكتب عنه، ونشر المقال بجريدة الاتحاد الاشتراكي، تحت عنوان : «محمد زفزاف لا يعرف الكتابة». وكان وقتها كاتب «المرأة والوردة» المعني بالمقال، لايزال على قيد الحياة ويعاني من المرض .
لحسن أحمامة لا يعتبر نفسه مترجما، وإنما ناقدا أدبيا. لذلك هو لا يترجم إلا الكتب التي يستفيد منها كثيرا في ممارسته النقدية. فلم يثبت قط أن ترجم تحت الطلب. هذا عهد أخذه على نفسه منذ أن ركب غمار هذه التجربة. فكل الكتب التي قام بترجمتها، كانت قد استهوته، لدرجة أنه أحيانا كان يجد نفسه يقرأ النص الانجليزي، مباشرة باللغة العربية دون وعي منه، ومع ذلك يشعر بأنه لم يقدم كل ما رغب في ترجمته. ويعتبر ترجمة النقد أصعب بكثير من ترجمة السرد. فقد يتصرف مترجم السرد في النص الأصلي، لكن ذلك غير مسموح به في الدراسات النقدية، ولعل هذا ما جعل الكثير من الكتب النقدية مضللة، خصوصا بعض الترجمات المشرقية. أما في المغرب فالترجمة عموما جيدة، وهذه حقيقة لا يماري فيها أحد. ثم إن الترجمة، وإن كانت ممارسة شاقة، فهي ممتعة أيضا. بل إن الكتابة بشكل عام، هي نشاط ذهني وبحث عن الذات، وليست معاناة كما يدعي البعض.
أما النقد بالنسبة له، فهو إنصات إلى العمل الأدبي، وتحقيق حوار معه، وهو قبل كل شيء حكاية قراءة. هذه الحكاية يرغب دائما في تقاسمها مع القراء. إذ يعتبر أن الإبداع و النقد شغف ، وليس مهنة أساسها البحث عن الربح المادي أو الشهرة . فقد دخل هذا المجال عن حب وليس عن شيء آخر. هو من المؤمنين ، بأن أساس الإبداع هو الجمال ، والجمال هو ما يستوقفه ويستثيره للحديث عنه، إذ القراءة تنهض على التذوق قبل كل شيء . فكثيرا ما يتذوق نصا ويجد نفسه عاجزا عن الكتابة عنه ، مثلما أن هناك نصوصا يجد نفسه مضطرا فقط لاكتشافها. فالنص النقدي هو إبداع ثان على إبداع أول ، ثم إن الكتابة النقدية المبنية على المجاملات تسيء إلى المبدع، أكثر مما تسيء إلى الناقد ، و النص الإبداعي الجيد يفرض ذاته على الناقد.
راكم لحسن أحمامة طيلة مسيرته الإبداعية ، رصيدا هاما من الإصدارات الأدبية. ففي الترجمة له عشرْ كتب، وفي التأليف له أربعة كتب نقدية، إضافة إلى مساهمته القيمة في ثلاثة مؤلفات جماعية. وله من تأليفه كذلك رواية واحدة هي : « ذاكرة المرايا»، التي رأت النور في العام : 2014، عن منشورات اتحاد كتاب المغرب، والتي استغرقت كتابتها أربع سنوات، ثم ظلت حبيسة الحاسوب سنة أخرى قبل نشرها. وكان الهدف من كتابتها، هو الالتفات إلى ما اعتبرته جل النصوص الإبداعية، شيئا معيبا، أي الكتابة عن الذات وعن الحب، في حقبة طغى عليها الإيديولوجي، يعني بذلك سنوات السبعينيات من القرن الماضي. فكان عليه أن يستحضر تاريخ هذا الجيل الذي ينتمي إليه، بكل آلامه وآماله، ورغباته وأحلامه، ويكتب نيابة عنه. يتذكر أن أحد قراء « ذاكرة المرايا»، وهو من جيله، قال له في ما يشبه الهمس إنه كتب هذه الرواية عنه. مثلما قال له أحد الصحفيين، أنه رصد تجربته ومعاناته مع الصحافة. لقد كان صعبا الإفلات من الذات لحظة الكتابة، غير أن الجزء الأعظم من الرواية متخيل .
ومن مشاريعه الأدبية القادمة، رواية ثانية عنوانها “سمفونية فيفالدي”. تحكي من متقاعد مولع بقراءة الروايات، ويحاول كتابة رواية. إنها رواية عن الحب والموسيقى والتشكيل. من المتوقع أن تصدر عن دار النشر مقاربات بمدينة فاس، وكتابان مترجمان :
ما بعد الكولونيالية – دراسة في نقد الاستشراق تأليف الناقدة لِيلى غاندي ( حفيدة غاندي )
ميشيل فوكو، السلطة والجنس – حوارات – تأليف ميشيل فوكو.
الأول منهما، لم يحسم بعد مترجم : “ التاريخانية الجديدة والأدب “، في الدار التي ستتولى نشره، بينما الثاني صدر منتصف شهر شتنبر 2020، عن دار شهريار للنشر والتوزيع العراقية، لكنه لم يوزع بعد في المغرب ، بسبب ظروف جائحة كوفيد 19 “.
لا يقيد لحسن أحمامة نفسه بوقت محدد للقراءة. متى وجد الوقت يقرأ، وعادة ما يقرأ في المقهى، وفيها أيضا يكتب يوميا بدون استثناء، بين السابعة والتاسعة والنصف مساء. و يقرأ بالبيت بين الحادية عشرة ليلا والواحدة صباحا، الرواية في الغالب. ومن عادته أنه يقرأ ثلاثة كتب في نفس الوقت بلغات مختلفة، العربية والانجليزية والفرنسية، وفي مجالات مختلفة، مثلا يقرأ رواية وكتابا نقديا، وكتابا في العلوم الإنسانية .. و تبقى الكتابة بالنسبة إليه “حال وأحوال” – بالمعنى الصوفي – أحيانا يكون بصدد كتابة دراسة نقدية، وعندما تستعصي عليه، يتحول إلى الترجمة أو العكس، وهذا يأخذ منه وقتا لإتمام ما بدأه.
من هواياته التي يروح بها عن النفس، بعد ساعات من القراءة والكتابة، عزفه على آلة العود يوميا، لفترة قصيرة، لقطع شرقية ومغربية. وهو يرى أنه لا يشكل استثناء في ذلك، فالزجال ادريس بلعطار يعزف على الهجهوج، والشاعر والمترجم نورالدين ضرار يعزف كذلك على العود، كما أن الروائي نجيب محفوظ كان عازفا على آلة القانون، وإدوار سعيد كان عازفا على آلة البيانو. إن الموسيقى ضرورية للكاتب، فحين نتحدث عن الشعر، نتحدث عن الإيقاع، كما أن ميخائيل باختين يتحدث عن البوليفونية، التي هي في الأصل اصطلاح موسيقي .
درب السلطان الذي رأى فيه النور، هذا المبدع المتعدد، وإن لم يعد يقطن به الآن، فهو لا يزال يسكنه، رغم التحول المهول الذي شهده، ورغم إقبار العديد من المعالم. فقد تم هدم فندق البشير، وتحول إلى قيسارية، بات حي كريان كرلوطي ودرب كرلوطي سوقا لبيع الملابس والأحذية والعطور، وما إلى ذلك، علما أن العديد من الفنانين والرياضيين والمسرحيين، قد أقاموا بهذين الحيين. فعلى بعد أمتار من بيت لحسن أحمامة ، كانت عيادة طبيب الأسنان اليهودي ماكس بنشتريت، أحد مؤسسي الحزب الشيوعي المغربي. وخلفه كانت تقطن الممثلة المغربية نعيمة لمشرقي وأسرتها. وفي الجهة المقابلة بدرب كرلوطي كان منزل عازفة القانون عائشة سليمان شوقي، وبالقرب منها الحاجة الحمداوية، وبيت مصطفى شكري (بيتشو)، ومنزل البطل المغربي في سباق الدراجات امحمد بن احمد، وعلى مقربة من ذلك منزل القاصة الزهرة زيراوي والممثلة الشعيبية العذراوي، والمفكر سالم يفوت، وعازف الناي ادريس (الناياتي). كما عرف هذان الحيان دور سينما، مثل الشاوية والباهية وشهرزاد، ثم الأطلس والمامونية وموريطانيا .. منها ما تم هدمه، ومنها ما يبدو الآن خرابا مهجورا.
عاش مترجم “شعرية الفضاء الروائي”، في هذا الجو المليء بالفن و الثقافة. لائحة طويلة من الأسماء البارزة التي كانت بهذين الحيين : ابنيني وشيشة وعائد موهوب وخديجة جمال، دون الحديث عن الأحياء الأخرى التي يشملها درب السلطان، مثل درب الإسبان (سبليون)، حيث كان يقطن الراحل إبراهيم العلمي وعازف العود الراحل عمر الطنطاوي، والروائي احمد البكري السباعي، وبدرب بوشنتوف كان يسكن عبدالمجيد ظلمي والفنان محمد الحياني، واللائحة أطول مما يتصور المرء .
لحسن أحمامة – الذي يكاد يجزم بأن درب السلطان، لايضاهيه أي حي آخر بالدار البيضاء، من حيث عدد الأسماء البارزة التي خرجت من رحمه – نشر قبل أكثر من عشر سنوات مقالة بعنوان : “أبكيك يا دربي الحبيب”، على غرار رواية آلن بيتون : “أبكيك يا وطني الحبيب” رصد فيها تحولات هذين الحيين، ومن الذين استحسنوا فكرة هذا المقال الروائي : عبدالرحمن مجيد الربيعي، الذي قال في إحدى الجلسات برفقة القاص والمترجم العراقي علي القاسمي، إنه يتعين على الكتاب، أن يعيدوا بناء مثل هذه المعالم، كتابة.وهو ما لم يتحقق للأسف، لعدم التئام مثقفي درب السلطان للكتابة عنه، قد يكون مرد ذلك إلى هجرة العديد منهم إلى أحياء أو مدن أخرى.
* اعتمدت في صياغة هذا المقال،
على إجابات الناقد والمترجم “لحسن أحمامة”، خلال حواري معه الذي نشر بالملحق الثقافي لجريدة العلم بتاريخ يوم : الخميس 17 شتنبر 2020.
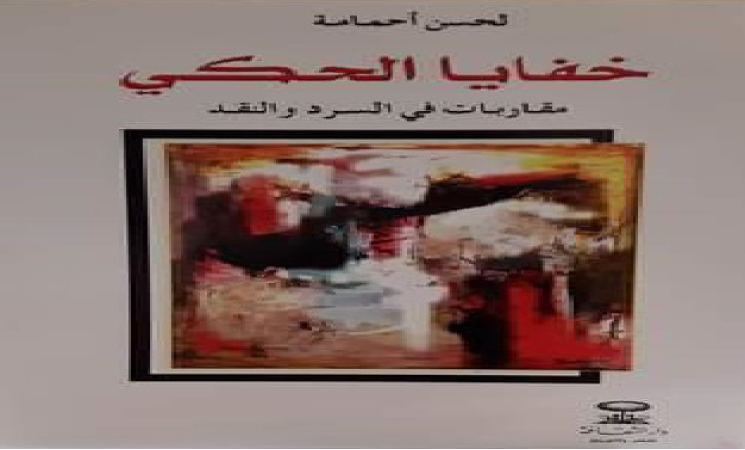






اترك تعليقاً