«في قبّعة غريغوري» منَ العجيب بمعنى المُدهش، ومِنَ الغريب بمعنى غير المألوف، ومِنَ المُخيفِ بمعنى الصّادم، ما يلفحُك كالهجير، وما يلسعُك لسع البرد القارص وأنت تسير في صحراء الوجود الفاقد للمعنى بين كُثبان الفوضى الكونيّة العارمة والمحلّيّة المقيتة، وأفاعي الظلم والخداع والحشرات المراوغة الزائغة واحتمال التّيه في سراب الغياب والتّهميش والتّغييب.
تسير بين كلّ تلك المخاطر دونما خريطة لكشف الألغام؛ ألغام المفاجأة السّرديّة الوامضة وشفراتها الحادّة الكاسرة لأفق الانتظار، وألغام المآسي التي تنفجر في وجهك ساخرة منك ومن ساردها ومن الوجود فتسحرك وتبهرك وتأسرك.
فكيف استطاع المتّقّي أن يحشو قبّعته بكلّ هذه العناصر المتعامدة، المتقاطعة، المتوازية لتُشكّل نصّا مُلغِزًا ممتعا رغم الكمّ الهائل من الألم الماثل فيها؟
منذ التّصدير يعلن المتّقي على لسان «فرانز كافكا» غايته «أحاول أن أنقل شيئا يتعذّر نقلُه، أن أشرح شيئا يتعذّر شرحه، أن أبوح بشيء لا أشعر به إلاّ في عظامي» .. فكيف يمكن لرجل يحمل في جوفه قلبين؛ واحد يتوق للتّواصل مع الآخر، وثانٍ يتحصّن بالهروب أن ينقل ما لا يُنقل وأن يشرح ما لا يُشرح وأن يبوح بما لا تشعر به إلاّ الذّات؟ تلك في تقديري أعظم مأساة تعشّش في ذهن السُّرّاد ومضانّ السّوارد في هذا السّرد الوميض المبشّر بالإبداع والغيث النّافع أدبا رغم الكمّ الهائل من الزّبد الذي يجب أن يذهب جُفاءً في هذا الواقع المرير.
غير أنّ المتّقي يُشهر قلمه سيفا بديعا تلتمع سنّه فتومض، فتخطّ ما يظلّ لامعّا برّاقا على الورق وإنْ كُتِب باللّون الأسود على صفحات بيضاء. فيودّ القارئ، كما عنترة، تقبيل سيوف المتقّي المُلْتَمِعَةِ على ثغور القصص الوامضة ومباسِمِها.وحين يهمُّ بالتّقبيل، تنقدح في ذهنه بوارقُ، وتخزه في الأعماق مهامزُ قُدّت من نار السؤال فيعيد التّفكير في كلّ ما يبدو عاديّا، بسيطا، سطحيّا ويسأل نفسه أسئلة تلبّست بصاحب الأثر وشخصياته المُشْكِلةِ.تلك الأسئلة التي تنبع من العادي الموغل في البساطة ممّا لم يُخطئْه في طفولته أيُّ واحد منّا من أبناء المجتمعات الريفية أو الحضرية المتواضعة، حين يُجمل المتّقِي محتويات قبّعته التي استعارها من «غريغوي» في القول:
«في البدء كنت طفلا، وكان ليل …
وسروال، وحكاية …
…………..
الطّفل نائم الآن، يعدو في الحكاية …
يضحك ..
يبكِي ..
ويقطُر من جبهته ماء الحكاية …»
ففي عمق كلّ واحد فينا ينام طفل، وفي ذاكرة هذا الطّفل الكهل أو الشّيخ ترقد ذكريات وذكريات ذات صلة باللّيل والحكايات وربّما بالسّروال الأوّل الذي يعي أنّه أشتُرِيَ له أو أحدَثَ فيه دون إرادة منه فعُوقِب أو سُخِر منه. غير أنّ المتّقي يعتمد العدول المعجمي بإتقان فيُخرج هذه الملفوظات من معانيها المعجمية الأصلية البسيطة وممّا ران عليها من ذكريات الطّفولة وبؤسِها أو سعادتها إلى سياقات جديدة ستكون حتما المادّة الخصبة المُخصّبة للقبّعة العجيبة. ففي كلّ «الققجات» المحشورة في قبّعة «غريغوري» بطريقة فوضويّة، اعتباطيّة، ظاهريا شيء من هذه الألفاظ الأربعة. فلا يكاد يخلو نصّ من هذا الطّفل الحالم أو الخائف، الآمل أو المتألّم أو المتوجّس كما لا يكاد يخلو من هذا اللّيل أو هذا السّواد المتّسِم بالفوضى والرّعب والخوف واحتمال العنف أو المجهول في أحسن الحالات. واللّيل عادة ما يستدعي الحكاية، حكاية من أفواه الجدّات. لكنّ المتّقي يستدعي السّروالَ بعد لفظة اللّيل مباشرة، السّروال بكلّ ما يوحي به من ستر ورغبة وشبق وربّما اغتصاب واحتمال الوسخ بمختلف معانيه وفي القبّعة من ذلك الكثير الكثير، لذلك تنزعه الجدّة حين تُصلّي: «جدّتي تُنهي تراويحها … وتلبس سروالها» . ومن اللّيل وسحره وما يشي به ظلامه من خوف وغموض، ومن السّروال بمختلف وظائفه الجمالية والإغرائية تتولّد الحكاية بكلّ ما فيها من غرائبي وعجائبي ومثير وجميل ورائع وممتع ومخيف. والقبّعة مكتظّة بكلّ هذه الأشياء. فنحن تقريبا داخل القبّعة نسير في غياهب شوارع المعاني التي تنشأ في ذهن كلّ واحد منّا عند قراءته لأيّ لفظ من هذه الألفاظ الأربعة التي تشدّ سقف المجموعة. فتُمطر رذاذا جميلا، وتقطر علينا أسى وألما، وتخنقنا برياح الفوضى وعتمة الضّباب النّاشئ عن الهواجس حتّى تكاد تدفننا تحت كُثبان رمال المآسي، وكلّ ذلك بفضل قدرة المتّقي الذي يحرّك عرائس شخصيّاته بخيوط من نُور لا تكاد تُرى. فتتحرّك أصابعُ القارئ أيضا ليُرقِصَ عرائسَه بما جاش في نفسه من قراءة المجموعة واستكشاف غيابات الجُبِّ الغميق لهذه القبّعة.
وكما ينام الطّفل بعد سماع الحكاية، فيركض فيه حالمًا أو يبكي فيه خائفا أو يتفصّد جبينه عرقا نتيجة كابوس مرعب، فإنّ القارئ أيضا يركض فرحا بعينيه على صفحات المجموعة ويجري طرِبا بما فيها من بديع السّبك ويبكي أحيانا أمام كمّ المآسي المُستعرضةِ وربّما يتفصّد جبينه عرقا من فرط ما يصوره المتّقي من أكل الأطراف، ودفن الإنسان لذاته والاصطدام بصخور الواقع التي تنكسر عليها أمواج الأحلام البسيطة القنوعة، وحجم الفوضى المرعبة وفظاعة الألم الذي يستشعره الإنسان الذي يقترف جرم التّفكير خارج النّسق السّائد للأفراد والجماعات فتنتابه الحيرة ويأتيه الألم من حيث لا يحتسب، وهو يعاقِرُ الأشياء البسيطة العاديّة التي عادة ما لا يأبه لها الناس، وكأنّنا بالمتّقي وأبطاله يُردّدون مع أبي القاسم الشّابِي:
والشقيُّ الشقّي مَنْ كانَ مثلِي ** في حساسيّتي ورقّة نفْسي.
كاتب وناقد – تونس
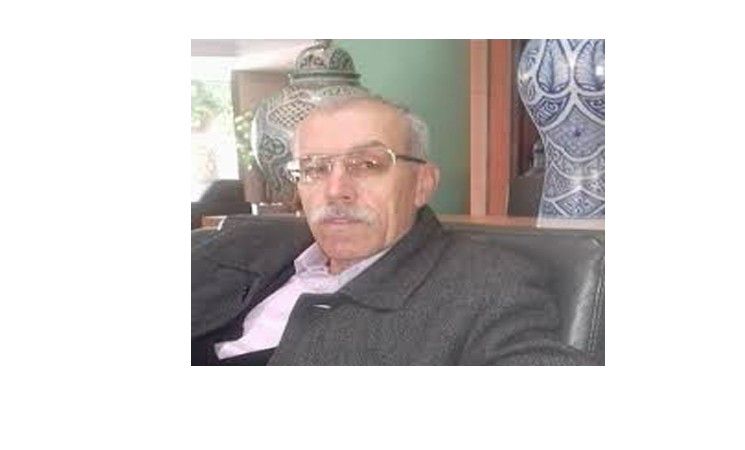






اترك تعليقاً