
هذه القراءة هي مصاحبة النديم، لا تتخندق في ما اعتاد دكاترة وأطباء النصوص تجريبه من نظريات ومناهج نقدية على جسد قصيدة عادة ما تصبح مضرجة بالدماء بعد كل عملية جراحية وقد تفقد بهجتها وروحها، وأعتقد أن الشعر الجيد لا يحفل بمراثي النقاد ولا بمدائحهم، يطردهم بعيدا كي لا يحولوا ورد الحياة في القصيدة إلى موائد للفجيعة والموت، لذا أعلن منذ البدء أنها مجرد مصاحبة لشاعر تعلم كيف ينغمس عميقا في متاهات الروح ويخرج غانما من العتمة، مضاء بسر داخلي يتفجر عبر لغة شفيفة، كما يجسدها ديوان «البستان» الذي أعتبره بمثابة ميلاد جديد للشاعر الرائي، لا الشاعر المبشر، من خلال لغة مكثفة تشير ولا تصرح، لغة أشبه بالصحو على درب السالكين والمشائين في الدروب المعتمة للروح، وإيقاع يحاول نقلنا نحو عوالم متخيلة تعيد خلق الكلمات والأشياء..
مع صدور ديوان «البستان» نحس أننا أمام امتلاك شاعر لأداته الفنية المصقولة ورؤيته العميقة، بما يشي بميلاد نوعي للشاعر عبد الكريم الطبال الذي راكم تجربة شعرية طويلة، فديوان «البستان» بهذا المعنى هو قطع مع الدعاوة السياسية والنزوع التبشيري، به يفتح الطبال انعطافا سيترسخ عميقا مع ما تليه من دواوين شعرية مكتملة البهاء، تامة البناء، أنيقة في صورها وإيقاعها، يقيم صاحبها حوارا يقيم على الحدود بين المرئي واللامرئي، الواقعي والمتخيل، تنقذ اللغة الشعرية من التكرار والنسخ، وتُخرج الحي من الميت وتزرع الحياة في قلب اللغة والطبيعة، لغة ذات نفس إشراقي..
في ديوان «البستان» سيصاب كل باحث عن مضمون أو محتوى ما بالخيبة، لأننا أمام نص أشبه ب»حبة البصل» على حد تعبير رولان بارث، حيث لا لب ولا شكل، لأن النص هو اللب وهو الشكل في آن، لذلك فأول ما يفاجئنا في نصوص «البستان» هو طبيعة اللغة الشعرية لعبد الكريم الطبال الذي اختار الإنصات إلى صوت عميق، رصف له الحلم طريقا وجعل من العالم المحيط به موضوعا للتأمل.. لغة شعرية تلتقط العالم بكافة الحواس:
«هذه الأعشاب.. كانت يوما
تتكلم عن الحب
تناغيني في القدمين
فأسقط في الحضن
تطوقني بالعطر
فأرشف خمر النهر
كانت تتلمس في جسدي: الجذع
وفي صوتي: الغصن»
حواس متيقظة تنقذ الكون من خموله، تبحث في البستان عما يشبه الإنسان في تمامه، العنفوان الآسر حيث الصمت وحده لا يدخل في الغياب، وفي «مرثية» نجد ذلك التناغم الأخّاذ بين الحب والفجيعة، بين الحياة والموت، تتقد كل الحواس لتنقل ما لا يرى، أو يخلق الغرابة في المؤتلف والمعتاد:
«لا أشم في عينيك الحلم
لا ألمس عطرك العنفوان
ولا يشتعل الصباح في أصابعك».
يسافر الشاعر في عالم مجهوله أكثر من معلومه، كرائي زاده الخيال، وفي الوقت الذي كان الشعر المغربي يحاول أن يخلق من الحرف جمرا مشتعلا ورصاصا لحروب الإيديولوجيا وصوتا مستعارا للدعاية السياسية، كان الطبال يبحث لقصيدته عن مجذوب وحضّار، وبلغة أرسطو عن مشّاء يبتهج بالمشي والنظر إلى ما لا يُرى في ما نرى، لسبر أغوار الروح، ولدينا فرقة صوفية سارت على نهج أرسطو، كان أفرادها يمشون وهم يتناقشون القضايا الكبرى للوجود، والطبال مشّاء بامتياز، يقول في إحدى تصريحاته: «حين أطبع الديوان لا أستريح، أمشي في الطريق وأنا أقرأ وأنا أكتب».
في «البستان» يظهر المكان والزمان كمجال لتجلي الكينونة، ليس هنا غير الذات/ الآخر/ الإنسان والطبيعة..
يقول:
ياسيدي
إني أريد أن أظل ها هنا
طبيعة في داخل الطبيعة (ص5)
و(تسكنني مدينة شريدة
بنهرها. والفجر والفضاء
في الليل
حين تزأر الرياح في وجوه الغرباء تنام في سرير الجسم. مثل طفلة
تحلم بالزنابق
وباختطاف نجمة فضية بعيدة) (ص41).
لغة الحدوس هي ما يصلح للمتاه، أخت طريق، سليلة الدهشة في حضرة الدوحة الشعرية.. «فالبذرة في الأعماق» (ص4)
«إن حدق في الشجرة
صعدت مشنقة
إن هم بلفظ البستان
يحترق الورد» (ص14)
لغة تنبض بقلب الذات الشاعرة ونبض الطبيعة التي ليست ها هنا موضوعا مستقلا، إنها مرتبطة بالفضاء (شفشاون وطن الشاعر وجنة خلده التي ما غادرها إلا إليها) تحفل بعبق الأندلس وماء الخصب.. الفضاء في «البستان»: «جنة»، «فردوس»، «عدن» و»بستان».. حيث يتعالق الصوفي بالرومانسي، بحث عن الغواية في قلب الحكمة وجاذبية غير المرئي والانصعاق بـ»ذات هشة بومض من شبح يشبه جسده القمر الغامض السابح هناك، وقد أغوص في بحر قصي علّني أرى في الأعماق صورة تشبه روحه النورانية الشفيفة فأثمل حتى الجنون» كما يقول الشاعر في سيرته الذاتية المعنونة بـ»فراشات هاربة» (منشورات اتحاد كتاب المغرب، الرباط – المغرب ط.1، 2007).
التوحد والتماهي في ديوان «البستان»
ميزتان أساسيتان في نصوص ديوان «البستان» وهما الدهشة والسلالة: لغة شفيفة تعكس بعد الدهشة وتمنح المجازات والاستعارات حوضا دلاليا جديدا، حياة أخرى تتهدم فيها تلك الأسوار الفاصلة بين الإنسان والطبيعة، وبين الذات الشاعرة والعالم، في تفاعل يعز نظيره سوى في النصوص الصوفية الباذخة.
لقد بسط فوكو بشكل مفصل المعاني الأربعة التي اكتساها السيمولاكر عبر تاريخ الثقافة الغربية، بينها ثلاثة تصورات تربط كلها السيمولاكر بالكذب، والزيف والخداع وتمثيل شيء واقعي حقيقي، مقابل الحقيقة والأصل والواقع الفعلي، ذات التصور الأفلاطوني عن المحاكاة في أسطورة الكهف، فيما يتحدد المعنى الرابع للسيمولاكر، في المعنى الذي منحه نيتشه الذي يدل على القدوم والظهور المتأني للذات وللآخر..( انظر عبد السلام بن عبد العالي في ص126-128 حول جيل دولوز: قلب الأفلاطونية)، حيث لا يدل السيمولاكر على النسخة الرديئة والمخادعة بل تصبح النسخة في مستوى الأصل، وتجعل قدومهما متآنيا، لا يفصل أحدهما عن الآخر فيقرن الشبيه بالشبيه والموضوع بنظيره.
في حديثة عن «هدم الأفلاطونية»، التي تميز بين النسخة والنموذج، الماهية والظواهر، الأصل والمثال، يعلي جيل دولوز من السيمولاكر.. في ديوان «البستان» يضعف الشبيه لصالح السيمولاكر كما في الشعر الصوفي، وحدة لا منوية فيها حيث الإنسان صورة الله.
على خلاف الشعراء الطبيعيين الأوائل حيث الطبيعة مرآة لعالمين متوازيين لا يلتقيان: عالم الإنسان وعالم الطبيعة، حيث يغدو البيان هو الاستعانة بعالم حسي وطبيعي لإنارة عالم غامض ومبهم هو عالم الإنسان.. أو لدى الشعراء الرومانسيين حيث الطبيعة تجسيد لعالم المثل، المحبة، الكمال والخير والفضيلة، مقابل عالم الإنسان المليء بالنقصان، الشر والقبح.. في شعر عبد الكريم الطبال تزول الحجب، تسقط ثنائية النموذج والنسخة، الأصل والمثال، لا محاكاة هنا..
إن البستان بوروده وأزهاره ليس نسخة عن جنة كما في الوعد الديني، ليس بديلا عن المدينة بصخبها وانصعاقاتها كما في الرومانسية، بل هو التجسيد الأسمى لحالة من الذوبان الكوني، الطبيعة ليست آخر أو مجرد خلفية تزيينية لفضاء الحركة وخزانا للصور، للبراءة الأولى أو مجرد مطية للتعبير عن انسحاقات الواقع، الطبيعة هنا ساحة للفعل وحيز للتأمل، مرآة التجلي الأسمى، البوح والنبوءة:
وحدي أنفرد بها في الخلوة
فتبوح بميقات الأدواح
وبأخبار البستان المعتل
الطبيعة الصائتة والصامتة كوجهي العملة الواحدة، ( ص5)
إني أريد أن أظل ها هنا
طبيعة في داخل الطبيعة، قصيدة يا سيدي
وفي قصيدة «البستان»، يحدث الاندماج حد التماهي بين الإنسان والطبيعة في ظل خلق متجدد، لا وجود لعالم المثال، هناك التوحد/ الوجود مرآة صافية/ المخلوقات ليست مثالا أو محاكاة لأصل:
هذه الأعشاب…
كانت تتلمس في جسدي: الجذع
وفي صوتي: الغصن
وفي سرحاتي: الظل
تكبر بي
تتعملق في مرآتي
لأن الشاعر وحده، على خلاف كل سراة الليل، يستنير بما لا يذروه عبث النسيان ويعرف حقيقة أن «البذرة في الأعماق»، بذرة الخلق..
حين يصبح الإيقاع حركة الداخل نحو الخارج
الإيقاع هو ما يعطي الهوية الأجناسية للقصيدة كما يؤكد هنري ميشونيك، باعتباره وشم ذات الشاعر في تعالقها مع العالم والطبيعة والزمن والتاريخ والنصوص. في ديوان «البستان» يحاول الإيقاع نقل الأشياء من واقعها العيني لتكتسي ملامح تخييلية، تنساب الصور والانزياحات مثل شلال ماء، في موسيقى صافية رقراقة، في وحدة نسيج يحاكي الدواخل، يرصد التوترات النفسية والوجودية.
الحالة الشعرية في نص «البستان» هي طريق صوفي يغوي نحو التوحد مع اللامرئي، عن لغة تلامس ماء الأشياء التي يسمع هديرها مثل شلال ينساب بين خلجان اللغة، رقراقة وصافية في وحدة نسيح يحاكي إيقاع الدواخل، يرصد التوترات النفسية والوجدانية للشاعر.. بحيث أؤكد أن هذا الديوان يعتبر نقطة انعطاف قوية من الرصد الخارجي للأشياء إلى الدخول في حالة وجدانية دون التفريط في البعد الغنائي الملازم لإبداعات الطبال الموالية، فيميل عبد الكريم الطبال منذ هذه التجربة إلى أن يمتح من لغة صوفية نورانية تقطع مع نماذجه السابقة وتخلق هويته الشعرية المتميزة.


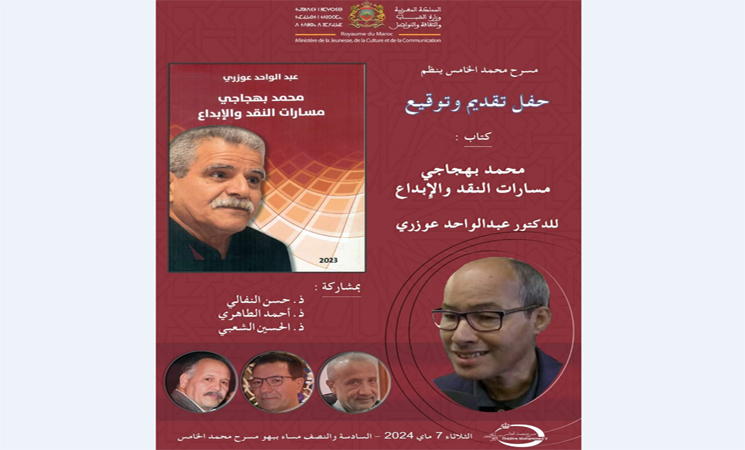
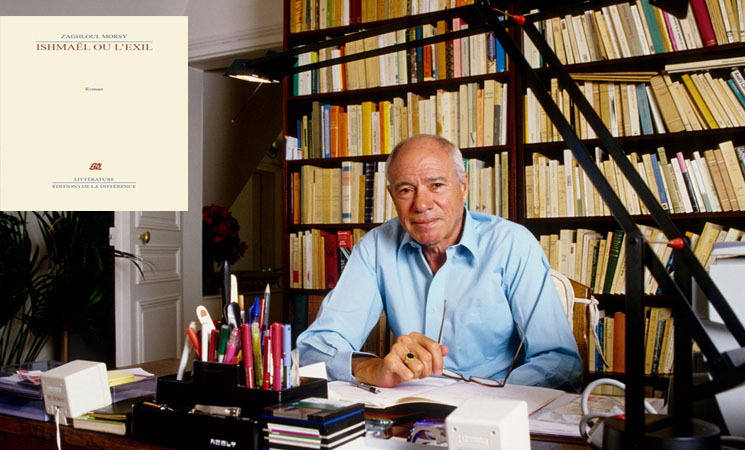


اترك تعليقاً