
بحس شاعري وبلغة شفيفة، يستمر الكاتب والإعلامي المغربي في إنتاجه المتعدد بين الأدب إبداعا ونقدا، والصحافة تنظيرا وممارسة، والسياسة تحليلا ومتابعة. في إصداره الجديد الموسوم ب»فتنة بذرة الجمال.. محاولات في مداعبات النص»، يقدم كوكاس قراءة مبهجة تذهب رأسا نحو ما كان يسميه القدامى ب»ماء النص»، وما يلح الكاتب على تسميته بذرة جمال النص الأدبي. في هذا الحوار/ المكاشفة حاولنا أن نمارس شغبا خاصا على هامش الإصدار النقدي للكاتب عبد العزيز كوكاس، فكان هذا الحوار الذي نتمنى لكم سفرا ممتعا في رحابه…
اللافت للانتباه هو عنوان الإصدار الجديد لك: «فتنة بذرة الجمال.. محاولات في مداعبة النص»، من أين أتى هذا العنوان ذي الملمح الشاعري؟
حين نكون أمام العتبات، علينا دوما أن نتعلم حسن الضيافة في حضرة النص الأدبي، المضياف والكريم، يقول القدامى: «قل لي كيف تسمي الأشياء، أقول لك من أنت»، من هنا جاء عنوان الكتاب النقدي الذي أصدرته حديثا «فتنة بذرة الجمال»، والقصد بالطبع هو البحث في شاعرية النصوص المعالجة، بغاية الكشف عن بذرة الجمال فيها، تلك الفتنة الجميلة التي هي أرق من القتل خارج البعد الأخلاقي، لأن النقد الأدبي الذي اعتمدته يمارس قراءة عاشقة على نصوص سكنتني وأمتعتني، وبعضها يعتبر علامة بارزة في الإبداع العربي أو المغربي.. من سليم بركات وجبران خليل جبران إلى عبد القادر الشاوي وعائشة البصري وعبد الكريم الطبال وغيرهم.. إنها نصوص تفرض علينا قراءة غير خطية، قراءة لا تقفز على المفاصل الحيوية للنص.. تلك تولد لدينا الرغبة في لغتنا الخاصة، في محاولة الكشف عن جزء من رؤيا العالم لدى المؤلف.
هل هو فرار من القراءة الأكاديمية والصرامة المنهجية، ودعوة للقراءة الانطباعية والاحتكام للذوق الفني أو ما سميته بالقراءة العاشقة؟
أولا أود أن أؤكد أن مفهوم القراءة العاشقة، يعود إلى الشاعر والناقد محمد بنيس، كي نرد الأشياء لأصحابها، وأنا أحد طلبته ممن افتتنوا بمفهوم «القراءة العاشقة»، أو ما سميته ب»مصاحبة النديم»، وهي لا تعني التخلي عن المناهج والمقاربات المستجلبة من فنون وعلوم إنسانية مجاورة للأدب، بدليل استشهادي بكبار من دعوا إلى تخليص القراءة النقدية من الانطباع والذوق بالمعنى التقليدي، وفي مقدمتهم تودوروف، رولان بارت وجوليا كريستيفا التي دعت إلى «علم النص».. إنني أهتم بمفهوم اللذة في قراءة النص، الذي يفسره بارث بكونه انتقالا من النقد إلى الرغبة في لغتنا الخاصة، مصاحبة النصوص ومداعبتها من الشقوق المواربة التي لا تُرى أحيانا، دون التخلي عن الصرامة المنهجية، وتعلم التواضع في حضرة النص المبهج. ما قمت به في كتاب «فتنة بذرة جمال النص»، هو مداعبة نصوص مغربية وعربية أقمت معها نوعا من الألفة، نصوص نشأت بيننا ما يشبه حكاية عشق، مارست فتنتها علي فوجدتني منجذبا إليها، لأنها فاجأتني بشكل بنائها واكتنازها لمعنى متحول، وأفق تجريبي مفتوح، ليس من باب الاستحداث والمغايرة وإنما من باب اختبار باب الغواية أي فتح مسارات جديدة للجميل والممتع. لقد كان علي كناقد أن أكشف عن سر فتنة بذرة جمال هذه النصوص ولكن من داخلها، أي من تلك المكونات الجمالية والبنيوية التي هي سر شاعريتها.. إنها قراءة بعيدة عن الانطباعات والحدوس، بل قراءة تمتلك كفاية منهجية، لكنها بعيدة عما يمارسه بعض من أسميتهم ب»دكاترة» أو «أطباء» النص الذين يعالجون النصوص بأدواتهم «التشريحية»- كم أنفر من هذه الكلمة الدموية- مغرمين بعدتهم وعتادهم المنهجي والنظري، لا بجمالية النصوص وفتنة بذرة الجمال التي تشمها، والتعميم هنا قاتل، ذلك أن قراءات نقدية رزينة عديدة لا تضحي بالنص لصالح المناهج والمفاهيم المستجلبة من حقول معرفية مجاورة للأدب، ستظل منارة بارزة في تاريخ النقد المغربي والعربي عموما.
في مفتتح كتابك النقدي الأخير تكلمت عن الكتابة النسائية والإخصاء الذكوري، وقد عابت عليك الشاعرة الكويتية سعاد الصباح، كما أتذكر في مقالها النقدي عدم متابعتك لإنتاجها الشعري، في الوقت الذي نوهت الكاتبة الجزائرية أحلام مستغانمي وكاتبات أخريات بجرأة تحليلك، ورأينا تغييرا في موقفك من المقال النقدي السابق إلى ما نشرته في كتاب «فتنة بذرة الجمال»، لم حدث ذلك؟
هذا المقال أو الدراسة إن شئت خلق الكثير من الجدل، وتلقيت الكثير من اللوم الشفهي، من طرف كتاب رغم أني أقدرهم لكني أعتبرهم أنهم لم يتخلصوا من بُعد هيمنة الذكورة، ورغم أن النص لا قضيب ولا فرج له، فإن العديد من الكاتبات النساء عانين من التهميش والإقصاء اللاشعوري أحيانا بسبب جنسهن لا جنس النصوص التي أبدعوا فيها، وكان مسعاي هو الانتصار لديمقراطية الإبداع لا التخندق في خانة «النسوية» أو «مقاربة الجندر»..
لقد انبرى بعض النقاد كما بينت في كتابي، إلى البحث عن الحمض النووي للعديد من الكتابات النسائية الباذخة التي تركت وشما في جسد الإبداع العربي عموما، من رواية «أيام معه» للشاعرة والروائية اللبنانية كولين خوري الصادرة عام 1959، والتي أرجع النقاد أمر كتابتها إلى نزار قباني حتى «ذاكرة جسد» لأحلام مستغانمي التي أسندت مرة لنزار قباني ومرة أخرى لسعدي يوسف، حتى وإن تبرأ الاثنان من ذلك، ثم سعاد الصباح التي حاول الكثيرون تجريدها من الإبداع وإسناد قصائدها لنزار قباني مرة أخرى.. ما حدث في حالة الشاعرة الكويتية سعاد الصباح في صيغة مقالي الأول، هو أنني اعتبرت أن هذا الهجوم الذكوري قد أخرس الشاعرة وجعلها تلوذ بالصمت… لذلك ردت الشاعرة الكويتية بشكل مهذب على مقالي، واعتذرتُ لها لأنها لم تتوقف فعلا عن الكتابة، لكن بحكم التداول المعطوب للإنتاج الأدبي والفكري في العالم العربي، لم أكن أتوصل بأي إنتاج للشاعرة سعاد الصباح، هذا البعد تداركته في كتابي «فتنة بذرة الجمال»..
ما كان يهمني أن يحظى مقالي بالتبجيل من طرف المناصرين أو التبخيس من طرف المعارضين، ذلك أنه كما يقول جاك دريدا: « كل حقيقة جوهرية تمضي دوما قدما، بغير حاجة إلى جمهور مؤيديها أو معارضيها».. لقد تقاسمت الكثير من الكاتبات والمبدعات العربيات هذا المقال بنوع من الابتهال، والحق أني لم أشأ الانتصار لقضية نسوية، بقدر ما وددت الدفاع عن مبدأ أساسي يتمثل في أن الإبداع لا جنس له، غير التصنيف الأجناسي المعروف، وأن الإبداع هو المميز للنص لا جنس صاحبه، لم يعد القلم/ القضيب أداة للكتابة، فنحن اليوم أمام لوحة المفاتيح والفأرة.. إن الأمر يتعلق بمخزون لاوعينا المتراكم الذي لم يتخلص من البعد الذكوري والهيمنة باسم الجنس.. وهذا يحتاج إلى أركيولوجية تاريخية لمعارفنا.
نلاحظ أن العديد من الكتب التي تناولتها ذات منحى تجريبي، وبعضها يمتح من المعجم الصوفي، من «بستان السيدة» لعبد القادر الشاوي إلى «نديم الطير» لمصطفى ادزيري، و»الكراطيط» لمحمد شويكة وإبداعات المصطفى غزلاني وسليم بركات… هل لهذا علاقة بالأفق المرجعي للناقد كوكاس؟
إذا قصدت التجربة الوجودية للتصوف.. لا أبدا لم أمر من التجربة الصوفية أو لم أهتد لأهل الطريقة بعد، ولكن إذا قصدت الملمح الصوفي الشاعري فنعم، ثمة تداخل مرده لتأثير شخصيتين: أولهما أدونيس الذي لفت انتباه جيلي لمواقف النفري من خلال المجلة التي كان يصدرها والتي تحمل اسم «مواقف»، فاكتشفت عبره ابن الفارض وابن عربي والحلاج وفريد العطار وجلال الدين الرومي… وثانيهما الشاعر الصديق مصطفى ادزيري، الذي يجاور مبنى ومعنى الزاوية البوتشيشية بقرية مداغ بالشرق المغربي، والذي اكتنزت خزانته جواهر الكتابات الصوفية التي أنارت لي الكثير من العتمات في التجربة الشعرية الباذخة للصوفيين، فعنوان رواية «بستان السيدة» يمتح من هذه المرجعية الصوفية، أما ديوان «نديم الطير» فهو من خلال عنوانه فقط يشير إلى كتاب الصوفي الفارسي فريد الدين العطار.. وهو ديوان شعري مبهر يتداخل فيه سحر السطر الشعري مع بهجة الرسم والخط، حيث ينبثق صراع بين البني والأزرق الذي يميل إلى الرمادي، أي بين الطيني والسماوي الذي يجسد صراع الناسوت للسمو والتوحد باللاهوت بهجة كماله، ويعتبر ديوان «البستان» لعبد الكريم الطبال علامة فارقة في شعر هذا الصوفي المشّاء الذي انتقل من اعتبار الكلمة سلاحا إلى اعتبارها عشقا وخمرة وحبا، حيث لا يقدم «البستان» كبديل لفردوس مفقود بل كرؤيا للجميل والممتع في قلب كينونة التشكل الشعري، كما أن الطبيعة ليست مكانا للهروب الرومانسي أو خلفية تزيينية، بل هي كنه وجودي عبره يعاد تشكيل الكلمات والأشياء..
أما بخصوص التجريب، فأعتقد أن كل الكتابات التي تبحث عن أفق مغاير ليس فقط للإبداعات المجايلة أو السابقة لها بل بما فيها كتابات المؤلف نفسه، تعتبر كتابة تجريبية، فأنا أنظر إلى التجريب بوصفه تأملا دائبا في التجربة الذاتية للمبدع بحثا عن أسلوبه الخاص، ذلك الحس النقدي الذي لا ينام على وسادة المألوف والمتوارث، ليس هوسا في البحث عن الجديد المغاير، أو ما يمكن أن نسميه بالاستحداث والمغايرة الشكلية وركوب موجات العصري والجديد، وإنما بحثا عن الملمح الشخصي والرؤيا الفلسفية العميقة والتقنيات المناسبة لتشكيلها فنيا في الإبداع.. فالتجريب كما ينظر له تودوروف هو «النص الأدبي الذي يحطم قواعده النوعية».
تحدثت بنفور عن أطباء ودكاترة النص، هل قصدت الباحثين الأكاديميين الذي يتعاملون بصرامة منهجية مع النصوص أم أصحاب الشهادات العليا الذي يقاربون النصوص وهم محكومون بالصرامة العلمية التي تفرضها المناهج والنظريات النقدية؟
(يضحك) هل تبحث لي عن جبهة حرب جديدة؟ سأحكي لك حكاية طريفة عن سياق هذه التسمية التي ابتدعتها، كانت هناك ندوة تكريمية للاحتفاء بشاعر كبير بمدينة بأطلس المغرب، استدعيت لها، ما لفت انتباهي هو تسميات المتدخلين المرسومة على اللوحات المنتصبة أمامهم، الدكتور فلان والدكتور علان، لا أحس بأي عقدة تجاه الأمر لكن حين انتهى الدكاترة من تقديم تحليلاتهم لبعض دواوين الشاعر المحتفى به، وجدت أن تلك النصوص قد فقدت بهجتها وماءها وزينتها وبذرة جمالها، مثل سيارة أنيقة أصيبت في حادثة سير بأضرار بالغة، لذلك قدمت مداخلتي بكون قراءتي هي مصاحبة النديم، لا تتخندق في ما اعتاد أطباء ودكاترة النص تجريبه من نظريات ومناهج نقدية على جسد قصيدة عادة ما تصبح مضرجة بالدماء بعد كل عملية جراحية، وقد تفقد بهجتها وروحها، وأعتقد أن الإبداع الجيد لا يحفل بمراثي النقاد ولا بمدائحهم، يطردهم بعيدا كي لا يحولوا ورد الحياة في القصيدة إلى موائد للفجيعة والموت، وأعلنت أن قراءتي هي نوع من المصاحبة.. أنا لست ضد المناهج النقدية والمقاربة المستندة إلى مناهج ومفاهيم مجاورة لحق الإبداع كما قلت في بداية هذا الحوار، فأنا خريج كلية الآداب والعلوم الإنسانية ومدين لأستاذة كبار، مبدعين ونقاد، في تكويني، لكن أخشى الصرامة «العلموية» التي تقتل بذرة جمال النص وفتنته.. لذلك تبهجني قراءات عبد الفتاح كيليطو وعبد السلام بنعبد العالي وغيرهما في الانتقال من المنهج إلى النص، من الصرامة العلمية للمفهوم النقدي إلى خصوبة النص الإبداعي المتجدد دوما، بالإضافة إلى التنوع في المقاربات والانسلال من الشقوق لإبراز المكنون الجمالي للنص الأدبي.


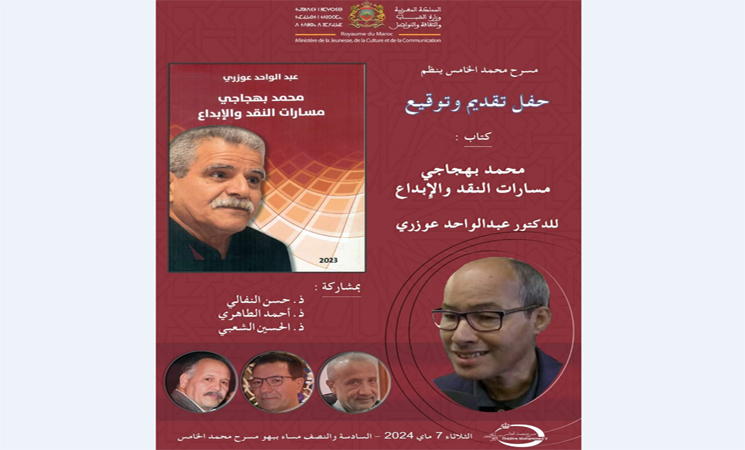
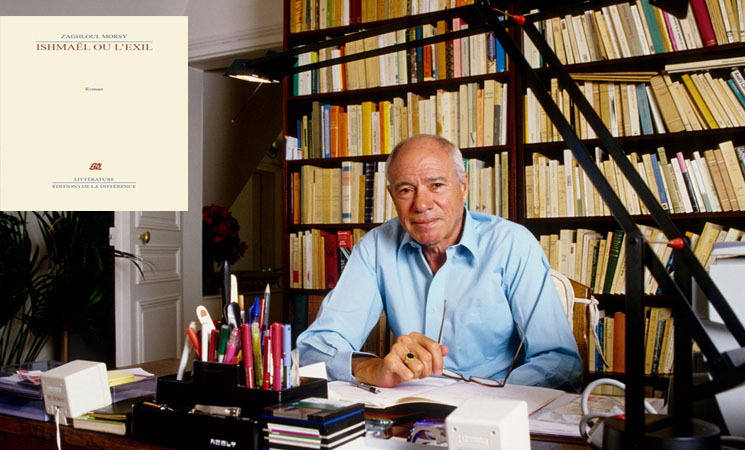


اترك تعليقاً