
ابن ماريا هو أول أصدقائي، وكان بيت عائلته يواجه بيتنا على الطرف الآخر من الطريق الصاعدة عبر زقاق درب الشُّهّب، بينا كان محمد اليتيم ، حفيد المرأة التي سمعناه يناديها بالعزيزة، وهي جدته، وهي التي كنا ننتظر جميعا عودتها مساءً من حقول لا ندري أكانت في جنوب البلدة أم في شرقها ، لنقف ثلاثتنا لنحييها، وهي تقود حمارها الذي كان يصعد وهو ينوء تحت بحمولة كبيرة من مختلف ما تجنيه على اختلاف المواسم، وتجعل شيئا منه على ظهره، وقد أمسكت بحبل وهي تتقدم في مشية رازحة تحت ثقل ما تحمل، ونهتف :
الله يعاون آلعزيزة
فقد كانت بالفعل جَدَّةَ صديقنا محمد اليتيم.
فتجيبنا بحرارة وفرح صادقين، وهي تتبسم رغم تعبها:
اللهم آمين يا أولادي …أرضاكم الله وحفظكم لوالديكم.
وما أن تمر بخطوات حتى نهرول في إثرها في احتراس من أن تشعر بنا ، لنقطف ما يتدلى من نَوْر وزَهر كان بين الأعشاب المخضرة التي تحمل منها على ظهرها ما فاض عن حمولة الحمار في حيوية رغم تعب آخر النهار، ثم نلوذ بباب أحد منازل الزقاق نحكي عن كل شيء حرمتنا منه أيام العواصف والأمطار التي كانت منعتنا من الخروج خلال أيام الشتاء الطويل الفارطة، مما يكون قد شهدته بلدتنا من جديد مثل امتلاء طرقاتنا وأزقتنا مؤخرًا بفوج من قدماء المحاربين ومعطوبي الحرب الأهلية الإسبانية، أو ما يكون قد جرى قريباً من حينا من محاولات سطو لصوص على بعض المنازل القريبة منه ، أو بعيدا مما يمكن أن يكون أحدنا قد شاهده في طريقه إلى السوق أو إلى مقابر ما فوق السّوق من مشاهد جنائز، أو مواكب دفن صغار اختطفهم الموت في أيامهم الأولى، سمعت من كان يقول عنهم إنهم سيبعثون طيورًا الجنة، لتشغل مشاهد القيامة وأهوالها والنجاح في عبور الصراط أو السقوط عنه إلى جهنم مباشرة، كما شغل جانباً من محكينا، ما كنا نخافه من وقوع في شراك جنيات وخوارق الأغوال الذي كنا نؤمن بوجود عوالمها التي تبدأ مع حلول الظلام ونشاط أهل الأرض الذين كانت لغة الكبار تكني عنهم ولا تصرح باسمهم ، لذلك كنا نخاف أيضًا كل ما يتراءى لنا في ظلام الخرائب وكل أرض خلاء، ونجمد من الخوف كذلك ونحن نسمع إلى عزيف أصوات الرياح في كل مكان التف شجره وعلا، أما إذا أعولت بومة أو نبحت كلاب في ظلام المقابر فمعنى ذلك إعلان عن موت ، وخروج أرواح من أجسام ناس وهي تصرخ بحيث لا يسمعها إلا من لا يتكلم من حيوانات وأجنَّة في أرحام،، أو حكايات شياطين كانت تشعل النار ليلًا في قبر مَّا ، كنا نُنْصح ألا نقف تجاهه ونحن نرنو إليه ببصرنا حتى لا ننجذب إليه فتبتلعنا تلك النار إلى أعمق قرار فيه، أو في الطريق إلى الكُتَّاب وما كان يشهده محلُّ ملحَق به يستعمل لحفظ أدوات دفن موتى الناس من معاول ورفوش ونعوش.
كما كانت تستغرقنا حكايات عما كنا نراه ونحن على الطريق إلى المدرسة، وما كانت تضج به من مشاهد الحياة اليومية من أعمال نجارين وحرفيين مختلفين، كان أحدهم يستخدم آلة تعمل بالكهرباء يعلو صوتها حتى يصل إلى أبعد مكان من محل النجارة ، أو أدخنة هذا الفرن أو ذاك، حين تسد الطريق في بدء إشعال النيران. أو مشاهد خرازين يكونون يستغرقهم يما بين أيدبهم من أحذية أو «طرابق « يتفننون في تلوينها وزخرفتها، أو ما كنا نسمعه من بعض الدرازة الذين كانت أماكن عملهم تضيق فلا تشمل إلا مرمى واحدة، أو تتسع لأكثر من ذلك.
***
كان الخوف من شبح الموت الأسود سببَ امتلاء حياتنا جميعًا، بكوابيس ومخاوف من فقدان من نحبهم، وكل ما يهاجمنا في النوم واليقظة صور الجحيم وهي تمور، ومواقف العذاب التي يمر بها الناس بعد القيامة التي لم تكن تعني عندنا غير فناء الحياة بلا طمع في النجاة. فكل ما في وجداننا شخصيات مختصة بتعذيب من يقع تحت أيديها، أنا صور النعيم فقد كانت غائبة عن متخيلنا غيابها عن واقعنا المحسوس، إذ لا يمر على الطريق العام أسفل زقاقنا إلا جنود الاحتلال، وحراس مغاربة في ثياب مدنية لكن بعيون نارية، تتابع كل صغيرة وكبيرة، فلم نر ظلًا من إله يمر أو ملائكة من نور. في واقع كان جحيماً وكل شخوصه كائنات من نار تتأجج آناء الليل وأطراف النهار. لذلك كنا في طفولتنا نلوذ بأحضان أهلنا مع اقتراب أقل خطر، أو قبل أن يجن الليل ، وتبسط دولة الظلام سلطانها على كل ما حولنا من مشاهد الحياة.
وفي جو تلك الاجتماعات البريئة قويت صداقتنا، فملاعب صبانا كانت لا تتجاوز أعلى الزقاق الذي كان كل عالمنا، فإذا نحن لم ندخل دار أحد الجيران، بحثنا ـ بينا كنا نلهو ـ عن منفذ، تصحبنا شمس النهار، في جدار في أقصى الزقاق، يفضي إلى المقبرة الشرقية التي كانت قد جعلت تضيق ، وبدأ كبار الحي يفكرون في بديل عنها، وفي زقاقنا كان أطفال آخرون ميّزوا أنفسهم عنا ، إما لفارق السن، أو لخلاف بين الأمهات ، أو لاعتبارات أخرى لنبقى نحن : أحمد ومحمد وسعيد إخوة وإن لم تلدنا أم واحدة.. كان محمد يتيما،حفيد المرأة التي كانت تعود بالحمار وحمولة الأعشاب مع غروب كل شمس، أما سعيد فكان والده يعمل حارساً بالسجن المدني، وكلاهما كان يسكن في دار تقطنها أكثر من أسرة، أما بيتنا الذي كان مكونا من أكثر من طابق وبغرف كثيرة فلم يكن يقيم به غير أسرتي. لذلك لم يمر إلا عام وبعض عام حتى أفقت ذات صباح لأسمع أن أسرة صديقي سعيد ابن ماريا قد انتقلت إلى مدينة بعيدة، فتشغلني عن اجتماعات الزقاق أجواء المدرسة المختلطة واختلاف وجوه تلاميذ بين ذكور أكبر سنا مني ، وفتيات حسان، وما يترتب عن علاقات هؤلاء وبعض الإناث من وقائع وحكايات، حتى نسيت ما كان من صديقي في زقاق الصبا.
لم أرَ صديقي سعيد إلا مع شبوب المراهق اليافع فيّ، واستطالة قامته هو واتساع صدره بشباب واضح الحيوية، لكن لا أحد منا تحرك لاحتضان الآخر ، أو حتى لتحيته، شيء ما عندي لم أفهمه حتى اللحظة، تنكري أنا لذكريات الماضي الذي اعتقدت أنه أصبح بعيداً. ربما لكوني كنت في القسم الأعلى قبل صديقي بعام أو عامين، لا لاختلاف في التكوين و الرؤى والانتماء، ولا حتى لاشتداد حَوَلٍ في عين صديقي لم يكن يثير اهتمامنا في طفولتنا الأولى، وإن اصبح مؤثرا في سلوكه من بعد، فلم أدر ماذا حطم ما كان نشأ بيننا من روابط بريئة في سنوات الغياب، قام مكانها حواجز ليس أقوى منها، حتى ونحن في نفس الثانوية، بل ونفس الداخلية التي كانت تؤوينا فيها حجرة نوم واسعة ممتدة تشمل ما يفوق مائة تلميذ، يستعملون نفس المرافق ،فقد ظللت على انصرافي عن أول صديق في حياتي ، لأنشغل بعقد صداقات مع أشخاص آخرين ، لم ألتق بهم إلا مع التحاقي في بداية العام الدراسي بالسلك الثاني من هذه الثانوية.
***
أما صديقي الثاني ، محمد اليتيم، فقد كان مسار حياته، مختلفًا، إذ ورث حمار جدته، واتخذه وسيلة لنقل الآجرّ والأتربة ، وبعض مواد البناء ، يحملها إلى جهات داخل الأزقة الملتوية الضيقة من مدينتنا القديمة، بمثل ما اتخذ سمة وقار أو احتشام، وهو يقطع أزقة المدينة في كل اتجاه ، إلى أن غاب كل منا عن الآخر.
***
في المدرسة المختلطة نشأت بين أطفال كنا نتجه في ذهابنا في مجموعات توحدها الطريق، فتعرفت على صديقي محمد الثاني الذي قام في إحدى المسرحيات بدور السلطان محمد الخامس مع مجموعة من التلميذات وتلاميذ المدرسة ، وكان محمد هذا يكبرني بحوالي أربعة أعوام، وقد ضمت المدرسة كتاكيت وديكا و كل ما استطيع استرجاعه من مواقف معه تدل على تقدمه في السن عني ، وتأخر خبرتي سواء ونحن نشاهد عبور جيش الإسبان بين أحياء من معسكراتهم ذات مرة، في مسيرة تدريبية، كان منهم من يمسك بلجام حصان أو بغل واحد، ومن يمسك باثنين في آن،فاعتقدت أن من يقود اثنين أعلى رتبة من صاحب اللجام الواحد، فسخر مني وهو يصحح لي أن الأقل رتبة هو الممسك بلجامين. ومرة ونحن في ملعب للكرة كان يقوم في المباراة بدور حارس المرمى ، وكنت أصيح عليه منبها إياه الا يقف إلى جانب العمود ويترك المرمى بلا حراسة ، فيصيح بي محتجاً :
!!!ـ أنا أتتبع حركة الكرة
كان محمد يشملني بعطفه، ويؤدي عني أحيانًا حتى ثمن الدخول إلى السينما، لكنه أحايين كان يتحايل ويتخذني وسيلة لرؤية الفتاة لطيفة التي كان متعلقاً بها.
وتعمقت صلاتنا إلى أقصى ما يمكن ان تصل بين تلميذين لما يتجاوزا مرحلة الابتدائي.
وقد كان محمد الثاني ممن اختارتهم لجنة الأساتذة لأداء بعض الأدوار في مسرحيات قدمها تلامذة المدرسة ذات عيد وطني. ما جعل منه نجمًا تفخر به مدرسة البنين والبنات التي كنا ننتمي إليها.
لكن حدث ذات يوم أن أفقت ، فلم أجده ،وفقد عرفت أن أباه الذي كان جنديًا، وتركه في حضانة أحد أخواله، رجع فاستعاده، لكنني لحداثة سني لم أفتقده ، وقد ابتلعتني دوامة أحداث فقدت معها كل شعور أو وعي بما يجري حولي في فترة بين آخر الطفولة وبداية المراهقة، لأفتح عيني بعد ذلك بسنوات وأنا أخطو في غفلة داخل أحد ممرات الحي الجامعي لأجده، وكأن ماضيّ كان زمن حشاش، أو شخص غارق في المخدر، وقد أوصله إليّ أحد رفاقي من مدينتي إلى الجامعة، لأسمعه وهو يقول له وهو يعرفه عليّ:
ها هو ذا صديقك القديم أحمد
ورغم أني تعرفت عليه من نظرتي الأولى، تظاهرت بانني لم أتذكر. فشملتنا نحن الثلاثة لحظة صمت، غير منتظرة ولا مفهومة، إذ كان رفيقي الذي دل صديقي القديم عليّ ينتظر أن أطير إليه فرحا، أو أن أهب إلى عناقه في شوق، لكنني مددت يدي ببرود قائلا:
على أية حال مرحبًا،
إنهما الآن معا في الدار الآخرة، انتقل إليها أولًا الرفيق الذي كان دليل صديقي القديم إليّ، بعد بضعة أعوام من ذلك اللقاء، واستمرت صداقتي بمحمد الثاني حوالي أربعين سنة بعد وفاة الصديق الذي جمعنا، ليفرقنا قدر الموت بعد أن اختلفت بيننا مدن العمل ومسارات الحياة وانتماءات الفكر والسياسة ، لكن ما لم أفهمه كان موقف التنكر لصديقي السعيد بن ماريا، الذي لم يكن قد مضى على فراقنا أكثر من أربع سنوات، وادعائي النسيان مع أقرب أصدقاء صباي من بعده: محمد الثاني الذي كان يصاحبني إلى داخل منزلنا حيث باركت صداقتنا المرحومة والدتي، التي كانت تتفاءل بمجرد النظر إلى وجهه المستبشر الضاحك دومًا ، مرحبة به كلما جاء إلى دعوتي إلى الخروج أو لإخباري بأي شيء.
***
وقد ظللت إلى عهد قريب، أيام كنت لا أزال أقيم في مدينتي البعيدة أرى صديقي محمد اليتيم، في جلبابه الصوف الأشهب، يسير وهو مطرقٌ رٍأسه وراء حماره، وفي يده قصفة من غصن شجر، يهوي بها في رفق،على ظهر حماره، وهو يقول في عصبية غير صادقة :
أرّرْرْ …زدْ … حيِّدْ بَالَكْ.
فأفهم ، وأحاول أن أنتبه، فأحِيدُ في خفة حركة، عن طريق حماره ، وأنا متيقن أنه لا يعنيني. ولم يكن ما يباعد ما بيننا شعوراً بتعالٍ أو كِبْـرٍ من أي نوع، فما زال داخلي الإحساس الدافئ نفسه الذي كان يجمعنا بعضا إلى بعض حيًّا في أعماقي، لكن ما لم أفهمه هو ذلك الصمت الذي قابلت به بعد فراق دون خصام سابق عودة أصدقائي الثلاثة ، كل على حِدَةٍ ، إلى الظهور، فجأةً بعد فجأةٍ، أمامي.


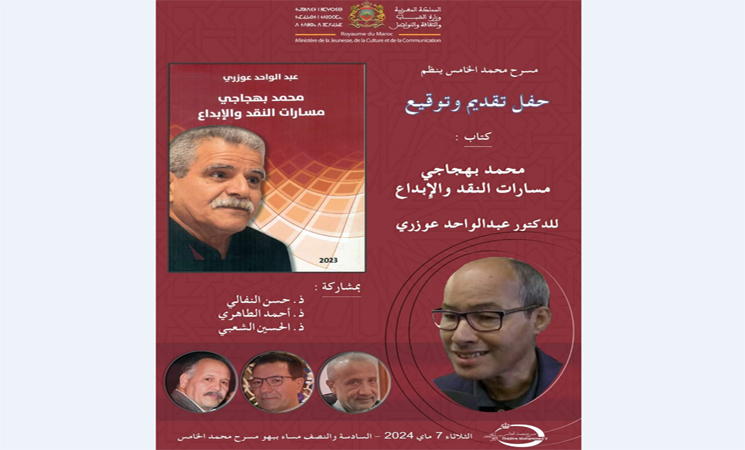
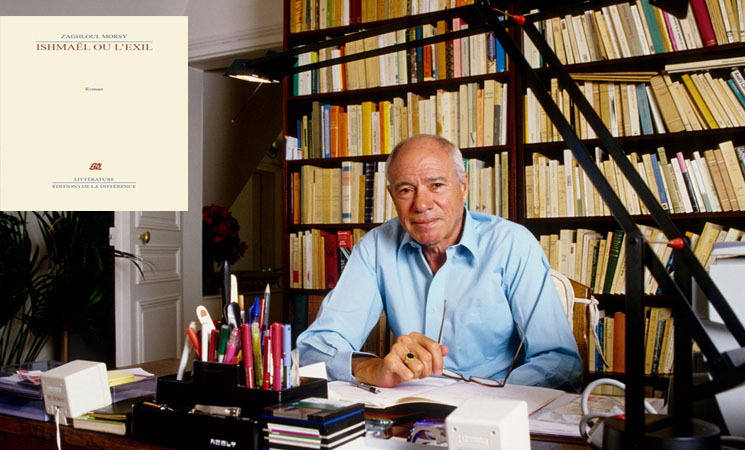


اترك تعليقاً