أَحْمِلُكِ كالعَتَّالِ على ظهري.. أحملكِ كَصُرَّةِ الغريبِ أوْ كَبُقْيا البقايا فوق رؤوس المُرَحَّلين والمُهَجَّرين واليتامى. لا ألتفت إلى الوراء حتى لا أبكي، وحتى لا أتحولَ إلى عمود ملحٍ تجرفه نظراتٌ حاميةٌ تنزلُ عليه كالحِمَمِ أو مثل شواظ من نار، فأصير إلى اندثار، وإلى هباء وغبار.
ومع ذلكَ، فالمنزل شاخصٌ شخوصَ الطفولة بِلاَمُبَالاَتها وشقاوتها ونعيمها.. إنه في البال والعين والقلب. قائم يُفَتِّتُ بْلاَزْمَا وخلايا دمي ذَرَّاتٍ ذراتٍ كما يفعل إزميل النحات بتكوينات الحجر، ويبعثر صور الذكرى مثلما كانت أمي تفعل بفرن الفحم الحجري في الأماسي الباردة، والصباحات المثلوجة الضبابية الرمادية والغبراء حيث تتجمد الأطرافُ، ويتكلس الخطو، ويتكسر المشيُ، وَتَزْرَقُّ العظامُ، وتَصْطَكُّ الظلالُ، وتَجْحَظ ُالعيونُ.
المنزل رقم 329، منزلنا: مَحْفُورُ في رُخامة الذكرى، ومنقوشٌ على قُماشة الأيام. صغيرٌ بلاَ نوافذَ، مُخَلَّعُ الأبواب، محشورٌ حشراً في خاصرة بعضِ المباني الدَّرْدَاءِ ذات الأسطحِ الفاغرةِ والمتهالكة، والميازيب الضاحكةِ الصاخبةِ في الأوقات الماطرة.
منزلٌ صغيرٌ تمسحه بالكف في وَمْضَة ثِقابٍ، وتقطعه بالخطو في رمشة عينٍ. دَفِيءٌ رحيمٌ – مع ذلك-. عُشٌّ وَقَوْقَعَةٌ آمنةٌ ومِرْوَحَةٌ، رَحىً دَوَّارَةٌ تجلب الماء والهواء في القيظ المستبد، والسَّوَادِ الطاغي الجبار.
كنتُ قُرَّادًا لصيقا بحيطانه أَمْتَصُّها وتَمْتَصُّني كما تفعل الحشرات الإبريَّةُ المجهريةُ الطفيليةُ بجلدِ وأجسام الدواب والأنعام.، أَسْتَفُّ جِيرَها وبياضَها الباهتَ المقشورَ، عليما بثقوبها، وشقوقها، وشروخها وأخاديدها، إذ مساحته لا تعدو مساحة زنزانة سجناء الحق العام. وأكاد – الآن- أعبرُه بالأشبار، وأصفه وصفا دقيقا كأنني مَا بَرَحْتُهُ لحظةً، وكأن العمر الممتد، والترحال بعيدا عنه، إلى قِبْلاَتٍ وجغرافيات أخرى، وسماءٍ ثانيةٍ وثالثةٍ ورابعةٍ، لم يعملا إلاَّ على تسطيع وتظهير حُضوره ناصعا بشكل لا يُصَدَّقُ، وعلى سَمْتٍ مدهش وغريب. وكما لو أنَّ الغيابَ حجابٌ أخفاه عن يد البِلَى والبطش، والتفتت والتحلل والاهتراء، وَحَمَاهُ من الضياع والتلاشي والاندثار مثلما يحمي الشوك الواخزُ الشَّرِسُ حقلا من الورد العائم في موج الألوان، ورغوة العبير.
لا أَتَذَكَّرُنِي مَاشيًا أبداً، أَتَذَكَّرُني دَوْمًا جاريا، وأحيانا حافيا، مُهَرْوِلاً سواءٌ في الحواري والدروب، والأزقة والأسواق، أو قاصدا مدرسة «ابن سينا» حيث الخوفُ والقَفْقَفَةُ يُعرِّشانِ في حضور المدير مَسْيُو «أنطونا»، ومواطنيه الفرنسيين الذين تتلمذتُ عليهم. مُهرولاً كأن شبحًا يَتَعَقَّبُني، أو «كرباج» أبي الأسود الغليظ المفتولَ وَالمُوجِعَ، يتوعدني. أوْ صرخاتِ أمي، وتوسلاتها متوددةً إليَّ، وزاعقةً في وجهي، حَاثَّةً إيايَ على الدرس والتحصيل، أو كما لو كنتُ على موعد غرامي، أو لقاء «مخملي».. يا للمخمل الخيالي اللذيذ والبعيد ..اا.
مُهَرْوِلاُ.. مهووسا بجماعة العفاريت النفاريت: أتْرَابي وَصَحْبي في الحارات، ساعين إلى سرقة ثريات العنب، وَ» لَمْباتِ» البرتقال من حدائق الفرنسيين، والمهندسين، و» الشّيفانْ»؛ والأجبانِ التي كنت أجهل تسمياتها، من محلات براقة متلألئة أُعِدَّتْ للإفرنج، ومهندسي مناجم الفحم، ومستغلي جهد وعرق العمال. ويا كمْ أتْعَبْنا المرحومَ سي عبد الجبار الفيكيكي، وراوغناه للانقضاض على ثمين الجبن، ولذيذِ الزبدة الملفوفة في كاغد بَرَّاق مذهب، والكاسات الغامزة بمحتواها من الحليب، واللبن، والرائب.
وكان لي ـ مع جمال الفرنسيات، وإن شئتَ الدقة، مع بياضهن، وتناسق أجسادهن، وعطورهن الفاغمات، وثيابهن العاطرات الخافقات في الريح، والهواء، والهوى ـ ألفُ رقصةٍ وَسُؤْلٍ وحيرةٍ وتَلَمُّظٍ وارتباك. ولازلت متأثرا بتلك اللحظاتِ النفسيةِ الرهيبةِ التي تنزل عميقا إلى مهاوي وجداني كطفل، وجذوري كتلميذ أشعتَ وأجْعَدَ يُجَرِّرُ شقاوتَه على قَصَبٍ مُقْتَلَعٍ من وادٍ غيرِ ذي زرعٍ، وَضَرْعٍ ناشفٍ منقوعٍ في الحرمان والأحزان. وكيف لي، وأَنَّى لي أنْ أنسى ثلجَ / ثلوجَ المرارات.. وأمي الحميراءَ الضئيلةَ تحملني كسنجابٍ على كتفيها الضامرتين، وَتَغُذُّ الخطوَ بي راكضةً نحو مَشْفى الأهالي حيث أُعَالَجُ من دَرَنٍ طَقْطَقَ في الرئتين، أَدْنَاني من موتٍ محقق ومحوٍ أبدي، وتذَرُّرٍ لا التئامَ بعده، ولا نشوراً؟
فضلُ حياتي الفائضةِ هذهِ، واحدٌ من أفضال أمي التي أَسْمَيْتُها مليكةً مالِكةً في قصائدي. وبعضُ أفضالها: سلسلةُ تحديات كانت مَدْعاةً إلى الدراسة، وحافزاً على التحصيل حيث تألقتُ، وَشَعَّ نجمي في الطفولة وبداية الصبا والشباب ببلدتي. ألمْ أكنْ أحصد الجوائزَ تلو الجوائزِ في كل المواد من الرياضيات التي لم أَعُدْ أَفْقَهُ فيها شيئا، إلى اللغة التي ارتضيتها ملاذًا ومُلْهِمَة ومعشوقةً، وذريعةً إلى البوح والكلام، ومن ثَمَّ، إلى الكينونة والكيْنَنَة، وتثبيت الوجود والإيجاد بتعبير الفلاسفة؟
بهذا المعنى، يكون الشعر الذي أَرْتَضِيه سبيلا إلى البوح والكشف، والعري، والموقف، ومَسِيرًا عبر الدغل الكثيف، والأحجار المُسَنَّنة، والشواخص القاطعة، سعيا إلى إحقاق ما أراه حقا، وعطشا إلى الينبوع البارد الذي يُطْفيء غُلَّتي، ويملؤني بالحياة، وطريقا لاحِبًا نحو استعلان الأنا، والذات، والدلالة التي أُرِيدَ لها أن تُطْحَنَ، وتصبحَ فَتِيتًا في غمرة الوَجَل والمرض والفقر المفروض.
في دخيلة هذا الشعر، تترقرقُ جرادةُ فَاحِمَةً لاَحِمَةً وَمُعَرَّاةً، وَتَتَلأْلَأُ الفرنسياتُ مُلَفَّعاتٍ بالبَضاضَة والوَضاءةِ، والبهاء، والجمال، ومُعَفَّرَاتٍ « في الخيال» بأثرِ الفَرَاشِ، ودم العَلَقِ، وخرافةِ العربي الفحل المُخْتَرِقِ، وما هُو بالمُخْتَرِقِ، بل مُخْتَرَقٌ منذ الأزل وإلى يوم الدين !
وفي تضاعيفِ هاتيكَ النصوصِ الشعريةِ التي أمْتَحُها من طفولتي بجرادة ـ كما لا أحتاج إلى تبيين- يرتفع نشيد التمجيدِ.. تمجيدِ العمال الذين بنوا صَرْحَ المدينةِ، وعَجيزاتِ اللصوص، ثم ماتوا في عز شبابهم وقد خلفوا أراملَ ويتامى انتهوا إلى التسول، والضياع، والمذلة، والمسكنة، بعد أن سُدَّتْ في وجوههم أبواب الرحمة، وكُشِّرَتْ فيهم نيوب الجحود والنكران.
من دمائهم، وعرقهم المخلوط بالفحم، وسُعالهم الذي كان يَرُجُّ جدرانَ البيوت، وسَمْعَ الليالي، وغَلَسَ الصَّبَاحَاتِ الكليلةِ، اسْتَمْدَدْنَا الحياةَ، وواصلنا العملَ، وأمكنَ أن يكون الكيان. دَمُ أبي ودِمَاهُمْ.. قناديلُ قرأنا في ضوئها، و تسامرنا، وضحكنا ثم بكينا، وعقدتُ/ عَقَدْنَا العزم على أن نكونَ.
هي أمشاجٌ من طفولة بعيدة – قريبة، غائبة / حاضرة، باهتة ومتوهجة، شقية وغنية، فقيرة لكن مكابرةً وكريمة، أثيرةً ونفيسةً كالأَلْماسِ. غير أنَّ المبدعَ بَرَّاحٌ ينشرها في العالمين، لعله يَبْصِمُ ويُكَرِّسُ بها وجوداً أَصَرَّ أعداءُ الحياة على تغييبه ومحوه، ودَكِّه دَكّاً. وأصر هو بمكره الخَلاَّق، وصبره الأسطوري، وعِناده القُطْرُبي، على إعلانه وتدوينه، وخَلْقِه ليصيرَ موجودا في الوجود، ويصيروا وجودا معدوما، ومسخا زائلا ومذموما.
وها هي ذي إحدى قصائدي تختزلُ حياةً صغيرةً عامرةً بالطيش الجميل، والوجود الحر:
أَسْمَعُ ..
نبضات: حديثُ الطائرِ المَقْفوصِ

الكاتب : محمد بودويك
بتاريخ : 02/04/2021

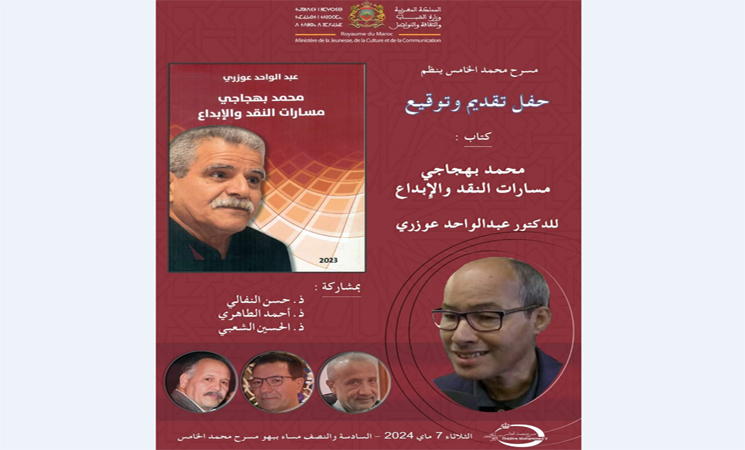
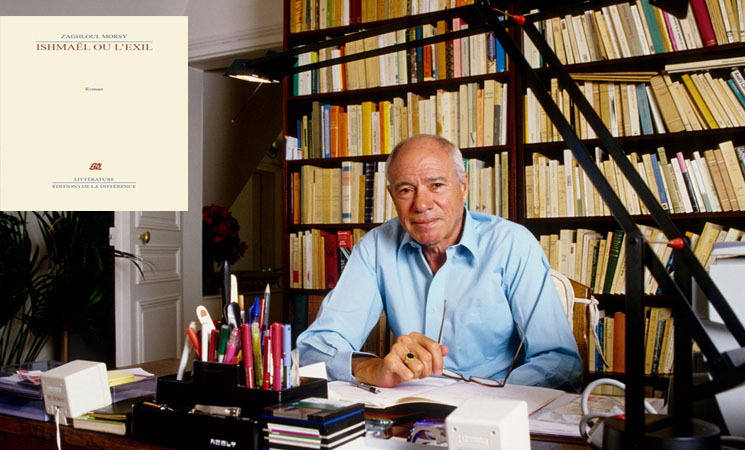


اترك تعليقاً