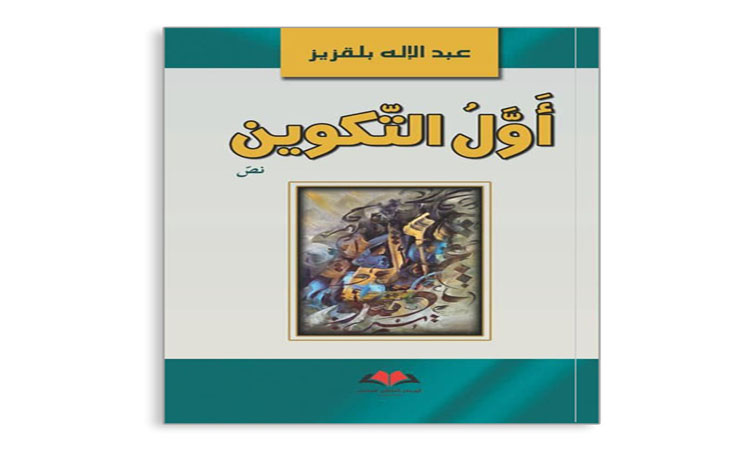يصنّف دارسو الأجناس الأدبية السيرةَ الذاتيةَ، إجمالاً، بأنها فنٌّ فرعيٌّ من شجرة السّرد الكبرى، وغصنٌ يانعٌ من كينونتها الباسقة. هي فنٌّ قديمٌ وحديث، في آن. قديمٌ، إن نحن قرننّاه بالتراجِم والسِّير التي وضعها كتابٌ ودوّنها أهلُ المعرفة بأصنافها عن حياتهم وأعمالهم، يعنيني منهم الأعلام لا الغُفل، نسوق مثالاً عنه في العربية كتاب» التعريف» لابن خلدون(1332ـ1406).هذا النوع الفرعيّ عند القدماء كان يشتغل بتقييد نَسبهم وشيوخهم ممن درسوا عليهم وأخبارِ من اتصلوا بهم ووصلوهم مع إحاطة بأحوال زمنهم. إن موضوع هذه الكتابة الشخصُ في هويته وتكوينه لا الذاتُ بوصفها(أنا) مستقلةً ومميزةً بصفاتٍ وطباعٍ وتُجلِي لنا صاحبَها بأسلوب البَوْح والاعتراف في أطوار مختلفة من حياته، لذلك سُمِّيت سيرةً ذاتية، لا غيْرية، ولا هي موضوعية. هذا التعبير إذا كان قد ظهر تبشير به في القديم الغربي في» اعترافات القديس أوغسطين» (354ـ430)، فإن نواته الصلبة توجد في « اعترافات جان جاك روسو»(1782) المصدر الأمّ لمعظم الدارسين، لما سيصبح منذ القرن الثامن والتاسع عشر تعبيرًا عن الفرد صريحًا صِيغ بضمير المتكلم في سياق عصر تحول الأنوار وتغيّرات اقتصادية اجتماعية حاسمة. من غير أن نغفل بأن الاعتراف يستند إلى مرجعية كنسية تربطه بالخطيئة الأولى عند المسيحيين، على خلاف مذهب المسلمين الله عندهم غفور رحيم.
لامجال للتفاصيل، وبالرغم من هذا لا بأس من التذكير بأن السيرةَ الذاتيةَ التي كتبها بعض العرب حديثًا اقتدت برائدتها الغربية، الفرنسية خاصة، وبكثير من الاحتشام والحذر، في المادة المروية، والبنية الصرفية النحوية (الضمير الراوي). أكتفي بمثال كلاسيكي عليه الإجماع، كتاب «الأيام»(1927) لطه حسين(1889ـ1973) استعمل فيه عميد الأدب العربي ضميرَ الغائب لأسباب ترحيلِ نفسه إلى آخرَ والتحايلِ على المعلوم والمجهول بالنسبة لشخص ضرير، وخصوصًا تحاشي البوح الذي يسوق إليه ضميرُ المتكلم وهو لسانُ السيرة الذاتية وصيغتُها المُثلى في نماذجها المقننّة بالإضافة إلى قواعدها المجنِّسة لها بعد استقصاء المتن الغربي حصرًا، والمقررة شبه دستور أدبي في « الميثاق الأوتوبيوغرافي»(1975) عند فليب لوجون، تجمع جملةَ طرائقِ وأنساقِ كتابة هذا النوع الذي ما انفكّ يتبدّل ويتجدّد. نعلم أن نصيبُ العرب فيه قليل، ومتأخر، لأنه سرد، جزءٌ من فن الرواية التي كتبوا متأخرين( مطالع القرن العشرين) ولأنه يحتاج وجوبًا إلى أكبر قدر من الحرية والتسامح والاعتراف بخصوصيات وأمزجة، وحيوات الأفراد وسط طغيان السلطة الجماعية عقيدية وحاكمة واجتماعية عرفية.
للأدب المغربي الحديث نصيبٌ مهم جدًا في هذا الفن، وإن بقدر محدود، يسمح بالقول بأن أهم سيرة ذاتية كُتبت بعد أيام طه حسين، رغم إغفال النقد الأدبي في المشرق المنغلق على نصوصه، لوزنها الحاسم، هي التي دبّجها يراع عبد المجيد بن جلون(1919ـ 1981) بكتابه» في الطفولة» (1949) عندي أنها تعدل بل تفوق» الكلمات»(1964) كتبت متأخرة عنها وفي سياق مختلف، لجان بول سارتر(1905ـ1980) جُعلت في القدَح المعلّى عند الدارسين والنقاد.لا بأس في هذا المقام من القول أنشتان ما بين» في الطفولة» ونص» الزاوية»(1942) للتهامي الوزاني(1903ـ1972) الذات فيها مكبلة بل ملغية لحساب سيرة التكوين الفقهي والصوفي، فبدون هذا التيمة لا سيرة. لذلك نعتبر ابن جلون رائدَها ومعلمها في أدبينا المغربي والعربي، عامة. انقطع نسل هذه الكتابة بعده إلا قليلا أو ما انتسب إليها بارتباك عند عبد الكريم غلاب(1919ـ2017)، إلى أن بدأنا نشهد في السنوات الأخيرة استئنافًا لها وذلك بولوج بيت السيرة الذاتية من باب خلفي لها يُسمى» التخييل الذاتي» حذلقةٌ بين الرواية والسيرة، وبعبارة الناقد رشيد بن حدو كتابة « بين ـ بين»، أو بعرض شبه تاريخي ونظري لمقاطع يعُدّونها هامةً من حياتهم وتعليمهم وتكوينهم الثقافي وتأملات عامة، أذكر بالذات عبد الكبير الخطيبي(1938ـ2009) في» الذاكرة الموشومة» بالفرنسية(1971). ثم انتقلنا في» أوراق»(1989) إلى ما سمّاه مؤلفها عبد الله العروي (1933ـ) ب» السيرة الذهنية». أبعدَ عنها الوقائعَ الشخصيةَ وركّز على مساره العلمي بين المغرب وباريس.
قريبا منه، فعل سعيد بنكراد في» حيرتي وظنوني»(2021) ينبه قارئها بأنها» تحمل من الأفكار أكثر مما تجمع من الأحداث والوقائع». هذه النماذج من السيرة الذاتية مختلفةً يلمُّ شعثها مشترك عرضِها بالسرد على لسان راوٍ هو المؤلف ثم تتفرع نُوَيْعات.
عند عبد الإله بلقزيز، وهو جامعيُّ أولاً، أستاذ الفكر العربي والإسلامي بجامعة الحسن الثاني، وله أعمالٌ روائيةٌ ونصوص من عيون النثر الفني، نقف عند نصٍّ هو بيت القصيد من مقالنا، أراه جديدًا ومختلفًا في نهج السيرة الذاتية:» أول التكوين»(المركز الثقافي للكتاب، 2023). وبسبب هذا الاختلاف، ولإبداعيتها المائزة تجتهد في تصّورٍ ونسجٍ آخرَ للسيرة الذاتية عامةً لا في أدبنا العربي وحده. لابد سيلفت نظرَ القارئ نوعُ التجنيس الذي وضعه الكاتب لعمله على الغلاف، وما هو اعتباط بل تعيينٌ بقصد ومثارُ لبُس وسؤال؛ سمّاه(نص)، ومعلوم أن كلّ كتابة شعريةً أو نثريةً لسانيًا هي مجموعُ التعابير والجُمل المشكّلة لعمل مكتوب، ويتخصّص بالتعريف نصًّا حسب وظيفته(جان مشيل آدم،2005) ليقدم لنا بعض إجابة عن مقصد الأديب بلقزيز نزيهة لا مخاتلة، وإن يوقعُ القارئ مثلي في ورطة، بالأحرى يحرِّضُه على التأمل.
يتكون كتاب» أول التكوين» من قسمين موزّعين على فصول صغيرة بأرقام رومانية. يهدينا المؤلف في المدخل إلى معنى عنوانه (أول) يفيد البدايات، و(التكوين) هو تكوين الشخص (7). نفهم، إذن، أننا سنكون بصدد سيرة ذاتية، ما يفتح أفق انتظار القارئ على تلقٍّ حكائي بصيغة سرد حياةٍ كما يرويها صاحبُها، وبالمواد البانيةِ لها، وكما يبغي أن تُعلم وتُرى وتُفهم وتُفيد وتعِظ. وإذا كان الناس جميعًا بدون تمييز يملكون سيرة شخصية، فإن الكاتب يحتاج إلى مسوِّغٍ لينتقل إلى إنجابها، ولا بد سيفكر في طريقة نسجها قبل أن يرويها ومن أي زاوية، لأنه يعي ضمنًا أنه سيُقرأ كاتبًا ويُقوَّمَ نصُّه أدبيًا بخلاف السياسي والرياضي ومثلهما تُنتظر تجربته، أولا. بلقزيز أعدّ لهذا عُدّته بإثارة مسبقة للسؤال:» لماذا السّيرة؟ ماذا تريد من إيقاظ ماضيك(…) أهي سيرةٌ ما تكتب أم حيلةٌ لخروج النرجسية من شرانقها ورؤية محاسنها في مرآة صقيل؟» (8). يأخذ بيدنا، يرشدنا في مَهْمَه طريقه كأنه يخفّف علينا من وعثاء ما سنلقاه ونحن نخطو في درب ما لم نتوقع:
1ـ إنه يتلقى وسيروي أول التكوين ب(عين الذاكرة).
2ـ بعبارة أوضح، سيركب صهوة العودة إلى البدايات، بمعنى العود من حاضر إلى الماضي.
3ـ إنه ليس كاتب سيرة» لكنك تتلصّص على بعض ما جاد به الزمان عليك واستنقذته من آفة النسيان». لننتبه هنا إلى ملازمة الحذر لدى كل كاتب عربي من السيرة كأنها شُبهة أو معرّة.
4ـ سيروي من جود الزمان مجتزئًا ومتخيِّرًا» اقتنصْ لك منه ما تقرأ فيه صورتك الآن». هذا الانتقاء والتخيّر، أيضا، ملازمان لكتابة السيرة الذاتية، واهمٌ من يظن أنها تُروى كاملة ولا حقيقية حرفيًا، إذ الاقتناص يصنع ما لم يكن وإن ببعض ما كان؛ إنها حقيقية كاذبة لو جاز(10).
5ــ وإذن، فقد حدد وضعه(STATUT) وأعلن ميثاقه (PACTE) وأفصح عن هويته( متلصّص VOYEUR) يُطل من ثقب باب الزمن الحاضر على دار الماضي. من ثقب ذاكرة مُحيّنة.
6ـ وهذا هدفٌ جوهريٌّ من وراء القنص، اتخاذهإبدالاًPARADIGME» تصحح به ما فعلتْ فيكَ الأيام من ألوان التبديل»(10).
سبب آخر للتشكيك في صدقية أي سيرة حرفية (هي تُصحح). لذا يحق لي تسجيل أنه قيل كلّ شيء، على غرار ما قاله مارسيل بروست في» ضد سانت بوف»(1954)» هذا الولد الذي يلعب هكذا فوق الخرائب يتغذّى فقط من متعة ما تعطيه الفكرة التي يكتشف، يخلقُها وتخلقه»، وجريًا على نهج دشنه ألان روب غريي الذي كسّر مرآة استندال المتجوّلة في الشارع والعاكسة، ناقلاً رواية القرن التاسع عشر إلى رؤية منتصف القرن العشرين بعين بطله ماتياس:» المتلصص» (1955).
فعلامَ يتلصص عبد الإله بلقزيز، وبأي أداة؟ في الظاهر قال إنه سيذهب إلى بداياته، تعني الصِّبا واليفاعة، ولا بأس ببداية الشباب، ليروي ما تحفل به عادة واللهم استثناء، وفي سيرته نجد مادة وفيرة ينضّدها على صعيد الاستثناء جديرة بالفرز والإحصاء في ورقة خاصة. لنتحدث هنا على صعيد العام حدده عينًا في ما يُكوِّن الشخصية. أداتُه(احتلاب الماضي) من ضروع الذاكرة. ماذا سيحتلب من الذاكرة التي مهما بلغت صلابتها غربال؟ وعلى أي منوال؟ سؤالان أساسان يتوقف عليهما موضوع ومعنى ونوع هذه السيرة التي أنعتها بالاستثنائية، بانتسابها إلى النوع، واختراقها له في آن من داخله لتتخلّق نصًّا أدبيًا مفردًا بذاتها وبه.
لا تروي « أول التكوين» سيرةً تقليدية. لا زمن ولا مكان محددًا لهما بصرامة، اللهم بتعميم، من قبيل أن مراكش مدينة مسقط الرأس، إنما لا عناوين وعلامات قارة لشخص يستعيد مقاطع من حياته يتحرك ظاهرًا في المكان وينتقل بين حدب الأحضان؛ بعد مسافة كتاب وقراءة أنه يتنقل في أمكنة ذاته ولواعج وتهيؤات صباه أكثر من أي شيء.وتنتفي الكرونولوجية، لا يستقر الراوي في وقت، ما يلبث الاستطراد والحنين وزحف الذكريات، وكذلك زخرف العبارة واقتضاءُ مراعاة قفلة السجعة أن ينقله بين الأوقات، بين المعلومات والصور، منها مشاهدُ مبعثرةٌ عن الطفولة تتراوح بين الكتّاب القرآني وحضن الجدة والخال الذي ناب عن أب مات وهو في عامه الأول، حالة اليتم يمرّ عليها مرور الكرام وإن غذت الوحدة، وطقس الحمّام، وحلقة الحكواتي في ساحة جامع الفِنا بمراكش مسرح وفضاء التكوين الأول ومعاينات الطريق.هي مٍزقٌ متفرقة، وأوائلُ خفقٍ غرامي وغُلمةٍ جنسية، عبورًا بإشارات خاطفة لسنوات التعلم بين الثانوي والجامعي وأجوائهما العامة، مع وصف مزاج التلميذ ونفسيته وغلوّ طبعه، أحيانا، ونهمِه للقراءة، وذكره كتابه المفضلين، أضف لهذا انبجاسُ نبعِ موهبةٍ أدبيةٍ ناشئة ما فتئت أن جاورتها ملكةٌ فكرية مشحوذة، وتذبذب بين شخصيتي الأديب والفكر، خامة هامة في فسيفساء التكوين، سَمتُها متواصل ودليلها عيارها بارزان في هذا الكتاب. بيد أن أهم بغية وأعزّ ما طلب بلقزيز، مما ذكرنا وسواه، هو شرح الخاطر، ورصد أجواء النفس، ما يؤهل لوصف كتابه بسيرة الطّباع والوجدان (الخجل، العزلة، الوحدة، الخيال، الولع بالحكاية، الصمت،) يسائلها ويقلّبها على وجوه محلقًا بالمجاز وأجنحة المحسّنات البديعية لا بالوصف المادي، فهو طيف لا إنسان، ما أن تقبض على خبر وفعل إلا وهجرهما إلى مجهول البيان، وعليك أن تلاحقه ولن تصل. في قاموس وأساليب الرّبائد القديمة يؤسس بها نصًّا عربيّا بنية الجملة فيه مسجوعة، والمفردات بلون وصورة وإيقاع.
ما أكثرها وأنطقَها العباراتُ والمقاطعُ الممثلة لهذا المنزع، الدالة عليه تحتاج بدورها إلى جدول خاص. وهو ما يمكن أن يوكل لطلاب سيفيد في تخصص محدد ليتعلموا في ضوء النص أفضل من رطانة المصطلحات.هاك منه تشخيصٌ حيٌّ للعبة الكناية والمجاز:» وحدتي متعتي وفي الصمت ولادة ما قد يولد، وهما حديقتي ومملكتي وموعد إيناع سنبلتي. مهبط وحيي هما، ومِسّلّةُ ذكريايَ وشاهدتي؛ أقيمها مثلما شئت على هوايَ؛ وأرسل مرآها في فضاء تعجنه يدايَ، أخرج من تقمّص البعيد في خيالي، وأعتصم بالمكان الأثير على هواي»(48). بعد وصف وجدانه يعرِّف بل يصف كيف ارتاد الحكاية على ضفاف حكايا الجدة، حيث «ينمو الخيال مثل عشب فوضوي»(57) يجمع ويسمع ويخبّئ في القرار تُسعفه حافظة شُحذت في الكُتاب القرآني. وسواءٌ تحقق هذا في ما روى أو بقي نيةً خالصة، فالكاتب بلقزيز يشرح لك خطة كتابته، ويكثر من التنبيه لها كأنه يخشى سوء الفهم وإما انصراف القارئ على خلاف ما كان يتوقع من السيرة كما قرأها في نصوص متداولة مألوفة، وهذه خاصية أخرى من خصائص هذا النص الفريدة بعبارة ما يسميه نقد السرد بالميتا ـ حكي وإن جاء هنا على السّجيّة مثل ما كان يخطه الفقهاء سابقا على الطرة:» أسأل نفسي، أحيانا،عن حدود الواقع في الحكاية حين يشتد بي الشعور بالغرابة، ويركبني سؤال المستحيل(…) الخيالي واقعي عندي وإن بدا الإثنان متضاربين»(58) ويبقى للخيال عليه فضل بالرغم من ظاهر التسوية، وإن سمّاه بلفظ مختلف فجعله يعادل التخييلَ فيأتي مصدرًا لفعل تخيّل، وهو غيره في مصطلح السرد بمعنى (fiction) وإن دار في فلكه في خاتمة المطاف،ذلك أن نقل الخيال إلى مضمار السرد، الرواية، يتم بعملية تحويل عبر صور مصنوعة أيّ بالصنعة، مصداق هذا الفهم مني والتأويل هذا المقطع قوله: «علّمني التخييل أن أفكّ إسار الممتنع على الإمكان وأن أروِّضَه على طاعة ما شاء(…) وكم كان عليّ أن أصنع من عالم الأشياء أشيائي الخصوصية، وأن أهبها الأشكال والأسماء والألوان القزحية»(59). تأكيدا لتأويلنا المسبق المستنتج يُزوِّد الكاتب قارئه بتوضيح إضافي مقنّنًا له اسما خاصا هو» قانون الدهشة» يصل إليه على هذا السبيل وبهذا المنوال؛ اقرأ:» والخيال لولبيّ، وربما أفقي، حين أحسنُ الإصغاء إلى نبرته فأسلس القياد له يأخذني إلى حيث يشاء، ويعلمني ترويض الأشياء، وتركيب المكان والزمان على قانون الدهشة»(60). الترويض بمعنىً هو الصنعة.
هل أحتاج بعد هذا إلى وصفها ب (استراتيجية كتابة)، في مضمار إبداع نصٍ أدبيٍّ تتنازع المواهب وأصناف القول والخطابات صاحبه. لذلك، وبناءً على عرضي وما حددت من خصائص لهذا الكتاب، بوسعي أن أخلص إلى القول بأن بلقزيز الأديب فيه يبُزّ ُالجامعيّ حقًا والباحث المبرّز، يفتح لقرائه وطلابه بيتّه الداخلي، إنما بأوشام ٍورموز، بسيرةٍ المطلوبُ منك فيها أن تخشع فيها كأنك في محراب، وأن تتقرّى الكناية والاستعارة عبر مدارج تكوينين: الشخصية والنص، بينهما برزخ وجدان وأساليب بيان لا يبغيان. وهذا علِمنا طرزَه عند شاتو بريان، ونسقَه لدى مونتيني، وقليلاً عند مصطفى صادق الرافعي يغلب عليه رونق اللسان، وفيضًا لدى جبران خليل جبران، بقاموس ينتمي إلى بلاغة إنجيلية وخلجان ذات بدهاليز وألوان، و»عنقود ندى» قطفناه في كروم المغربي مصطفى الصباغ، واليوم ثمارُه دانية القطاف فوّاح في بستان عبد الإله بلقزيز اختار أن يكتب السيرة الذاتية على غير طراز، وهو امتحان له، وكذلك إعادة اختبار لذائقة القراء. لن أتركه قبل أن أستعير من فمه سؤاليّ الأخيرين:» ولَم تسأل نفسك لِمَ تسلُك في الكتابة الإغراب، فتنتقي من الألفاظ ما ربَد في المعاجم من ربائد اللفظ ممّا دالت دولتُها مذ ذوَى سلطانُ اللسان في الأعراب»وزاد يسأل:» فلِم، إذن، تكتب وراء حجاب الوضوح، وتُرسل القلم في خُيلائه سادرًا في غريبه يقول ما يقول، لكنه في القول لا يبوح، ولا يركب لمنطوقه العبارة الدقيقة؟»(139) .لا أطلب جوابا، فلو علم الكاتب، ما كتب.