الرواية
بين مؤهلاتها والوعي الموضوعي بها

ليس من عادتي تقويم نص، بالأحرى إصدار أي حكم عليه، قبل قراءته بإعادتها وتأمله طويلا في حد ذاته، وبعد ذلك وضعه ضمن شروط إنتاجه وفي محيطه العام. كما لا أقرأ عملا لأوليه أكثر من أهمية لا تتقرر إلا بعد الاطلاع عليه وبنظارات تناسب نوعه تظهره للعيان. تفشّى بيننا من يتبرع ومن تتنطع بترفيع هذا الكتاب، والغمز من ذاك النص، لا يألون أقل جهد في قراءة تستوجب الدّرايةَ والوقتَ والانتباه بعيداً عن ضوء المناسبة وعجلة التغطية بانفعال. تقويم نصوص راجحة في الميزان الأدبي، لا في وهم تفوّق أصحابها بالغرغرة والجمهرة، مسؤولية نقدية ذات بال، فكيف إذا خصت أعمالا تلتفت إليها أنظار العارفين، كذلك المتربصين بالجوائز الأدبية ذات الاعتبار، إذ ليست كلها كذلك، فيها المحصور في طاعة وصك مال.
شهرا أكتوبر ونوفمبر الأخيران كانا موعد النصوص والجوائز الأدبية الكبرى في العالم الغربي، وقسم كبير من قراء العالم تتعلق عيونهم، بمقدار معرفتهم باللغات، بها، وتصبح قدوةً ومقياسا للإجادة في الفن الذي تُمنح باسمه نعلم أن الرواية اليوم هي الأغلب. نعرف أن جائزة نوبل للآداب تمثل دائما ذروة متقدمة ثم يليها العزف المنتظم للجوائز الأدبية في بريطانيا وفرنسا/ مثلا/ بينما تتوزع جوائز أخرى، العربية من بينها، على مدار العام. يتوالى في فرنسا، باريس بالتحديد، الإعلان عنها بعد موجة توقعات وتكهنات وتسريبات هي تحصيلُ حاصل مجموعِ القراءات التي توزعت بين المجلات والملاحق الثقافية عن نصوص يركّز عليها نقادٌ ومعلقون محترفون في سياق استشرافٍ واستباقٍ بل وترويج ومحاولة تأثير على لجان قراءة مكونة غالبا من روائيين راسخين وأدباء مشهود بخبرتهم في الميدان غير طارئين، بهذا يحدث تجاذب وتصادم أيضا بين رأي عام نقدي في الوسط الأدبي والإعلامي وبين ميكروكوزم لجان متنازعين بين غواية كُتاب وإيحاء وربما تأثير دور نشر، وخصوصا ذائقة خصوصية تنسجم مع ما يسمونه في باريس ب» l’air du temps» أي الفكرة أو التيار السائد في مرحلة ويهيمن على النفوس والأذهان فيتمأسس أخيرا بقرار وليكن اختيار لجنة.
وفق هذا المنظور، فإن المعايير النقدية وحتى الأمزجة الذوقية المبطِّنة والمصاحِبة المتحكمة عادة في عمليات وقرارات التحكيم، إن لم تُزَح أو تُختَرق كليا، إذ لا يمكن بتاتا تمرير أعمال مهزوزة القيمة في مضمارها، فإنها تجد ما ينافسها من خارجها وبتقدير وتصوّر موضوعيين، كأن تتجه هيئةٌ إلى إعلاء تيمة أو مرتبة فكرية أوبراديغم حضاري تمفصلت حوله مجموعة من النصوص وينسجم مع حالة ثقافية في البلد، رؤية مجتمعية وأخرى إنسانية، لم لا نزعة إيديولوجية يُراد الانتصار لها، وبالطبع، هناك خصائص جمالية وتصورية في النوع الأدبي( الرواية، هنا) قابلة للترجيح، ما خصت به رونودو جائزتها هذا العام فمنحتها لإميلي نوثومب عن روايتها»Premier sang» ضمن حزمة روايات تخييل ذاتي خصصت كلها لتيمة الأب.
نخلص إلى أن أهم ثلاث جوائز أدبية توجت كتابها هذا العام، تندرج في هذا الإطار، مُنحت ثلاثتُها تبعا لرأي ورؤية وخطة متقاربة، لَتحسَب أن هناك اتفاقا قبليا أُبرِم بين الهيئات القائمة عليها، ونفذته في ضوء الأعمال المعروضة عليها أو جعلتها مناط قراءة لتختار منها الفائز. وهي مجتمعةً جاءت إما صاعقة بمفاجأتها، أو كانت مستبعدة، وإما واردة بالترشيح أو التأهيل. أولاها، نوبل للآداب معلوم ذهبت للتنزاني عبد الرزاق قورنح، أبى إحباطٌ عربي إلا أن يربطه عنوةً بأصول يمنية قديمة عسى يخفف من حسرة فوزنا مرة واحدة فقط منذ نجيب محفوظ (1988). لم يكن روائي زنجبار الأصل، الإنجليزي الجنسية والإقامة واللغة والمُنجز، وارداً على بال أو لسان، فهو كاتب منسيّ، ببضع روايات وقصص أهمها «Paradises» المنشورة سنة 1994 وأهلته للجائزة وكان ترشيحه قد ورد سابقا في البوكر الإنجليزية. لجنة نوبل حددت قيمتها وأهميته في أن رواياته:» تبتعد عن التنميط وتفتح عيوننا على شرق إفريقيا المتنوع ثقافيا وغير المعروف لكثير» وحيث:» تجد شخصياته نفسها في فجوة بين الثقافات والقارات، بين حياة كانت موجودة وأخرى تنشأ، لذا فهي غير آمنة إطلاقا».
في الموسم نفسه فاز دفيد ديوب، المولود من أب سينغالي وأم فرنسية، ومدرس جامعي بفرنسا بالبوكر الإنجليزية عن روايته:»Frère d’âme»الصادرة 2018 ترجمتها إلى الإنجليزية الشاعرة الأمريكية أنّا موشوفاكيس، بعنوان:»At Night All Blood is Black» فيصبح أول إفريقي يحظى بهذه الجائزة عن قصة وفاء بين صديقين أفريقيين كلاهما حارب في صفوف الجيش الفرنسي وضد أعدائه، وتمزج بين تعبيرين إنساني محض وتصوير تاريخي نابذ لنظرة استعمارية. بعدها أصدر ديوب عامنا» La porte du voyage sans retour»(Seuil ) تحكي فصلا مرعبا من تاريخ معاناة الأفارقة مع العبودية من خلال بطولة نسوية ممزقة. وتحظى الرواية بحفاوة في التلقي والمبيع علما أنها منزّهة عن الصنعة ونابعة من الجذور.
الثالثة هي»La plus secrète mémoire des hommes» الفائزة بأهم جائزة فرنسية في الرواية منذ 1905 الغونكور وصادرة عن دار نشر غفل. خلافا للإثنين السابقين، فإن محمد امبُوغا سار، لم يفاجئ الوسط الأدبي، فروايته حظيت بالاختيار ضمن عديد جوائز(فمينا ورنودو) ونوه بها أكثر من منبر واسم عالم، وجاءت في قائمة ترشيحات قوية، وفي الختام أطاحت في قصب السبق بأسماء وازنة منافسة (كرستين أنجو، سوي شلاندون، ولوي فليب دلامبير، ثلاثتهم حلبوا ضرعا واحدا هو تاريخ علاقتهم بالأب وتعقيداته موضوع الرواية الفرنسية الأول هذا العام. سار، سينغالي شاب، مشبع بثقافة المتروبول، وذهب في روايته الضخمة والمركبة ينبش في تضاريس الروابط السينغالية الفرنسية بين الهوية والانتماء والاستلاب لجاذبية المستعمر، مستدعيا قصة قديمة بطلها كاتب سينغالي عاش التجربة مبكرا واختفى فذهب بشخصيات جديدة يبحث عنه ويستعيد في تناصات متداخلة أزمة الإفريقي مثقفا وإنسانا في مفترق طرق بين جذوره الإثنية واللغوية والثقافية، وتحديات العالم الخارجي، بدءاً من الاستعمار وامتدادا في هيمنة لغة الآخر، وبحثه الإشكالي عن المكان الخصوصي.
قرأت الروايات المذكورة ثلاثتها، كل واحدة جديرة بعرض وتحليل خاصين، مفردة ومتواشجة أيضا لوجود مسالك بينها، وليس غرضي هذا هنا، أبين، ولا مجاله يسمح، وإنما إثارة الانتباه إلى ثلاثة أمور أيضا، أجدها مع غيري من الفطنات والنابهين، قابلة للعرض والإشارة:
1ـ هؤلاء روائيون من أصل أفريقي(زنجبار والسينغال). ثلاثتهم مقيمون خارج بلدهم الأصل حيث يعيشون ويعملون. هم كذلك، وهذا بيت القصيد، يكتبون بلغة بلد المهجر، واحد بالإنجليزية لم يكتب إلا بها وتباعد الزمن بينه وبين لغته الأصلية وثقافتها وكذا عيش أهلها، فلجأ إلى إنجلترا هاربا من الاضطهاد وفيها بنى حياته وأصبح كاتبا، نوعا ما روائي إنجليزي. السينغاليان، أيضا: أولهم(ديوب) فرنسي بحكم زواج والده وسينغالي بحكم الأبوة وإرث ثقافة بلد الأجداد لم يكتب إلا عن هذا، لكن بالفرنسية فقط لغة تعليمه ومنشإه وبها يُدرِّس، أيضا. أما محمد سار، فجاء إلى باريس طالبا متفوقا واجتاز مباريات مدارس عليا بتفوق، وغامر بأول رواية فتحت له الطريق، وإذا به تدريجيا يبزّ القوم بلغتهم وفنهم، والنتيجة ما نعلم.
2ـ إنهم ثلاثتهم رغم تغرّبهم وانشدادهم إلى دول المتروبول الإمبراطورية والاستعمارية القديمة لم يكتبوا إلا عن عوالمهم الأصلية، أوفياء للحفر في تضاريسها الأنتروبولوجية ورسم أنماط عيش أهاليهم ورصد التحولات جراء الصدامات مع المحتل والوافد، يمثلون ضمنا وعلنا رفض التبعية والاستلاب، تعبر القارة السوداء في سردهم وتخييلهم عن وجود فرد فذ. معهم يمكن الحديث عن رواية إفريقية مختلفة تجاوزت الفولكلوري والعجائبي ونبرة وصور الالتزام المباشر بشعارات إيديولوجية صارخة.
هؤلاء بنصوص مميزة ينطلقون من موقع الأدب ويصارعون، كما فعل سار الغونكوري، لإقناع المحيط الأدبي الغربي بقضيتهم الأدبية ، لذلك فإن روايته حفلت بسجل جدالي عن هذه المسألة بالذات، وتخلل الميتا خطاب كلام بطلها وهموم شخصياتها، كتاب أفارقة يعيشون في عواصم الغرب في دوامة البحث عن الاعتراف.
3 ـ نحتاج رغم ضيق المجال لبعض التفاصيل، أولها تعرف عام على العوالم المطروقة في روايات هؤلاء الكتاب، والتيمات المشتغلة في أعمالهم، ولا بأس أيضا بأدوات معالجتها وطرائق تسريد حكاياتهم المتراكمة فيها، باعتبارها أولا وأساسا مبنية على الحكاية التقليدية، هذه صيغة ما قبل روائية وجدت في المجتمعات قبل الصناعية والبورجوازية وتلائم حيوات وطقوس بيئات ما قبل استعمارية وخلالها، حيث تتمثل ثقافاتها وتقاليدها وأنماط عيشها، وباختصار، المخيال العام السائد والمهيكل لها يختصر روحها وحامل هويتها، أما الرواية فهي صناعة فنية بورجوازية نضجت في القرن التاسع عشر وتعددت بأشكال ورؤى متحولة بعد ذلك، إليها لجأ كتاب ما بعد الكولونيالية، من باب المفارقة، ليعيدوا تأسيس هوياتهم ورسم مجتمعاتهم والقصاص أيضا لثقافاتهم المهانة من طرف موجات الاستعمار وتغيير الهوية.
لنبدأ بقورنح، فائز نوبل. مجهول عند القراء العرب بل وكثير من جمهور الغرب القارئ. روايته(Paradis) بالإنجليزية، فهذه لغة كتابته، ومترجمة بشكل محدود إلى عديد لغات، تمثل حجر الزاوية لعالمه الروائي ومرآة عاكسة لمجمل شواغله وشجونه. هي حكاية طويلة عن بلده الأصلي ومنها يتتبع فيها ما جرى لطفل انتزع من عائلته رهينة لدى تاجر مدينة له بمال، وسيعمل عنده بالسخرة ويبقى عبدا إلى أن يفي والده بالدين، هي معاملة سائدة في هذا البلد، الذي عانى أيضا من العبودية بأشكال. انتقل الطفل مع التاجر إلى بلدته ومن خلال إقامته وتنقلاته، حلولا أو في رحلات تجارية ومغامرات خطيرة من أجل الربح، يرسم قورناه صورة بانورامية عن بلده الأصلي من جميع النواحي، وخاصة العرقية والاقتصادية والعلاقات الاجتماعية والتعبيرات الثقافية الفولكلورية، ويركز على وصف هبات الطبيعة من لوحات فتانة يشبهها بالجنة وتصويراتها في القرآن والعالم الآخر، فترسم حقيقية واستعارة أيضا. وكذلك، كيف أن هذا البلد الجنة هو في الوقت جحيم يتعرض للاحتلال والصراع بين قوى الاستعمار الألماني والإنجليزي، وتُنهب خيراته لينتقل إلى مفترق طرق بين حضارتين وثقافتين. قصة الولد الرهينة ذريعة ومسار لعرض هذه الصور والمعضلات. هل أقول أن هذه البانوارما ما زالت تثير فضولا وتجلب ذائقة أجنبيتين؟ نعم، بكل تأكيد. إن المخيال الإسلامي المتغلغل في ثنايا هذه الرواية بآيات وتمثيلات وبيان كفيلة وحدها للفت النظر، وجعل هذا الروائي يشغل موقعا فريدا إذ يوهم بالعجائبية، فإنه يستوطن أصوله بفطنة رسول.
4ـ لا تختلف الروايتان الأخريان الفائزتان بالبوكر الإنجليزية والغونكور الفرنسية عن عالم الروائي النوبلي إلا في محكياتهما والشخصيات والمسارات، وإلا فالتيمة هي ذاتها، أي تقاطع عالمين وثقافتين وصراع هويتين والوجود ضمن أزمة الانتماء الحضاري في السياق ما بعد الكولونيالي. كذلك، تستدعي الروايتان تاريخ العبودية والاحتلال الأجنبي وامتهان الإنسان الإفريقي وتبضيعه وتسليع القيم، وتحفل بعديد القصص والمشاهد والمواقف الطقوسية والفولكلورية كما تروق للعين الأجنبية ،وجوهريا إشكالية إعادة بناء الذات الفردية والوطنية في مفترق طرق بين الثقافة الغازية والمهيمنة والأخرى الأصلية العريقة والمفككة في آن. مع خصوصية تتميز بها رواية السينغالي سار هو جعلها الأدب موضع مساءلة وتحويله إلى بؤرة تدور حولها القصة ذات الأبعاد الثلاثية بين لمتروبول الفرنسي والمرجع الإفريقي الأم، والذات الممزقة في ازدواجيتها بين ثقافتين الباحثة عن مرتكز عبر تناصات وإحالات.
5ـ هل اقتنعت المحافل الأدبية الغربية الكبرى بهذه» الدفوعات» وارتضت مقتنعة بالأحقية الإبداعية لهذه الروايات، المكتوبة، طبعا، بلغتها(إنجليزية وفرنسية) فأسبغت عليها رضا أفخم الجوائز تعلم أنها تغني آدابها؛ أم إلى جانب الجدارة والاستحقاق، بالعبارة التقليدية، ثمة موقف ضمير، وتعبير «وعي شقي» من لدن هذه المحافل عن غبن طال كتابا وقارة( أول غونكور لإفريقيا لروني مرات سنة1921، ونوبل وحيد لها وول سوينكا 1986) وكذلك نعده انتصارا لقيم بخست طويلا وآن إنصاف أصحابها؟ أم إلى هذا وذاك، مظهر إقرار للثقافة الغربية عامة بحقوق الشعوب ومناهضة الاضطهاد بتكريم أبنائها المنتسبين إليها، كما هو اعتراف ماكر ما دام يدور في فلك الفرنكفونية نفسها ويوسع أفقها بينما هي في تقلص، ويغني آدابها هي منه وهو فيها، كأنما مقايضة مريحة ذات مغنم للطرفين؟
لنترك الأسئلة مفتوحة ولنحيّي قوة الأدب. نعم قوة الأدب الذي فرض نفسه على هيئات راسخة تتحكم في أرفع الأوسمة التي تزين صدور الكتاب، تارة باستحقاق كامل، وأخرى بتفاوت وتساهل أو لجاذبية ما.
6 ـ بقيت لنا ملاحظة أخيرة في هذا السياق، نراها في أن تكريم الروايات الثلاث المذكورة من طرف هيئات أدبية غربية رفيعة يمثل نظرة نقدية ارتدادية للرواية الغربية عموما عن كيف تكتب وما هي مواضيعها وشواغلها، وأغلبها حاليا متورمة بالهموم الفردية والتشنجات الأنوية والعصاب الجنسي ولا تكاد تخرج عن الطريقة الأتوبيوغرافية والتخييل الذاتي، بنفور من المجتمع وانكفاء على أنا مرضية شبه منقطعة عن اليومي والتاريخ . بينما نكتشف في الأعمال المتوجة، نعم مدموغة بشدة بطابع المثاقفة، هي أراض بكر وعوالم خلفية وحيوات شعوب كانت لها ثقافات استعبدها الاستعمار وشوه كثيرا من وجوهها، وها هم كتابها الأخلاف يعودون بوعي جديد ليس بالضرورة بروح فرانز فانون وإيديولوجيات التحرر الستينية، أو ليرقصوا فوق الحطام، وإنما ليزيحوا الرماد عن جذوة غضب وغصب ويعطوا لشعوبهم الحق في سرد حكاياتها الأولى بأنسجتها وصورها الأصلية كما كانت وكيف سرقت وقتلت روحها.
7 ـ ثم ألا ينبغي للكتاب العرب المتسابقين الآن المتهافتين أحيانا بخزي على الجوائز أن يتأملوا هذا المثال، ويتساءلوا برصانة: ماذا يكتبون؟ كيف يسردون؟ من أي مخيال يستمدون وعنه يصدرون؟ ما جماليات تخييلهم؟ وهل هم يملكون الخيال حقا، أم يرقعون مقاطع من التاريخ وأحداثا عابرة، ويثرثرون طويلا بلسان شخصيات سطحية تفيض شفاهها بزبد تباريح تذهب جفاء؟
لم يوجد الأدب للكدية، بوصف الهمذاني والحريري في مقاماتهما الشهيرة يقدمان صورة بارودية مدهشة عن مرحلة، كم نراها تتجدد لتستشري كالوباء، ولكن لأكبر وأعمق وأجمل. وبعبارة أخيرة، لا ينبغي أن ننبهر بأي نص ونزغرد له عروسا لفوزه بهذه الجائزة أو تلك، بل لمؤهلاته يدركها الراسخون في فنه لا أشباه دارسين ونقاد يؤتى بهم لـ» يحللوا» الزيجة مدلسين عاهات العروس. لا يسمع صفير في القاعة حول هذا النص لأنه بطريقة ما مغشوش أو في تحكيمه تدليس، الدليل أن نوبل ذهبت لكاتب نحت اسمه في سجل الرواية في تسعينات القرن الماضي فأخرجته بعض الوقت إلى ضوء العابر وهو الذي منذئذ يسبح بهدوء وثقة في نهر الكلاسيكية الأزلي، وفي هذا فليتدبر المتعجلون، وقراصنة مكان غيرهم عبثا.


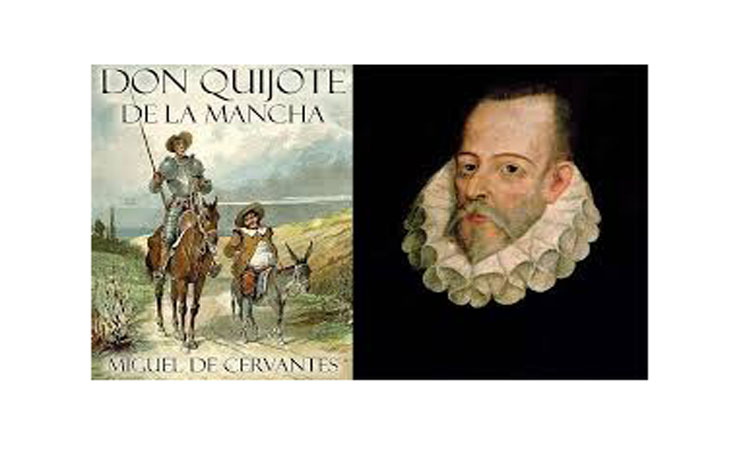



اترك تعليقاً