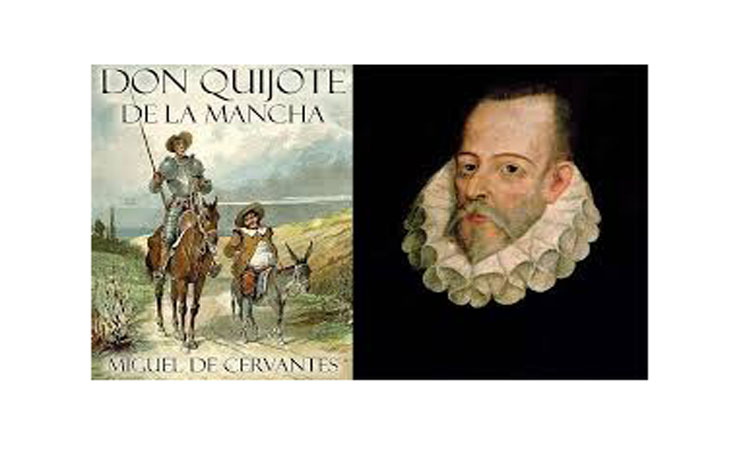هل للشعر وظائف عدة، أم له وظيفة واحدة لا غير، تواطأ عليها أهل الأدب والنقد والفكر، عبر تواريخ وأزمنة تمتد إلى البعيد، وهي الوظيفة التربوية بما هي أُسُّ وقِوام وغاية الأدب والفنون جميعا؟.
هل التربية هي ما ينبغي أن نتوخاه من الشعر، وننتظره، ونترصده في المطاوي والبواطن والمتون، شجرا مثقلا بالثمار، وبوارف الظلال؟. وهل معنى ذلك أن الوظيفة تلك هي وظيفة أخلاقية بحصر المعنى، أم جمالية بتوريقه و تخصيصه؟.
أم هُمَانِ واحدٌ، لأن الأخلاق جمال، والجمال أخلاق؟.
لكن، ألاَ يتكفل الدين بمهمة تربية النشء على الخُلُق القويم، والخصال الحميدة، والخلال الفاضلة؟، بينما يتكفل الشعر بالتربية الجمالية حَسْبُ، التربية العاطفية الانفعالية المثيرة للتفاعل النفسي والعصبي الخلاق، ليحصل الالتذاذ والنشوة، والرَّجَّة التي تحدث عنها عبد القاهر الجرجاني، ورولان بارتْ،، ويتأتَّى الشعور العميق، والإحساس الدفين، بالارتياح والرضا بحسب إيمانويل كانطْ.
فالشعر هو ذا في عُرْف البعض، وقد أوفى على غايته، وحقق حقيقته التي لا علاقة لها بالحقيقة العلمية أو الاجتماعية، واستوفى ابتداعَه وَخَلْقَه لأن أثره نفذ وتغلغل، وسما بالوجدان والحس والذوق، وبآدمية الإنسان. وإذاً، كل الصيد في جوف الفرا، فيما يقول المثل العربي.
ومعنى هذا، فإن الجملة الخبرية: وظيفة الشعر التربوية؟ تتضمن الإنشاء لأنها توحي – ضمنيا- بالسؤال أو بالتَّسْآل. وإذا شئنا قلنا : هي خبرية في منطوقها، إنشائية في مبطونها وبعدها الدلالي.
أي: هل للشعر وظيفة تربوية؟، وعلى فرض أنه يتبطنها، وتنهض به في الخلاصة والمآل؟. فما نوع هذه الوظيفة؟، ما طبيعتها؟، ما توصيفها؟، وأيُّ القيم تثوي فيها لتمررها قصدا، وبغية ومرمى؟. وهل اتُّفِق بصددها، أم تَحاججَ القوم في شأنها؟.
إشكالٌ فنيٌّ تاريخيٌّ، إبستيميٌّ معرفيٌّ وفلسفيٌّ، يحيل على معترك نقدي متعدد ومتفرد عبر تاريخية الفنون، والشعر ضمنها، حيث سعى منظور نقدي فلسفي إلى الدفاع عن علاقة الفن بالأخلاق، وبقيم المروءة والشرف، والشجاعة، وتشبيكه بمَعْنيَيْ: الإمتاع والمؤانسة والنفع والفائدة. ويمكن ذكر أفلاطون، وكْروتْشِهْ الإيطالي، وتولستويْ الروسي، ونظرية الشعر الكلاسيكية: تمثيلا لمنارات أحقاب زمنية متفاوتة ومتباعدة. بينما رأى منظور معرفي فلسفي آخر، أن وظيفة الفن والشعر، إنما تكمن فيه، في نفسه. إذ لا يروم الشاعرُ نفعَ الناس، ولا تمريرَ موقفٍ ورأيٍ أخلاقي معين بغاية اعتناقه وتَمَثُّلِه، والاقتداء به في السلوك اليومي، وفي العلاقة مع الآخرين. وغالبا ما يقفز إلى الذاكرة – في هذا الصدد- الفيلسوف كانطْ، والشعراء الألمان في القرن التاسع عشر من منطلق شعار: (الفن من أجل الفن)، كما يتداعى إلى الذهن : البرناسيون الفرنسيون، والدادئيون، والسورياليون.
كما لا ينبغي أن ننسى – في إطار تأكيد لاخارجية الفن، ولامرجعيته ـ جماعة الشكلانيين الروس، والمستقبليين ، وأصحاب النقد الجديد الأمريكيين. فضلا عن شاعر هائل كبودلير.
ولنا أن نشير – خطفا- إلى الشعر الديدكتيكي في معرض مناقشتنا للسؤال، وتقلييه على وَجْهَيْه، بما هو جنس أدبي مستقل، قائم الذات، مثله مثل الشعر التراجيدي، والشعر الملحمي. وهو ما لم يعرفه تاريخ الشعر العربي لا إثارةً ولا ممارسةً.
كانت الغايةُ من هذا الشعر المسمى كذلك، التعليم والتربية على مجموع الفضائل، والأخلاق الرفيعة، والحثّ على تعلم حِرَفٍ ومِهَنٍ وصناعات يدوية، وفلاحة، وصيد، وما إلى ذلك.
فمضامينه ومحتوياته استجابت لسياقات تاريخية معينة، واشتراطات اجتماعية وسياسية وتربوية، في أزمنة الحروب، وإثبات الذات، والأمجاد التي عرفها اليونان والرومان تاليا. ومن مبادئ الشعر الديداكتيكي ومتطلباته أن يدور بين شخصين: بين المعلم والتلميذ لا غير، وفي ذلك ما يعكس حرص شعراء الديداكتيكْ على الاستقلال بتجربتهم، وتفريدها عما عداها من أنماط الكتابة الأخرى، والشعر»الكبير» الحقيق بتسمية شعر: كالملحمة والتراجيديا والغنائية.
واشتهر من بين هؤلاء هيزْيودْ، وفِرْجيلْ في (جورْجياته)، ولوكْريسْ، وبارْمينيدْ الذي خَصَّه هِيدجرْ بمقالة قوية وعميقة متناولا شعرية الديداكتيك لديه، على رغم ما يمكن أن يلابسها من نَظْم بارد، ويغشاها من ضحالة وسطحية، ونثرية فَجَّة.
لكن المنتخبات والمختارات الشعرية عربيا، تلفت الانتباه، وتحض على إدراجها ضمن الديداكتيك: ضمن تربية وتعليم النشء العربي، في تواريخ فائتات، وعهود خوالٍ = في العصر الأموي، والعصر العباسي، والعصر الأندلسي، إذ أن الخلفاء والأمراء وقادة الجيش والوزراء، والولاة، اهتموا بتعليم أبنائهم وتربيتهم إعدادا لهم على مواصلة السير، والنقع في المضمار عينه، ومن ثم، جلبوا رواة الشعر واللغة والبلاغة، ليؤدبوا أبناءهم، ويهذبوهم، ويلقنوهم مباديء العربية، والإعراب، واللغة، والنحو، والبلاغة من خلال تحفيظ الأشعار الذائعة مثل المعلقات، وأشعار الإسلاميين والأمويين والعباسيين الذين لم يبرحوا ويتمردوا على عمود الشعر كما قَعَّدَه المرزوقي.
اتسمت الفِعْلة التعليمية – التربوية إياها بالتلقين والتحفيظ والترديد، بغرض تثقيف اللسان، وتقويم البيان، ومحاربة العجمة التي استشرت في العاصمة والأمصار بدخول الأعاجم إلى المدن واختلاطهم ببني عدنان وقحطان، بالعرب الخُلَّصِ.
لهذا نعتبر «المفضليات»، و»الأصمعيات»، و»جمهرة أشعار العرب»، و»حماسة أبي تمام»، و»حماسة البحتري»، وغيرها، وهي مختارات شعرية دفع إلى انتخابها، وإقرائها وتحفيظها، داعي التقويم التربوي العام، نعتبرها أدْخَلَ ما تكون في الشعر الديداكتيكي، علما أننا ندرك الاختلاف الفني الشكلي، والمضموني البيّن بين التجربتين الشعريتين المذكورتين. كما نَعِي حدود التنشئة التربوية التي دعت إليها المختارات المذكورة، لأنها كرست، تاريخيا، آفة الحفظ الببغائي، وإنْ وضعت بين أيادي المتأدبين = عيون الشعر العربي.
ما يعني أنها أشعار كانت (ونحن نقرؤها الآن) على قَدْرٍ كبير من الجمال والفن والمتعة لغةً وتركيبا وبناء وتخييلا ومجازا.
(يتبع)