فهل أكون جمعت بوعي وتفانٍ ونكران ذات، بين ما ندبتُ له نفسي متحمسا منشرحا وهو التدريس، وما انخرطت فيه مقتنعا ومندفعا، غير وَجِلٍ ولا متردد، وهو النضال اليومي مع زمرة من أصدقائي، لرفع الضيم والظلم عن النساء والرجال، عن الناس اللّي تَحْتْ؟، لست أدري.
كما أذكر أنني نشطت نشاطا ولا أكثفَ كأنني أنتقم لنفسي مما حل بها، وأعلن عنها بما هي نفس أبية صاحبها حاضر غير غائب. وتَمَرْأَى وتجلى ذاك النشاط في كتابة الشعر» الملتزم «، والشعر « المتحرر « ونشره بالملحق الثقافي لجريدة ( المحرر )، وما أدراك ما المحرر أيامئذ اا، تواقتا مع تقديم عروض ومحاضرات بفضاء الكنيسة الوسيع، وهي اليوم مُرَكَّب ثقافي بهيٌّ وحيٌّ، بعد مغادرة آخر أجنبي مسيحي وغير مسيحي، مدينتنا التي زركشتها إقامتهم فيها، ورشت لوحات ومشاهد ومساحيقَ وجديداً، كانت وكنا في حاجة إليها.
عرضت في المحاضرات، المومأ إليها، مواضيعَ وقضايا ذات صلة وُثْقَى بالأدب والشعر، ومنها تمثيلا: ( الشعر المغربي في عهد الحماية )، كتاب الدكتور الوديع والعميق إبراهيم السولامي. وفيها وضعت اليد على الفرق الفني والجمالي بين ما هو شعر وما هو نظم بارد اقتضته المناسبات الطارئة، والأحداث العابرة. فضلا عن تقديمي وتحويلي لباقة من أشعار محمود درويش وسميح القاسم، إلى ما يشبه المسرحيات، اجتهدت أن تكون خفيفة على القلب، سريعة الحفظ والاستيعاب، يمثلها ويؤديها كوكبة من التلاميذ والتلميذات، ما جعل حب فلسطين يتمكن من وجدانهم، ويسري في قلوبهم ودماهم.
وإذاً، لست في حاجة إلى القول بأن سنة 75 / 76 من القرن المنصرم، كانت سنة حافلة، غنية، فياضة بالنشاط التربوي، والنشاط الثقافي، والنشاط الحزبي والنضالي، والسهرالليلي الماتع واللذيذ مع ثلة من أصدقائي الأساتذة والعمال الذين يسكنون قلبي.
وذات عصر من سنة 1976، عصر لا كالأعصر، وقعت الواقعة. فبين استراحة التلاميذ وجلجلة الجرس، وفي غمرة حماسي واشتعالي، وغضبي « القومي « المهتاج، ونصرتي لقضية الشعب الفلسطيني، دعوت الأساتذة إلى الالتحاق بالقاعة لأمر ما. وكان معي بيان الثورة الفلسطينية، والحركة الوطنية اللبنانية، الذي عُمِّمَ على وسائل الإعلام، وتبنته بعض الأحزاب الديموقراطية، وهو البيان الذي يدين تدخل الجيش السوري في لبنان العام 1976، أيْ بعد عام فقط، من اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية في العام 1975، التي أتت على الأخضر واليابس، وقصمت ظهر التعايش والتساكن والديموقراطية ، وأحرقت الشجرة الرمز، شجرة الأرز الحضارية الخالدة. وكان التدخل السوري ـ كما رُوِّجَ ـ إنما تمَّ تحت غطاء الجامعة العربية، ليضع حدا للحرب الأهلية المدمرة. لكن الحقيقة غير ذلك، فحافظ الأسد الرئيس السوري آنذاك، كان يبغي من وراء دخول قواته النظامية، احتلال لبنان خوفا من أن يصبح جيبَ مقاومة شرسة تنخسه في خاصرته، وتهدد وجوده. كما صمم على استئصال الوجود الفلسطيني، وتركيع الحركة الوطنية اللبنانية والأحزاب اليسارية، والتمكين لأزلامه وأتباعه من الفصائل الأخرى الموالية والممالئة.
ما علينا. في غمرة ذاك الحماس، والغضب الساطع، قرأت على الأساتذة الحاضرين، البيانَ التنديدي بعد أن قدمت له بكلام نددت فيه بدوري بالنظام السوري ( وكان يدَرِّسُ معنا، إخوان سوريون أُكِنُّ لهم الاحترام والتقدير ). وما هي إلا دقائق حتى كان المدير، مرفوقا بالحارس العام، والمعيدين، يقف على الباب منصتا ثم متوعدا إياي بصوت مخنخن، بأوخم العواقب لأنني ما فتئت أعمل على تسييس المؤسسة منذ فترة طويلة، منذ قدومي والتحاقي بالثانوية، ساعيا، في تقديره، إلى تحويلها إلى ملحقة جامعية لا إلى مؤسسة تربوية تكوينية لها حرمتها، وحدود من يدرس فيها.
بلى، لقد أنفذ، أصلع الرأس القصير القذال، ذي الحاجبين المنتوفين على الجبين اللعين ـ وعيده، وحقق مرامه وبغيته. ففي صباح بارد، ملفوفا في جلابيتي، يَمَّمْت شطر الثانوية منشرحا كالمعتاد، وقفت مع تلاميذي أمام القسم الذي استمر مغلقا أمام تساؤلنا واستغرابنا، بينما شرعت أقسام محاذية في مباشرة فطور الصباح، أقصد في بدء إعطاء الدروس. أُخْبِرْتُ بأنني مطلوب من النيابة بوجدة في أمر يخصني.
وفي وجدةَ، أُنْبِئْتُ بأن ثلاثة أطراف مجتمعة لم تعد ترغب فيَّ لتدريس أبنائها، وقد راسلت الوزارة الوصية في أمر ذلك؛ وتلقت شفويا قرار توقيفي إلى أجل غير مسمى. كانت الأطراف المتحالفة الحقودة المتآمرة هي السلطة المحلية في شخص رئيس الدائرة، وجمعية آباء وأولياء التلاميذ في شخص المرحوم الزيتي، والسلطة الإقليمية آنذاك في شخص العامل: الدُّبّي القدميري. وكان المدير المأمور والدمية قد رتب كل شيء. فعند مغادرتي المؤسسة شاتما وغير مبالٍ، حضر للتو من يملأ مكاني الذي شغر ساعات قلائل فقط.
وللحقيقة والتاريخ، فما وقع بالثانوية من قراءة البيان الثوري على الأساتذة، لم يكن إلا مبررا واهيا، وذريعة لم تنطل على أحد. فالمسألة أبعد من ذلك، إذ تتعلق بالنضال الحزبي، وبارتباطي بالعمال، وعلاقتي الوطيدة بالتلاميذ. وهو ما كانت السلطة تخشاه، وتَتَسَقَّطُه، وتتحين اللحظة المواتية لإيقافي وفصلي ثم إبعادي عن مدينتي.
فهل أكون سقطت، كَرَّةً أخرى، في فخ اندفاعي، وحماسي الطاغي الذي أعماني حتى ظننت أنني مُخَلِّصُ العمال، وكاشف الغمة عن الأرامل والثكالى والأيتام والرجال، وموصل التلميذات والتلاميذ إلى الغد الجديد، غد الحلم الوليد؟ أم ترتد المسألة إلى ما قبل « فعلتي « أي إلى حدث بارز، إلى تلك الزيارة الخاطفة التي قام بها القائد السياسي الفذ، والمناضل النقابي الكبير الشهيد عمر بن جلون قبل اغتياله بأشهر معدودات على يد إرْهابيين ظلاميين ينتمون لحركة الشبيبة الإسلامية؟
كان للزيارة المشهودة وَقْعُ الزلزلة في أوساط السلطة عندما نما إلى علمها بأن عمر حل بين ظُهْرانيْ مجموعة من عمال جرادة. فجن جنونها لأن حلوله بيننا تجاوزها. انعقد الاجتماع النضالي تحت رئاسة الشهيد، بين العصر والعشاء. التأم فيه شمل المتفرقين، وغص المنزل « السري « بأعداد تناكبت وتزاحمت حتى لا مزيد. وبعمقه التحليلي المعروف، وقدرته التوجيهية المعهودة، وطرافة تعليقاته على المتدخلين، اشتعل الحضور تجاوبا مع توجيهاته، وأفكاره التي أبانت عن معرفة دقيقة بواقع جرادة، ووضعية العمال المأساوية بها. إنه الحضور الذي بقدر ما رفع هاماتنا، وقوى تماسكنا، وحفزنا على المزيد من الالتحام، وضبط التنظيم، وتوسيع القاعدة، والمناورة متى دعت الحاجة إلى المناورة، بقدر ما أغمد سيوف السلطة لفترة طالت، وأربك حسابات الخصوم، وفضح من كان حقيقاً بالفضح والسخرية.
هي ذي الواقعة التي عجَّلتْ ب « تهجيري» حتى لا أقول بطردي من جرادة مخافة نهوض عمالي، وزوبعة سكانية مساندة لا تبقي ولا تدر. ففي الأصل، لا فوضى، ولا إخلال بالنظام العام، ولا دعوة إلى العصيان، وتكسير المحلات، والمتاجر والسيارات، وما يدخل في ممتلكات الناس. فكيف تبرر السلطة هنا أو هناك، تدخلها وعنفها، وطردها، وتكسير عظام من يقوم بالمطالبة بحقه، والجهر بما يؤلمه ويوجعه؟.
وها دور مدينة أبركان يصل إذ عينت فيها مكلفا بتدريس اللغة الفرنسية لتلاميذ تركتهم أستاذتهم الحامل عرضة للريح والانتظار والفراغ، ولم يكن قد تبقى من العام الدراسي إلا أشهر معدودة. ويرجع الفضل في استئناف تدريسي بعد أن تلقيت كتابا من الوزارة بتوقيفي، إلى إخواني في الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي بوجدة الذين اجتمعوا بنائب وجدة لثنيه عما اقترف في حقي. ثم اتصلوا بالمكتب السياسي للحزب، ليقنع مسؤولي الوزارة الوصية بنسيان ما أقدموا عليه.
ولم يكن من هدف لأولئك المتآمرين الظالمين، غير اقتلاعي من بلدتي، و» نفيي «، والتطويح بي إلى « جبل قاف « لإبعادي عن العمال وتيئيسي، وكسر شوكتي. وما تسفيري إلى مدينة أبركان إلا فعلا دنيئا من أفعالهم، علما أنني أحببت مدينة الشهامة والرجال والبرتقال. وكيف لا أحبها، وجدتي من جهة أمي، يزْناسنية بركانية قُحَّة. لكن، هيهات ا.. هيهات اا، فما عتم أن رفعت التحدي عاليا، وصرت أزور مسقط رأسي نهاية كل أسبوع حيث أقضي يومين أو ثلاثاً وسط إخواني وأصدقائي العمال والعاملات، مؤطرا، مستمعا لجراحاتهم، ومقترحا ما أراه قمينا بالتخفيف عما يرزحون تحته، وينوؤون بحمله، وتبصيرهم بالطريق السالك بهم إلى كرامتهم، والمفضي إلى استرجاع آدميتهم وإنسانيتهم. وقد ذُهِلوا يوم سُدَّ في وجهي سبيل متابعة ما كنا نخوض فيه، وما عوَّلْنا على القيام به. كما ذُهِل تلاميذي وتلميذاتي يوم انقطعت عن تدريسهم، وصاروا، بين عشية وضحاها، حيارى لا يعرفون ما الذي صار حتى فُطموا عن أستاذهم، كما فُطِمَ أستاذهم عنهم، وهم الذين لم أكن آلو جهدا في ربطهم بالواقع والأحداث والمستجدات، تجاوبا مع شغفهم المعرفي ، وتعطشهم للجديد، لا أن يظلوا مرتبطين فحسب، غاطسين إلى الفروة في برامج ومناهج ومؤلفات منبتة ـ في معظمها ـ عن تطلعاتهم وانتظاراتهم، وآفاقهم. وتلك محمدة ـ في ما ادَّعي ـ لازمتني في مشوار ومسير ومسار تدريسي منذ جرادة حتى رباط الخير، حتى فاس، وإلى المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين: التدريس الرسمي، والتدريس الموازي. متى ينتهي الأول ليبدأ الثاني، وينتهي الثاني لنعود إلى الأول ذهابا وإيابا، أقواسا وانفتاحا.
لقد علمتني التجربة والمِراس، وسلخ أكثر من أربعة عقود في التدريس والتكوين والتأطير، كيف أوفق بين ما هو موضوع ومنهج وبرنامج مفروض، وما هو مرغوب ومطلوب لدى التلاميذ، غير مُدْرَجٍ ضمن تلك الموضوعات والبرامج، فهل أكون أفلحتُ.؟
نبضات : كبوة عباس، والعودة إلى مسقط الراس ( 4 )

الكاتب : محمد بودويك
بتاريخ : 03/12/2021

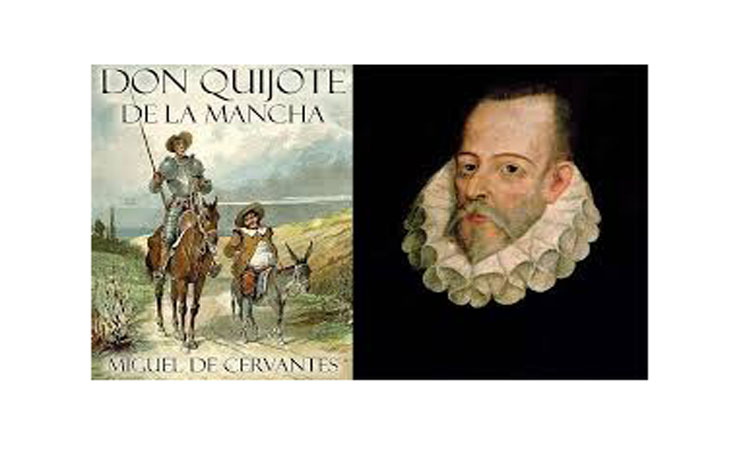



اترك تعليقاً